
 |
| جديد المواضيع |

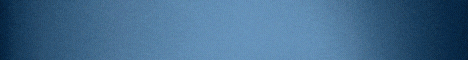
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
اهتمام علماء المسلمين بعقيدة السلف
ظروفه ، وآثاره للدكتور : أبو اليزيد أبو زيد العجمي اهتمام علماء المسلمين بعقيدة السلف ظروفه وآثاره 1- نبذة عن المؤلف 2- الاهتمام بعقيدة السلف 3- السلف والخلف 4- المرحلة الأولى 5- المرحلة الثانية نبذة : تلقى تعليمه في الأزهر ، وتخرج من كلية دار العلوم جامعة القاهرة 1967 م . حصل على الماجستير من دار العلوم 1977م . حصل على الدكتوراه من دار العلوم 1981م . التخصص : عقيدة وفلسفة إسلامية . الإنتاج العلمي : 1 - حقيقة الإنسان في ضوء التصور القرآني ( تأليف ) . 2 - الذريعة إلى مكارم الشريعة ، للراغب الأصفهاني ( تحقيق ) . 3 - نجاة الخلف في اعتقاد السلف ، للشيخ ابن قائد البخوي ( تحقيق ) . 4 - الفقهاء وبحوث العقيدة الإسلامية ( تأليف ) . أسهم في عد من المجلات العلمية منها : 1 - أضواء الشريعة ( بالرياض ) . 2 - حولية دار العلوم ( بالقاهرة ) . 3 - المسلم المعاصر ( الكويت ) . 4 - البحوث الإسلامية ( بالرياض ) . الوظيفة / مدرس بكلية دار العلوم جامعة القاهرة . أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالرياض . الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء :: المملكة العربية السعودية . |
|
#2
|
|||
|
|||
|
الاهتمام بعقيدة السلف :
إن من يتفحص الكتب التي صنفت في العقائد يصادف عددا غير قليل يظهر أو يدافع عن العقيدة عن عقيدة السلف الصالح ضد التيارات الأخرى ، ولا نريد هنا أن نستقصي هذا اللون من مؤلفات العقيدة ، ولكن حسبنا أن نشير إلي بعض هذه المؤلفات . ففي القرنين الثاني والثالث الهجريين نجد ما ينسب للإمام أبي حنيفة النعمان ( 150هـ ) من رسائله التي تعالج مسائل في العقيدة تقارب منهج السلف الصالح ، الذي أوجزه أو كتب بعده في متن الفقه الأكبر الذي حظي بشروح عديدة . كما نجد الفقه الأكبر للإمام الشافعي ( 204هـ ) ، والرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل ( 242هـ ) . وفي القرن الرابع الهجري نجد لابن خزيمة ( 311هـ ) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا ، ونجد العقيدة الطحاوية ( 321هـ ) ، وقد حظيت بشروح عديدة أيضا ، كما نجد للإمام الأشعري ( الإبانة عن أصول الديانة ) ( توفي سنة بضع وعشرين وثلاثمائة ) ، وفي القرن نفسه نجد الإبانة لابن بطة العكبري ( ت 387هـ ) . وفي القرن الخامس الهجري نجد الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للإمام البيهقي ( المتوفى 458هـ ) رغم ما فيه من بعض التأويلات التي هي خلاف منهج السلف . (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 174) ويمكننا أن نعتبر كتاب البغدادي "الفَرْق بين الفِرَق" في الاتجاه نفسه ؛ لأنه يظهر باطل معتقداتهم ، ويُذَيَّل ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة ( توفي 429هـ ) . فإذا انتقلنا إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية أعني القرنين السابع والثامن الهجريين ، وجدنا لشيخ الإسلام ولابن القيم ولتلاميذهما من بعدهما حشدا هائلا من المصنفات في خدمة عقيدة السلف . وقد استمر هذا الاتجاه حتى العصر الحاضر حيث مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تتلمذ على هذه المدرسة كما هو واضح في الرسالة المسماة "نجاة الخلف في اعتقاد السلف" - للشيخ أحمد بن عثمان بن قائد النجدي ( 1097هـ ) . وهذا الحشد الهائل من المصنفات التي تمثل اتجاها يعنى بيان عقيدة السلف الصالح يوحي بسؤال مؤداه : لماذا كل هذا الاهتمام بعقيدة السلف ، وهي موجودة في الكتاب والسنة ؟ وبلفظ آخر : ما هي البواعث التي أدت إلى وجود هذا الاتجاه ظاهرا في تاريخ الفكر الإسلامي ؟ للإجابة على هذا السؤال نقول : لا بد أن ندرك أن مرحلتين تتشابهان إلى حد كبير مر بهما الفكر الإسلامي ، فكانت الظروف في المرحلتين باعثة على هذا الاهتمام بعقيدة السلف الصالح ، ولا بد للأمر من بيان المرحلتين ، يسبقهما تحديد لمصطلح السلف والخلف . |
|
#3
|
|||
|
|||
|
السلف والخلف :
كثر استعمال هاتين اللفظتين في صورة الاقتران والعطف ، فقد يراد بهما (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 175) مجرد الدلالة اللغوية التي تعني السبق والمتابعة ، فسلف بمعنى سبق وتقدم ، وبمعنى مضى وانقضى ، وسلف السائر سلفا أي : تقدمه وسبقه ، وأما خلف ففي المعجم : خلف فلانا خلفا : جاء بعده فصار مكانه ، وفي القرآن الكريم : عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وكذا الخلف : والعوض والبدل . وقد حملت بعض الكتب أسماء تؤدي هذا المعنى اللغوي ، مثل : " صلة الخلف بموصول السلف " لمحمد بن سليمان المغربي ( ت 1094هـ ) ، والكتاب عبارة عن ثبت بأسماء كتب ألفها السابقون من العلماء ، وهي تفيد الذين أتوا بعدهم . وكذلك كتاب ابن رجب الحنبلي " معان فضل السلف على الخلف " وفيه عدة رسائل في باب العلم والآداب ، كما يحوي كلاما موجزا في العقائد . وقد يراد بهما معنى اصطلاحي مشتق من المعنى اللغوي ، كما في عنوان رسالة الشيخ عثمان بن أحمد النجدي : " نجاة الخلف في اعتقاد السلف " إذ لا يعقل أن الأمر هنا مجرد دلالة لغوية ، فيكون المعنى نجاة من لحق في اتباعه لمن سبق ، دون تقييد لصفات أخرى تجعل هذا السابق جديرا بأن يكون اتباعه منجيا . وقد حدد ابن تيمية مفهوم السلف بما يفيد أنهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون وتابعوهم المعنيون بـ : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 176) يقول ابن تيمية : فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين : أحدهما : أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك عنهم من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة . والثاني : أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة ، ومن أهل الحديث والتصوف ، وأهل الكلام كالأشعري وغيره ، فصار مذهب السلف مقبولا بإجماع الطوائف وبالتواتر ، لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع . ثم يقول : " فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف ، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك " أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - " . ويقرر شيخ الإسلام في موضع آخر أن هناك اتفاقا بين أهل السنة والجماعة من جميع الطرق على أن خير القرون ما ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل ، وإيمان وعقل ، ودين وبيان ، . . . كما قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : " مَن كان مِنكُـم مُستَنًّا فَليَستَنّ بِمَن قَد مات ؛ فَإنّ الحَيّ لا تُؤمَن عليه الفِتنةُ ، أولَئِك أَصحاب مُحمّد أَبَرّ هذه الأُمّة قُلُوبا ، وأَعمَقها عِلما ، وَأَقَلّها تَكلُّفا ، قوم اختارهم الله لِصُحبة نَبيّه وَإِقامة دِينه ، فَاعرفوا لَهُم حَقّهم ، وَتمَسّكوا بِهَديهِم ؛ فَإنّهم كانوا على الهدي المستقيم . . . " . وما أحسن ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - في رسالته : " هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل ، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا . . . . . . " . فإن عامة ما عند السلف من العلم والإيمان هو ما استفادوه من نبيهم (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 177) - صلى الله عليه وسلم - الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور ، وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد . وبهذا يكون قد تحدد مفهوم السلف اصطلاحيا حين يذكر في باب اعتقادهم والأخذ عنهم . أما مفهوم الخلف : فقد حدده شيخ الإسلام بأنه يراد به جماعة المتكلمين ومن تابع منهجهم ومنهج الفلاسفة ، وابتعد عن منهاج أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَهْمًا منهم أن ذلك خير من مذهب السلف ، ويصدق هذا المفهوم على الآخذين بهذا المنهج قديما وحديثا . ولا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم ، وغلط في معرفة الله حجابهم ، وأخبر الواقـف على نهاية أقدامهم بما انتهى إليه أمرهم حيث يقول : لعمــري لقــد طفــت المعــاهد كُلّهــا وســيرت طــرفي بيـن تلـك المعـالم فلـــــم أر إلا واضعــــا كــــف حــــائر علــى ذقـــن أو قارعـــا ســن نــادم ويبين شيخ الإسلام خطأ فهم الخلف لمنهج السلف ، وبيان ضلال من يزكي مذهب الخلف أنفسهم ؛ فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيـث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأُمِّيّين الذين قال الله فيهم : وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ . وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات . . . وقد كذبوا على طريقة السلف ، وضلوا في تصويـب طريقة الخلف ، فجمعوا بين الجهل بطريق السلف في الكذب (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 178) عليهم ، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف . وبهذا فإن لفظ السلف حين يطلق يجب أن ينصرف لا إلى مجرد السبق الزمني ، بل إلى أصحاب الرسول وتابعيهم ومن بعدهم بشرط الالتزام بمنهجهم والذين يتأخر بهم الزمن أن يسموا سلفا إذا كانوا على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما لفظ الخلف فإنه لا يعني مجرد التأخر في الزمن ، ولكنه يضم إلى هذا معنى آخر هو البعد عن منهج السلف واتباع منهج الجدل العقلي وغيره من طرق البشر في التفكير الذي لا يستند إلى كتاب أو سنة . وقد حمل بعض العلماء شهرة بلقب السلفي ، وتناقلها كتب التراجم والطبقات أمثال : الحافـظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم سلفة الأصبهاني ، وهو أحد الحفاظ المحدثين . ولد / 472 هـ وتوفي 576 هـ وعاش مائة وأربع سنين ، وكان مشهورا بلقب السلفي وقد أخطأ فريد وجدي في هذا . والأصح : أنه السِّلَفي بكسر ففتح . وكما اشتهر هذا الوصف - في فهمنا - عن التحديد الذي أشرنا إليه من التزام منهج الصحابة والتابعين . وجدير بالذكر أنه إلى جانب هذين اللفظين قد يحمل مصطلح أهل السنة معنى " السلف " كما نراه كثيرا في استعمالات ابن تيمية ، وقد يكـون أكثر اتساعا إذا أطلق في مقابل لفظ " الشيعة " ، ولكن الأغلب أن يتحدد مفهوم أهل السنة بأهل الحديث ومن تابعهم من الفقهاء . |
|
#4
|
|||
|
|||
|
المرحلة الأولى :
تكاتفت عوامل عديدة لتجعل القرنين الثاني والثالث الهجريين فترة (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 179) اتسمت بالجدل حول قضايا العقيدة ، وأدت بطريق أو بآخر إلى بداية التأليف في بحوث العقائد الأمر الذي أوجد بالمكتبة الإسلامية كثيرا من المؤلفات في هذا الموضوع وما يتصل به من تأريخ للملل والنحل . ولعل أبرز هذه العوامل ما يلي : 1 - وجود الفرق واشتغالها بمسائل استتبعت ردا من المخالفين لهذه الفرقة أو تلك ممن يختلفون في الأصول ، وتعصب كل فرقة لأصولها التي حكمتها في القضايا ، وحكمت بها على مسائل الخلاف ، ولكي ندرك أثر هذا العامل يجب أن نعي حقيقتين هامتين : الحقيقة الأولى : أن قضايا العقيدة كانت موضع اهتمام القرآن الكريم باعتباره كتاب الإسلام ، الذي يؤسِّس بناء الفرد على عقيدة التوحيد ، ويفرع منها كل نواحي النشاط الإنساني ، سواء في جانب علاقة الإنسان بربه في العبادات ، أو علاقة الإنسان بالناس في المعاملات والآداب ، أو علاقة الإنسان بالكون تسخيرا وتأملا وتحقيقا للخلافة والعمارة من خلاله . وسواء جاء الاهتمام بالتوحيد وتقريره في صورة إخبار عن حقيقة مؤكدة مثل : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، ومثل : وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . أو في صورة بيان يفهمه العقل ويصدقه الواقع المُشاهَد ، مثل قوله تعالى : لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ وقوله : مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ . (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 180) أقول : سواء جاءت المعالجة بهذه الصورة أو تلك أو غيرهما ، فإن المؤكد أن القرآن قد بين ( أن الإيمان بإله واحد له صفات الكمال والجلال لا شريك له في ملكه ، ولا نظير له في الخلق والإيجاد والتأثير والتقدير ، هو الذي يتفق مع ما نشاهده ونلاحظه من دقة ونظام في هذا الكون الذي يجري على سنن ثابتة وقوانين مطردة لا تختل ولا تتخلف ) . وكما اهتم القرآن بإرساء الأصل وهو التوحيد عقيدة الإنسان حين لم تنحرف فطرته ، اهتم كذلك بمحاربة الانحراف الذي حدث عند بعض الأقوام عن هذا الأصل معيدا الناس إليه : وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ : لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِدٌ . وبنفس المنهج يدحض فرية الشركاء والمشركين في كثير من الآيات ، والقرآن في إرسائه أصل العقيدة التوحيد يربط بين هذا الاعتقاد والعمل المرتبط به كمظهر عملي للتوحيد الذي يمثل أساس البناء ومنهج الحركة في الحياة ، نقرأ مثلا قول الله تعالى : قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ، وقوله تعالى : قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ . والتذكير بهذه الحقيقة يظهر أثر الفرق فيما جد على الناس من جدل واختلاف كَفَّرَ البعض فيه من ليس على فكرهم ، ذلك أن اهتمام القرآن (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 181) بالتوحيد إنما هو من باب تصحيح عقيدة ، يرى أكثر الباحثين أنها عقيدة الإنسان منذ نشأته ، وأن هذه العقيدة لم تنفك عنها أمة من الأمم ، وأن الإنسان قد انجرف إلى ألوان من الوثنية والتعدد لم يكن عليها في القديم . ولنفس الغاية كان الاهتمام بدحض شبهات الشرك والتعدد ومجادلة المنحرفين من أهل الكتاب . وقد جاء الحديث عن صفات الله الواحد القادر المريد ، بما لا يحدث انفصالا بين الذات والصفات ، وقد فهم سلف الأمة هذه الحقيقة فساقوا الكلام سوقا واحدا ، ووصفوا الله بما وصف به نفسه ، فإذا جئنا إلى التوحيد لدى فرق المتكلمين وجدنا تشقيقات ليس للمسلمين بها عهد ، فهناك علاقة الصفات بالذات الإلهية ، وهل وجودها يتعارض مع الوحدانية أم لا ؟ وهناك من لا يفرقون بين صفات الله المتفرد بالجلال والذي ليس كمثله شيء ، وبين صفات مخلوقاته تشبيها أو تمثيلا ، وهناك غير هذا من مهاترات الفِرَق ، وتشقيقات المجادلين . وقد أدى هذا الفهم الغريب للتوحيد بفرقة كالمعتزلة - والتوحيد واحد من أصولها الخـمسة - إلى أن تنفي عن الله أكثر الصفات الثبوتية ، كالقدرة والإرادة والعلم ، بحجة أن هذا يتنافى مع التوحيد ، ويقترب بالمسلمين من تعدد كتعدد النصارى ، كما أدى بهم فهمهم هذا إلى التأويل في الصفات الخبرية التي تثبت لله يدا وعينا وغير ذلك ، وقد أوقعهم فهمهم هذا إلى القول بخلق القرآن ، وما جرّه على المسلمين من بلاء واضطراب . وقد أدى بهم هذا الفهم إلى جدل طويل مع الفرق الأخرى وعلى رأسهم الأشعرية الذين يخالفونهم الرأي ، كـما أدى بهم إلى أن وصفهم غيرُهم بأنهم المعطلة وأنهم أخذوا آراءهم هذه من الزنادقة وليت الأمر يقف عند حد الجدل بل هو مخالفة صريحة للنصوص القرآنية الواردة في هذا الصدد (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 182) " وسواء أخذ المعتزلة آراءهم هذه عن الزنادقة كما يذكر الأشعري ، أم عن الفلاسفة كما يذكر الشهرستاني ، فإن رأي المعتزلة لا يشهد له الشرع ، بل إنه يؤدي إلى إنكار كثير من آيات القرآن التي تصف الله سبحانه بصفات العلم والقدرة والإرادة وغيرها " . الحقيقة الثانية : هي أن كثيرا مما أثير بين الفرق ، بل مما أخذت الفرق منه أسماءها قد يكون له جذور أسبق من القرنين الثاني والثالث ، كما يرى مثلا بعض العلماء في أمور القدر والجبر والخوارج . فالخروج الذي يستحقه من يخرج على الحق يرى البعض أن جذوره تمتد إلى يوم أن قال ذو الخويصرة التميمي لرسول الله عقب قسمته لذهبة آتته من اليمن : اعدل يا محمد ؛ فإنك لم تعدل . حتى قال عليه السلام : " إن لم أعدل فمن يعدل ؟ " . فعاود وقال : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى . ويقول الشهرستاني عن هذا الموقف : " ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجيا فمن اعترض على الرسول الحق أولى أن يصير خارجيا ، أو ليس ذلك قولا بتحسين العقل وتقبيحه ، وحكما بالعقل في مقابلة النص ، واستكبارا على الأمر بقياس العقل ؟ " . كذلك فإن مسألة القدر والجبر قد أثيرت على ألسنة المشركين كما يحكي الله تعالى عنهم في قوله : سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ . وواضح أنهم لا يريدون الاعتذار عن القبائح التي يعتقدونها ، بل مرادهم بذلك الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ورضي الله عنه بناء على أن (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 183) المشيئة والإرادة تساوي الأمر عندهم . ويذكر الشهرستاني أنها قد أثيرت أيضا على ألسنة المنافقين الذين قالوا يوم أحد : يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ وقولهم : لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا وقولهم : لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا فهل ذلك إلا تصريح بالقدر ؟ نقول : قد يكون هناك جذور للقضايا التي طال الجدل فيها بين الفرق كما ذكرنا أمثلة منها ، لكن هذه الجذور لم تكن بالقوة التي تثير جدلا وتخلق بلبلة ، وأظن الأمر يختلف كثيرا إذا قُورن بما أحدثه الخوارج إثر خروجهم بعد مسألة التحكيم ، وما ناقشوه من قضايا مرتكب الكبيرة ، وتكفيرهم غيرهم ، وما تبع هذا من موقف المرجئة الذين غالى بعضهم إذ اعتبر أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة . كذلك إذا نظرنا القدرية وجدنا أن ما كان في آخر عصر الصحابة والذي امتد إلى العصر الأموي والعباسي أصبح شيئا آخر غير الجذور الأولى خطرا وفكرا . يقول ابن تيمية : " ثم حدث في آخر عصر الصحابة القدرية . . . وأما القدرية فخاضوا في قدره بالباطل ، وأصل ضلالتهم : أن القدر ينافي الشرع . . . فصاروا حزبين : حزبا يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو ينفي بعضه . وحزبا يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن ، أو ينفي حقيقته ويقول : لا فرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه في نفس الأمر الجميع سواء " . وكذلك فإن الجبر أصبح نحلة ، واعتنقه ناس يدعون إليه ويدرسونه ويبينونه للناس ، وسواء كان أصله نحلة يهودية كما يقول ابن نباتة المصري صاحب سرح العيون في رسالة ابن زيدون ، أم هو نحلة أصلها فارسي كما يذكر المرتضى في المنية والأمل ، فإن المقرر أن الجبر أحدث جدلا طويلا على (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 184) الساحة الفكرية أخذ المعتزلة موقفا مضادا له ، وأخذ الأشاعرة موقفا متوسطا ، وفي كل ذلك جدل ومناظرات كانت سمة العصر وطابع الفكر الإسلامي آنذاك . أقول في ضوء الحقيقتين السابقتين : يجب أن ننظر إلى الفرق باعتبارها عاملا هاما في ازدهار حركة الجدل الديني في القرنين الثاني والثالث الهجريين ، ومقارنة معتقدات كُلٍّ وأصولها بمعتقدات وأصول غيرها ، ثم رصد ما حدث بينهم من مناظرات ومراسلات يظهر أثرهم في الفكر الإسلامي ، وليس تفصيل هذا من خطتنا ، وإنما حسبنا أن نشير إلى الظاهرة وندل عليها في مظانها من كتب الفرق والملل والنحل ، كما نشير إلى أن أثر الفرق ليس راجعا إلى موضوعات الجدل بقدر ما هو راجع إلى منهج تناول هذه الموضوعات والهدف المرتبط به . |
|
#5
|
|||
|
|||
|
المرحلة الثانية
أولا :: ذبول الحس الإسلامي ثانيا :: فساد المعتقدات ثالثا :: انتشار الفساد بين العلماء المرحلة الثانية : قد أنتجت المرحلة الأولى في قرنيها الثاني والثالث الهجريين اهتماما امتد حتى القرن الخامس الهجري ، ولعله وضح من خلال المؤلفات التي أشرنا إليها في أول هذا البحث . ثم أصيب العالم الإسلامي بموجة تشبه الموجة التي كانت في عصر الجدل والمناظرات ؛ من حيث سوء الحال في السياسة والاجتماع ، وتفرق الناس في العقيدة فرقا وأحزابا ، حتى إذا جاء عصر شيخ الإسلام ابن تيمية ( 661 - 728 هـ ) وجدنا الحال أسوأ من سابقتها الأمر الذي جعل المعركة شديدة في نفسه بين ما علم وما يرى في عصره من ظلمة شديدة وفساد في كل نواحيه . رأى في ماضي الإسلام عزة واتحادا ، وفي حاضره ذلة وانقساما ، فتقدم الرجل ليصلح وليداوي . وقد جاء الدواء بأيسر كلفة ، ووجد هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها . ولو فتشت عن البواعث التي بعثت ذلك العالم التقي على المجاهرة بآراء معينة ، لوجدت أن الذي بعث على هذه المجاهرة عيب في الزمان في الفكر ، أو في العمل ، أو فيهما معا . وإذا كانت هذه العبارة تمثل وصفا مجملا للعصر الذي تشير إليه ، فإن كتب التاريخ فصلت القول في مظاهر الخلل التي استدعت بالضرورة اهتمام المخلصين بإنقاذ هذه الأمة بتنقية عقيدتها مما شابها . وهاهي ذي بعض مظاهر الفساد آنذاك . أولا ذبول الحس الاسلامي : وهذا يفقد الناس حميتهم الإسلامية وارتباطهم بأحكامه ، واستعدادهم للتضحية في سبيل نصرته ، وقد تجلى هذا الأمر في صور نذكر منها : 1 - فساد عقائد الناس وإيمانهم بفرضية الجهاد ، حتى أن بعض المسلمين كان يناصر التتار ويؤذي الجنود المسلمين ، ويذكر ابن كثير في حوادث سنة ( 700 هـ ) هذا الأمر فيقول : " وفي شوال فيها عرفت جماعة ممن كان يلوذ بالتتر ويؤذي المسلمين ، وشنق منهم طائفة ، وسمر آخرون ، وكحل بعضهم ، وقطعت ألسن ، وجرت أمور كثيرة . . . . . . . . . وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه خلق كثير من المتطوعة والحوارنة لقتال أهل تلك الناحية [ يشير إلى جبال الجرد وكسراوات ] بسبب فساد نيتهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم ، وما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم التتار وهربوا حين اجتازوا ببلادهم وثبوا عليهم ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم وخيولهم ، وقتلوا كثيرا منهم ، فلما وصلوا إلى بلادهم جاء رؤوسهم إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستتابهم وبين لكثير منهم الصواب ، وحصل بذلك خير كثير . 2 - تدخل بعض السياسيين بالفتوى فيما لا يعلمه ، يذكر ابن كثير في حوادث سنة تسع وسبعمائة : أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون جمع العلماء في مجلسه وسألهم فيما قاله ابن الخليلي وزيرهم في شأن إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البيضاء لقاء أن يدفعوا للديوان سبعمائة ألف في كل سنة ، ولم يتكلم الحاضرون ، وكان من بينهم قضاة وعلماء ، لكن ابن تيمية انبرى للسلطان مبينا له خطأ هذا التصرف قائلا : حاشاك أن يكون أول مجلس جلسته في أبهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام الدنيا الفانية ، فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك وكبت عدوك ونصرك على أعدائك وفي هذا الأمر ما فيه دلالة على طلب الدنيا وتدل رفعة الإسلام من الوزير ، ودلالة على موقف بعض العلماء بالسكوت ، إيثارا للسلامة ، في مقابل الحق دون خشية لمخلوق . 3 - تجرؤ بعض النصارى على رسول الإسلام ، إذ أن رجلا يدعى عساف النصراني قد سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحين علم العلماء بذلك ، ومنهم : ابن تيمية حرضوا الناس عليه وعلى من استجار به ، فأطلق الناس عليهما الحجارة ، وقد استدعي ابن تيمية والشيخ الفاروقي ، وضربا نتيجة لهذا ، وقد كانت هذه الواقعة سببا في أن كتب ابن تيمية ( الصارم المسلول على شاتم الرسول ) فانظر إلى أي حد هان على الناس أمر إسلامهم . |
|
#6
|
|||
|
|||
|
ثانيا : فساد المعتقدات : ونعني بهذا المظهر من مظاهر الخلل أن بعض الناس فقدوا تقدير المصادر الإسلامية كالكتاب والسنة ، كما بلغ الاستهتار حدا تمثل في ادعاء المهدية وادعاء النبوة وبعض الغلو الفاحش في أمور العقيدة لدى بعض الطوائف ، مثل : الصوفية آنذاك . ويمكن أن نقدم دليلا على هذا المظهر بعض الأحداث التي سجلها لنا التاريخ ، منها : 1 - قتل رجل لكفره واستهتاره بآيات الله ، والاستهانة بالنبوة . ففي حوادث سنة ( 726 هـ ) يذكر ابن كثير " وفي يوم الثلاثاء حادي عشر ربيع الأول بكرة ضربت عنق ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن الهيثمي بسوق الخيل على كفره واستهانته واستهتاره بآيات الله ، وصحبته الزنادقة كالنجم بن خلكان ، والشمس محمد الباجريقي ، وابن المعمار البغدادي ، وكل فيهم انحلال وزندقة مشهور بها بين الناس . قال الشيخ علم الدين البرزالي : وبما زاد هذا المذكور المضروب العنق عليهم بالكفر والتلاعب بدين الإسلام ، والاستهانة بالنبوة والقران . 2 - ادعاء المهدية وتبديل الشهادتين ، حدث هذا عام ( 717 هـ ) حين خرجت النصيرية عن الطاعة وكان بينهم رجل سموه محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله ، وتارة يدعى علي بن أبي طالب فاطر السماوات والأرض ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، وتارة يدعي أنه محمد بن عبد الله صاحب البلاد ، وخرج يكفر المسلمين ، وأن النصيرية على حق ، واحتوى هذا الرجل على عقول كثير من كبار لنصيرية الضلال ، وعين لكل إنسان منهم تقدمة ألف ، وبلاد كثيرة ونيابات . وحملوا على مدينة جبلة فدخلوها وقتلوا خلقا من أهلها ، وخرجوا منها يقولون : لا إله إلا علي ، ولا حجاب إلا محمد ، ولا باب إلا سلمان وسبوا الشيخين ، وصاح أهل البلد ، واإسلاماه ، واسلطاناه ، واأميراه ، فلم يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجد ، وجعلوا يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل " . فانظر كم انقلبت الأوضاع ، من أفتى العلماء بكفرهم يعلنون أن منهم المهدي ولكن أقوالهم وأفعالهم تشهد أنهم أبعد أهل عصرهم عن دين الله الإسلام . 3 - قتل شخص يدعي النبوة ، ففي سنة عشرين وسبعمائة للهجرة حدث أن ضربت عنق شخص يقال له : عبد الله الرومي ، وكان غلاما لبعض التجار ، وكان قد لزم الجامع ، ثم ادعى النبوة واستتيب فلم يرجع فضربت عنقه ، وكان أشقر أزرق العينين جاهلا ، وكان قد خالطه شيطان حسن له ذلك ، واضطرب عقله في نفس الأمر ، وهو في نفسه شيطان إنسي . 4 - الصوفية وغلوهم : لقد كان لابن تيمية مع صوفية عصره مواقف قاسى فيها منهم الكثير ، فلقد ادعى عليه صوفية القاهرة ما لم يقله في أمور الشفاعة وابن عربي وشكوه إلى القاضي ، ونتج عن هذا أنه خير بين السفر إلى دمشق أو الإسكندرية بشروط أو الحبس ، فاختار الحبس ، ثم سافر إلى دمشق بعد ذلك . على أن هذه المكائد من الصوفية لابن تيمية لم تكن إلا لأنه أظهر لهم فساد عقائدهم وما يلبسون به على الناس ، ففي سنة ( 755 هـ ) كان له مع أصحاب الطريقة الأحمدية موقف ، إذ طلبوا من نائب السلطنة أن يتركهم ابن تيمية وحالهم ودجلهم على الناس بدخول النار . ولكن شيخ الإسلام أصر على أن كل حال لا بد أن تدخل تحت الكتاب والسنة ، وأظهر للناس خطأ فهمهم ، وجانب الرجل في سلوك هؤلاء الصوفية ، وقد استعدى هؤلاء الصوفية بعض الحاقدين على شيخ الإسلام فاتهموه بآراء في العقيدة تخالف منهج السلف ، وحكموا فيه خصومه وساقوه إلى الحبس ، ولكنه لم يكف عن بيان الحق لهم ولغيرهم ، وما كان هذا ليمنعه عن أداء رسالته ، فقد التقى بصوفي في القاهرة يدعى إبراهيم القطان ، وكان مخالفا للسنة في مظهره ، وكان يأكل الحشيشة التي تغيب العقل ، فأرشده ابن تيمية إلى الحق ، ونهاه عن كل المخالفات حتى يتعرض لفضل الله ورحمته ، وغير هذا كثيرون ممن تظهر أقوالهم وأعمالهم فساد المعتقد ، أو غش الأمة والتلبيس على أهلها ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . |
|
#7
|
|||
|
|||
|
ثالثا : انتشار الفساد بين العلماء :
ذلك أن هذا العصر ضم اتجاهات مختلفة يغلب على معظمها التقليد للسابقين ، وبخاصة في العقائد ، الأمر الذي يظهر في بعض الشروح التي وصلت إلينا من هذا العصر لكن هذا لم يمنع من وجود بعض الفلاسفة ، وأصحاب النزعة الفلسفية ، فما التصوف بما تحويه من اعتقادات مخالفة لعقيدة السلف الصالح ، وهذا وذاك كان لهما الأثر في وجود بعض الانحرافات في سيرة العلماء وموقفهم من الإصلاح والدعوة إلى تنقية العقيدة مما شابها من بدع وأهواء ، ولكن أقسى شيء في هذه الانحرافات هي أن يتدنى العلماء إلى مغبة المكائد لبعضهم طلبا للجاه والسلطان ، وما ذلك إلا لأن بعض العلماء كان خادما لاتجاه سياسي علا أو هبط ، وهذه بعض مظاهر الفساد في الموضع الذي يرجى منه الإصلاح . 1 - فقد امتحن ابن تيمية من جماعة من الفقهاء حين أشاعوا غير الحق عن كلامه لأهل حماة في العقائد المسمى بالعقيدة الحموية ، ولما أراد ابن تيمية أن يناظرهم وأرسل لهم الأمير هربوا ولم يحضروا ، وظل الأمر كذلك حتى عقد ابن تيمية مجلسه يوم الجمعة عند جماعة من الفضلاء وبحثوا في الحموية وناقشوه فيها ، فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير . فانظر كيف يشيع العلماء وهم أهل الحق باطلا ؛ لينالوا به من عالم ظنوه يزاحمهم على الدنيا ، والرجل من هذا الأمر براء ، كما تشهد سيرته ومحنته . فإذا أضفنا إلى هذا ما سجله ابن كثير في حوادث عام ( 701 هـ ) كانت النكبة أشد فيما وصل إليه العلماء ، وفي هذا الشهر ( شوال ) ثار جماعة من الحسدة على الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وشكوا منه أنه يقيم الحدود ، ويعزر ويحلق رؤوس الصبيان ، وتكلم هو أيضا فيمن يشكو منه ذلك ، وبين خطأهم ، ثم سكنت الأمور . 2 - ولو كان الأمر يقف عند حد الاتهام لهان الأمر إذ يمكن أن يقال : إنه داخل في باب الاجتهاد الذي يخطئ صاحبه ، أما أن يصل الكيد إلى حد التزييف والكذب ، فهذا هو الخطر الحقيقي ، وقد حدث ذلك في سنة ( 726 هـ ) عندما سئل ابن تيمية مِن عالمين عن مضمون قوله في مسألة زيارة القبور فكتب ذلك في درج ، فكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق : قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية إلى أن قال : وإنما المحز جعله زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبور الأنبياء - صلوات الله عليهم - معصية بالإجماع مقطوعا بها . ويقول ابن كثير معلقا : " فانظر الآن على هذا التحريف على شيخ الإسلام ويحكي حقيقة قوله ، وأن كتبه تفيض بغير ما حرفوا ، وفهمه لم يكن ليصل إلى ما اتهموه به من قوله : الإجماع على معصية هذا " . 3 - الإفتاء بغير علم ، وكان من آفة الفساد في العلماء أن يتكلم بعضهم فيما لا علم له به ، فابن زهرة المغربي اقترف هذا الفساد سنة ( 712 هـ ) ، فطيف به في دمشق وهو مكشوف الرأس ، ووجهه مقلوب ، وظهره مضروب ، ينادى عليه : هذا جزاء من يتكلم في العلم بغير معرفة . وقريب من هذا : ما كان يفعله بعض المنتسبين من التكفير للناس بأدنى ملابسة ، ففي المحرم من سنة ( 714 هـ ) استحضر السلطان بين يديه الفقيه نور الدين علي البكري وهم بقتله فشفع فيه الأمراء فنفاه ومنعه من الفتوى والكلام في العلم . . . وذلك لاجترائه وتسرعه على التكفير والقتل ، والجهل الحامل له على هذا وغيره ، فانظر إلى حال من قاده جهله إلى الحجر عليه في عمله الذي به قيمته لأنه لم يحسنه ، فقيمة كل امرئ ما يحسنه . |
|
#8
|
|||
|
|||
|
تعقيب :
ولعل لنا في اعتبارهما مرحلتين فَهْما جعلنا نعتبر الحركة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب امتدادا وتجديدا لمرحلة ابن تيمية ، وذلك أننا نلحظ في الكتب التي صنفت في العقائد بعد الشيخ ابن عبد الوهاب ، نلحظ فيها تشابها كبيرا مع ما حملته إلينا رسائل ابن تيمية وفتاواه ، وهذا ليس بمستغرب ، بل هو الطبيعي ؛ لأن الهدف من هذه الحركة الإصلاحية إنما هو تجسيد عملي لما تغياه ابن تيمية في جهاده في عصره . ولعل ما قدمناه من ظروف المرحلتين وتشابههما إلى حد كبير يصلح إجابة للسؤال الذي انطلق من ملاحظة المؤلفات ذات الاهتمام بالعقيدة السلفية ، فتفرق الفرق واضطراب الأحوال ووجود أصحاب الأهواء ، وانتشار البدع ، وادعاء المهدية والنبوة ، ثم فساد أحوال العلماء نتيجة المعصية المهدية وتسرب لعصم الأفكار من الترجمة إليهم في المرحلة الأولى ، وطلبا للدنيا ، وفقدانا لرسالة العلم ، وأمانة العالم في المرحلة الثانية ، وكذ الأولى . كل هذا في جو مضطرب لا تقدم الدولة فيه عملها الأساس في الحفاظ على دينها ، هذا وغيره من أسباب جعلت العلماء المخلصين لدينهم وأمتهم (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 204) يقدمون ما يستطيعون في باب خدمة عقيدة السلف الصالح ، إيمانا منهم بأن هذه الأمة لن يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها ، وقد كان التزام الناس بالإسلام أول عهدهم به وزمن الرسول والراشدين من بعده ، سببا أساسيا في حضارة الأمة وريادتها الأمم الأخرى ، وبقدر ما انحلت رابطة الالتزام بين المسلمين والإسلام بقدر ما تقهقروا وصاروا فريسة لغيرهم ، لا عن قلة يحدث لهم ذلك ، ولكن مصداق قول الرسول الكريم : غثاء كغثاء السيل يوشك أن تداعى عليكم الأمم ، كما تداعى الأكلة على قصعتها . فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ، ولكن غثاء كغثاء السيل ولينزعن من صدور عدوكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن . قال قائل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال - عليه الصلاة والسلام - : حب الدنيا وكراهية الموت . والله المستعان وإليه المرجع والمآب . |
 |
| أدوات الموضوع | |
|
|