
 |
| جديد المواضيع |

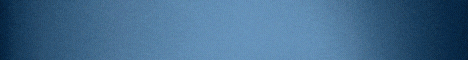

|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحروب ولوبيات السلاح إكسير الرأسمالية الإمبريالية تعد شركات السلاح الأميركية أهم لوبي في الولايات المتحدة، ويعدهم المراقبون صانعي القرار الحقيقيين، فهم القوى الخفية التي تدير وتنتج برامج ومخططات الحرب للحزب الحاكم في أميركا ما بعد الحرب الباردة، وبات جليا أن المتضرر من المشروع الإمبراطوري الذي تعمل له الإدارة الأميركية لم يعد يقتصر على العالم العربي والعالم الثالث، بل أصبح الضرر يشمل دول العالم الصناعي المتقدم في أوروبا وآسيا.وتفيد الدراسات التي أجريت في العقد الأخير من الزمان ان الحرب الباردة التي أنتجت سباق التسلح لم تنته إلا سياسيا، إذ أن مصانع السلاح لم تتوقف سواء في الولايات المتحدة او في دول حلفائها مثلما بقيت مستمرة في الكيان الصهيوني. وبدأت مرحلة جديدة في العالم بعد حرب كوسوفو، تمحورت حول التسارع للدخول في النادي النووي وحيازة السلاح الفعال خاصة بعد قيام حربين أميركيتين بدعوى "مكافحة الإرهاب"، ولذلك قال الباحثون ببروز أيديولوجيا "صناعة الارهاب". وطبقا للدراسات المعنية فأن الحقبة الجديدة التي بدأت مع عهد جورج ولكر بوش والتي تؤرخ ببدء الألفية الثالثة، أنتجت جماعات ولوبيات تمثلت بتيار المحافظين الجدد الذين يشكلون نسبة مهمة من لوبي صناعة السلاح والنفط والتي دخلت في إطار أدلجة العداء والحرب وروجت لما سبق أن عُدت خطط استراتيجية جاهزة تضمنت نظرية صراع الحضارات والدفاع القومي الذي افرز نظرية جديدة للأمن الأميركي دون ما سواه. ويرى الدكتور عبد الغني عماد وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية، أن هناك "مؤسسات ضخمة تعنى بالفكر الاستراتيجي، وبتحويله إلى خطط وخرائط وبرامج وأولويات يطلق عليها Think Tanks أي دبابات الفكر، وهذه التسمية التي تمزج الفكر بفلسفة القوة لم تأتِ مصادفة، فهي تعبر عن التحالف بين الفكر والسلاح في الولايات المتحدة، وهذه المؤسسات الاستراتيجية وبيوت الخبرة السياسية تمثل قوة ضاغطة وفاعلة تعمل بنشاط قل مثيله في العالم، وهي تتموّل وتتمتع بميزانيات ضخمة من كبريات الشركات الأميركية المعولمة". ويشير إلى أن "هذه الشركات العملاقة الممولة يقارب إنتاجها ما يساوي 25 في المئة من الإنتاج العالمي"، يذكر على سبيل المثال أن خمسة منها (جنرال موتورز) و(وال مارت) و(إكسون موبيل) و_فورد) و(ديملركرايسلر) يتجاوز ناتجها القومي 182 دولة في العالم، بل أن شركة (أكسون) يفوق دخلها دول (الأوبك) مجتمعة، وشركة (جنرال موتورز) يساوي دخلها دخل الدانمارك، وشركة (بكتيل) للمقاولات، يساوي دخلها إسبانيا. وشركة (شل) يساوي دخلها فنزويلا، وأن هذه الشركات وغيرها هي طليعة القوى الصانعة للعولمة، وهي الأسخى تبرعاً "وتمويلاً لمرشحي الرئاسة الأميركية ولمراكز الأبحاث وبيوت الخبرة السياسية والاستراتيجية مثل مؤسسة التراث (انشئت منذ 30 سنة) ومركز مانهاتن للدراسات (انشيء من 25 سنة) ومؤسسة المشروع الأميركي (انشيء منذ 60 سنة). ومركز هوفر (انشيء من 25 سنة) ومؤسسة المشاريع الأميركية AEI ومركز سياسة الأمن و(المؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي) JINSA، وقد أصبح أعضاء في هذه المؤسسات نجوم الفضائيات وصانعي القرار في الإدارة ومنهم كوندوليزا رايس وبول ولفوفيتز وريتشارد بيرل ودوغلاس فايث وريتشارد أرميتاج وديفيد ورمسر، ودونالد رامسفيلد، وديك تشيني". وتشير الدراسات إلى أن دوايت ايزنهاور حذر المجتمع الأميركي عام 1962 مما سماه بـ"الوحش الكاسر الذي ينمو في أحشاء الولايات المتحدة" وقال: "إن مواقع القرار الأميركي يجب حمايتها من هذا التحالف العسكري ـ الصناعي الرأسمالي وإلا ستكون العواقب كارثية، لأننا بذلك نضع سلطة القرار في أيدٍ غير مسؤولة، لأنها غير مفوضة. وبالتالي لا يصح أن تؤتمن عليه، وأود أن ألفت النظر إلى أنه إذا وقع القرار الأميركي رهينة لمثل هذا التحالف الصناعي ـ العسكري وأطرافه، فإن الخطر سوف يصيب حرياتنا وممارساتنا الديمقراطية كما أنه قد يصل إلى حيث يملك حجب الحقائق عن المواطنين الأميركيين وبالتالي الخلط بين أمن الشعب الأميركي وحرياته من جهة وبين أهداف أطراف هذا التحالف ومصالحهم". وحش من رحم حرب التحرير لا بد من القول أن الولايات المتحدة خرجت من حرب التحرير وهي عاقدة العزم على خوض غمار القوة العظمى أو بناء الإمبراطورية الأميركية، ويرى الباحثون أن الحرب الأميركية الإسبانية عام 1898 صنعت القوة الأميركية الإمبريالية، فقد تواصلت حروب الولايات المتحدة بلا توقف خارج حدودها، وذلك تطلب منها تأسيس صناعة قادرة على تحمل نفقات ومتطلبات هذه الحروب، فنمت صناعة السلاح، وأضيف إليها تجارته التي تطلبت منها أيضا صناعة الحروب في دول العالم والتي كانت أهم أسواقها لذلك السلاح. ومبررات القوة الإمبريالية الأميركية كمنت في العدو الذي صنعه استراتيجيوها والذي افرزه النظام العالمي الثاني بعد الحرب العالمية الثانية، إذ كان حدثا سعيدا للولايات المتحدة آنذاك عندما خرق السوفييت اتفاق يالطا وقسموا العالم إلى نصفين قطبيين، والواقع أن هناك دراسات تشير بوضوح إلى أن أيادي صهيونية وأميركية من لوبيات المصالح والسلاح كانت وراء خلق عالم القطبين ونظامه. على أن حرب فيتنام شكلت وجها آخر لسياسة إنتاج السلاح الأميركي، إذ يرى الكثيرون ان الحكومات الأميركية المتتابعة حرصت على وضع استراتيجية تؤمن للولايات المتحدة ما يطلق عليه بـ "الحرب من طرف واحد" وهو يعني تأمين سلاح أميركي متطور لا يمتلكه غير الأميركيين وبإمكانه أن يحدث الرد ضد من أية مخاطر قد تصيب الأمن القومي الأميركي، وهو ما يشير إليه الباحثون الذين رأوا أن ايزنهاور إنما دعا إلى تأمين ترسانة عسكرية تضمن هذا النوع من "الحرب من طرف واحد". بالأخص صواريخ كروز، متجاهلين التحذير الذي ورد في خطابه الأخير، ورغم ذلك فإن فيتنام بقيت فزاعة رعب يستخدمها الاستراتيجيون المرتبطون بلوبي السلاح من أجل تعزيز الاستراتيجية العسكرية والتي بلغت اوجها في عهد الجمهوريين الأخير الذي يرأسه بوش الابن بالبدء ببرنامج الدرع الدفاعي الصاروخي. بنت الولايات المتحدة استراتيجيتها للنظام العالمي الجديد على أسس إمبريالية تستهدف هدم العالم القديم أو عالم الحرب الباردة وإعادة ترتيب الأوضاع والسيطرة على مقدرات وثروات العالم، وبالطبع فان هذه المخططات تحركها عدة لوبيات أولها لوبي السلاح الذي يتحكم في استثمارات بالمليارات، ولذا كان الدفع باتجاه العمليات العسكرية من أجل تجريب أنواع جديدة من الأسلحة وتنشيط مبيعات شركات السلاح. {وَالفِتْنَةُ أشَدّ مِنَ القَتْل} صدق الله العظيم ومن لوبيات السلاح المعروفة إلى لوبي البترول، وهو صاحب سطوة ونفوذ لدرجة أنه يساعد في تحديد شخصية من يحكم هناك، ولا بد من الإشارة إلى أن استخدام العرب للبترول كسلاح عام 1973 دفع الأميركيين إلى البحث عن بدائل مقابلة لم تتوقف عند البحث عن أسواق نفطية بل امتدت إلى البحث عن آليات السيطرة على النفط وحقوله ودوله من اجل تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية، ولذا نجد أن هذا السلاح بات من أهم الأسلحة ولوبيات المصالح في أميركا، فهي التي تمد مصانع السلاح بما تحتاجه من دعم مادي، لقد ارتبط البترول بلوبي السلاح والمصالح الاستراتيجية الأميركية، ولم تستطع أية حكومة أميركية الخروج عن سطوتها، فهذه اللوبيات كانت تمد الحكومة الأميركية بقوتها. وينظر إلى الولايات المتحدة منذ نشوء الدولة باتفاق 13 ولاية على إعلان الاستقلال (1776) والتي اتسعت غربا وجنوبا وشمالا حتى القرن العشرين لتصير 50 ولاية، إذ نجد أن رقعة انتشار القوات والقواعد الأميركية في الخارج قد ازدادت منذ دخول أميركا الحربين العالميتين، فأصبحت تنتشر في أكثر من 130 دولة تتوزع فيها قرابة 500 قاعدة عسكرية من أبرزها القواعد الأميركية في اليابان. وفي ألمانيا والخليج، كما تجوب أساطيل أميركا بحار ومحيطات العالم وقد اقترب حجم الإنفاق العسكري إلى 400 مليار دولار سنويا وهو الأعلى على المستوى العالمي وقد عدت فيتنام نقطة تحول في سياسة أميركا تجاه الانتشار في أنحاء العالم وممارسة هيمنتها. ومع المخططات التي انتعشت بسقوط الاتحاد السوفييتي، وجدنا لوبي السلاح ولوبي الشركات العملاقة خاصة البترولية واللوبي اليهودي، قد مارست جميعها ضغطا على الإدارات الأميركية، وخاصة في الصراع العربي "الإسرائيلي"، فارضة عليها منطق الحرب الذي برز بأوضح صوره بالرغبة في إشعال الحروب في عهد المحافظين الجدد، وتذكر الدراسات أن جبهة المحافظين الجدد التي تهيمن على إدارة بوش ورغم أزمات الملفات المفتوحة للصراعات (أفغانستان والعراق) فإنها تدفع الإدارة إلى المزيد من إطلاق القوة الأميركية . وتعزيزها عن طريق التدخل في الصراعات المسلحة وبناء المزيد من القواعد العسكرية وزيادة حجم الإنفاق العسكري وتركيز هذا الإنفاق على برامج تطوير نظم التسليح لتنمية وتطوير القدرات العسكرية الأميركية، يهيمن عليها توجه تحقيق الحلم الإمبراطوري. تسلح وكلفة وحروب تشير التقارير إلى أن نفقات التسلح العالمية في عام 1998 وصلت إلى ما يقارب 700 مليار دولار مقارنة بنفقات 1995 ورغم أن مؤشر الارتفاع قوطع بانخفاض في نفقات التسلح لكنه عاد فارتفع مسجلا نسبة 5. 3% عما كان عليه الأمر عام 1997 ومقارنة بعام 1987 فان معدل الارتفاع كان عاليا جدا إذ شهد عام 1987 انخفاضا في التسلح. ورغم أن نفقات التسلح الروسية خفضت من حجم التسلح في العالم بنسبة 55% عام 1998 إلا أنها بقيت الوحيدة التي انحدرت من على سلم التسلح بينما لم تخفض أميركا وفق اتفاقاتها مع روسيا سوى 4% من تسليحها لكنها عادت فزادته لتمول أجيال الأسلحة الحديثة. تمركز الإنتاج العالمي للسلاح بشكل عال في دول صناعية معدودة. وتظهر الإحصائيات التقريبية لسنة 1996 أن الولايات المتحدة تنتج ما يعادل نصف ما تنتجه اكبر عشر دول منتجة للسلاح في العالم ويذهب الخبراء إلى أن إنتاج الولايات المتحدة يصل إلى 90% من إنتاج العالم. وتعد الولايات المتحدة على قائمة الدول المصدرة للسلاح لحقبة 1994 ـ 1998 تليها روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتايوان و"اسرائيل" وفي نهاية عام 1999، بدت اتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية ابعد ما تكون عن التوقيع. فقد تصاعدت المشاريع المطورة لأسلحة كيماوية وبيولوجية حديثة ورغم أن المنظمات الطبية حذرت من آثارها لكنها تبقى محور تنافس محموم بين الدول. وتذكر الدراسات أن مصانع إنتاج الأسلحة والذخيرة الأميركية قد بدأت في تجهيز كم هائل من القاذفات الجوية والقنابل ومختلف أنواع الذخيرة منذ انطلاق أول إشارة أميركية لاحتمال التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في يوغسلافيا وكان لدى تلك المصانع تأكيدات بأن المشتري جاهز بأمواله فلابد أن تكون هي أيضا مستعدة بالأسلحة والمعدات المطلوبة لتوريدها. كانت فائدة الولايات المتحدة الأميركية في حروبها التسعينية كبيرة. فقد دارت عجلات الإنتاج في مصانع أسلحتها كثيرا وحدث رواج اقتصادي حقق مكاسب جمة دفعت الكونغرس الأميركي لزيادة الميزانية العسكرية لعملية "تصميم القوة". ويشار إلى أن مصانع السلاح هذه التي حقق لها كلينتون أرباحا خيالية هي نفسها التي دعمت برامجه الانتخابية وتعدت فائدة أميركا الاقتصاد وانتعاشه إلى تدريب قواتها العسكرية على التطبيق في أراض أوروبية لها خصوصية تختلف عن مناخ الحرب العالمية الثانية. فهناك حرب الخليج والعراق وكوسوفو وذلك ساعد في رفع القدرة القتالية بجانب التعرف على مختلف البيئات في العالم تحسبا لحدوث حروب مستقبلية. ويسجل لأميركا أنها جربت جيل الأسلحة الجديدة، قسماً منه في البلقان والقسم الآخر في أفغانستان والعراق. وتدر شركات صناعة السلاح الأميركية أرباحا لا تقدر بثمن وتقوم بتشغيل مئات الآلاف من العمال والمهندسين ويعيش على هامشها الملايين من البشر وهي الشركات تنمو وتزدهر من جراء الحروب التي تشنها واشنطن على الشعوب الأخرى تحت دعاوى عدة منها: "مقاومة المد الشيوعي"، "محاربة الإرهاب"، "الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة"، و"ضرب الحركات المتطرفة"، أو تحت أي عذر يخطر على بال صانع السياسة الأميركية. وتشير التقارير إلى أن رؤساء شركات السلاح الأميركية يستلمون مبالغ هائلة تكاد تكون خيالية، فعلى سبيل المثال يستلم مدير شركة لوكهيد مارتن سنويا راتبا يقدر بـ 26 مليون دولار ومدير (جنرال داينامكس) ما يقارب 16 مليون دولار ومدير شركة (هونيول للأجهزة الملاحية العسكرية) 4,5 ملايين دولار سنويا، أما مدير شركة (اليانت لصناعة المقذوفات) فيستلم حوالي 5. 10 ملايين دولار سنويا. وتقدم شركات السلاح مبالغ هائلة للأحزاب السياسية المتنافسة على قيادة البيت الأبيض وكل شركة تدفع بمرشحها الذي يفترض فيه أن يفتح الأسواق أمامها ويسهل تصريف منتجاتها فالمصروفات العسكرية الأميركية ارتفعت إلى 400 مليار دولار وقد نجحت تلك الشركات في الدفع باتجاه الحرب والاستفادة من المآسي والمجازر والمذابح التي يعاني منها الناس وتعد الحرب طبقا للتقارير الإكسير الذي يعيد الشباب للرأسمالية فهي تعنى ببساطة تشغيل مصانع السلاح ومعدات القتال و إمدادات الجيوش وإهلاكها، وتجنيد وتشغيل المتعطلين عن العمل سواء في الصناعات الحربية أو الدفاع المدني أو إهلاكهم في الحرب، وبذلك يتم التخلص من الفائض السكاني والسلع الراكدة على السواء. (و الاعياذ بالله)، مما يعنى إعطاء الرأسمالية فرصة جديدة للانتعاش مجددا سواء أثناء الحرب أو بعدها ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد ) صدق الله العظيم ، كما تتسبب الحروب أيضا في إهلاك وسائل وطرق الإنتاج المتخلفة وتدمير المدن والمرافق القديمة( والاعياذ بالله) لتأتى فترة السلام بعد الحرب والتي تطبق فيها معايير إعادة الإعمار والتي تدخل في بنيانها أيضا شركات السلاح بوجهها الآخر.(و الاعياذ بالله) (فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على البشر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي ) من حديث رسول الله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في الشفاعة |
 |
| أدوات الموضوع | |
|
|