
 |
| جديد المواضيع |

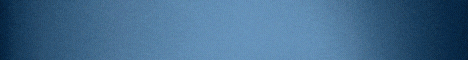
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
الضابط الخامس: مصلحة الدين لا تتمّ إلا إذا اقترنت النصرة بسلطان العلم والحجّة .
نصرة النبي -صلى الله عليه وسلم- المجرّدة عن العلم والحجّة صفة نقص وضعف؛ بخلاف النُّصرة المصاحبة لهما تكون صفة كمال وقوة ؛ فالنُّصرة مثلما تقوم بالردع والقوة فهي تقوم بالعلم والحجّة ؛ والقوة تطلب طلب وسائل، والحجّة تطلب طلب مقاصد ، والقوة تابعة والحجّة متبوعة؛ فالحجّة تطلب على الدوام ، والقوة تطلب عند الاحتياج . قال الرازي عند تفسير قوله تعالى : [ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ] {غافر:51} :" واعلم أن نصرة الله المحقين تحصل بوجوه أحدها : النصرة بالحجة ، وقد سمى الله الحجة سلطاناً في غير موضع ، وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع ، ونعم ما سمى الله هذه النصرة سلطاناً لأن السلطنة في الدنيا قد تبطل ، وقد تتبدل بالفقر والذلة والحاجة والفتور ، أما السلطنة الحاصلة بالحجة فإنها تبقى أبد الآباد"([55]). وقال تعالى: [ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ المُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا] {الفرقان:31} ؛ قال أبو السعود العمادي :"وعدٌ كريمٌ له عليه الصَّلاة والسَّلام بالهدايةِ إلى كافَّةِ مطالبِه والنَّصرِعلى أعدائِه أي كفاك مالكُ أمرِك ومُبلِّغك إلى الكمالِ هادياً لك إلى ما يُوصلك إلى غاية الغاياتِ التي من جُملتها تبليغ الكتاب أجلَه وإجراء أحكامه في أكناف الدُّنيا إلى يوم القيامة ونصيراً لك على جميع من يُعاديك "([56]). ومدار نصرة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- على قوة الحجة ووجود القدرة؛ فتارة يكون الانتصار له بالحجة والقدرة، وتارة يكون بالحجة فقط، ولا يكون الانتصارله بالقدرة من غير حجة ؛ كما قال تعالى: [ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ , إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ , وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ , فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ] {الصَّفات:171-174}. قال الإمام الطبري رحمه الله: "أي: أنهم لهم النُّصرة والغلبة بالحجج، ونقل ذلك عن السُّدي" ([57]). لذلك كان سلطان الحجّة أعظم من سلطان القدرة؛ لأنّ الدين لا يظهر ولا ينتصر إلا بظهور الحجّة، كما في ظهور حجّة الغلام في قصة أصحاب الأخدود أمام جموع الناس؛ فكانت حجته سببًا في إيمان المؤمنين؛ بخلاف القدرة فلا تؤثر إلا بواسطة الحجّة، يقول ابن القيم -معللًا تفضيل الحجّة على القدرة-: "لأنّ صاحب الحجّة له سلطان وقدرة على خصمه وإن كان عاجزًا عنه بيده" ([58]). والمتتبع للسيرة النبوية يقطع جازماً أن الصحابة -رضي الله عنهم- قد نصروا رسولهم -صلى الله عليه وسلم- بمكة – بالحجّة؛ ونصروه بالمدينة بالحجّة والقدرة ؛ وقد بينت ذلك بعض الآيات التي نزلت بالمدينة ؛ كما قال تعالى: [ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ] {المائدة:56} ( . قال البغوي - رحمه الله- في تفسير الآية: ) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا( "يعني: يتولى القيام بطاعة الله، ونصرة رسوله والمؤمنين، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : يريد المهاجرين والأنصار، ) فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ ( يعني: أنصار دين الله ) هُمُ الغَالِبُونَ (" ([59]). فالمصاحبة بين القوة والحجّة وعدم إلقاء العداوة بينهما في مواضع الدفاع عن الدين ونصرة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- شرط لازم لرفع الدرجات وبلوغ الغايات، يقول ابن القيم: "إنّ العلم بالحجج والقوة على الجهاد مما رفع الله به درجات الأنبياء وأتباعهم؛ كما قال تعالى: [ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ] {المجادلة:11}, وقال: [وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ] {ص:45} ؛ فالأيدي القوى التي يقدرون بها على إظهار الحق وأمر الله وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه، والأبصار البصائر في دينه"([60]).
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
|
#12
|
||||
|
||||
|
الضابط السادس: النصرة لا تتحقق إلا ببذل الواجب والمستحب من الدين بحسب الإمكان.
عندما يتحزّب أهل النفوس اللئيمة على نبي الهدى محمد -صلى الله عليه وسلم- ويظهرون ما أكنته ضمائرهم من الشّر والحسد يدرك أهل العلم والإيمان وأصحاب البصيرة والعرفان – بفضل الله ورحمته- أنّ أقوى أسباب الانتصار وأعظم خطط الدفاع هي أنْ يرجع المسلمون إلى دينهم ويراجعوا واقعهم ويحاسبوا أنفسهم ويتعاملوا مع النازلة بفقه واتباع ، وأنْ يبحثوا عن الأسباب الشرعية للنُّصرة ليصلوا إلى حقيقتين ثابتتين : إحداهما : أنّ كمال النُّصرة في كمال الطاعة . والثانية: أنْ ليس للمبطل الجاني صولةٌ وجولةٌ وحراكٌ إلا عند غفلة أهل الحقّ ؛ كما قال تعالى في سياق أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدعوَ ربه النّصر التام: [ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا , وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا] {الإسراء:80-81}. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي :" هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل، فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته" ([61]). فالانتصار للنبي -صلى الله عليه وسلم- والدفاع عنه والذب ّ عن سنته لا تكون مجدية مالم يحرص المسلمون على الالتزام بدينهم والصبر على طاعة ربهم في السراء والضراء، ومقابلة العدو بترك الذنوب والإقلاع عن المعاصي وهجر الشرك والبدع؛ والاصطفاف للمدافعة والمناصرة خلف راية الكتاب والسنة ونبذ الفُرقة والاختلاف ؛ يقول ابن القيم -رحمه الله- عند الكلام على طريقة المؤمنين في استجلاب النصر - :" لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها وأنها نوعان تقصير في حق أو تجاوز لحد ، وأن النّصرة منوطة بالطاعة ؛ قالوا : [رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا] {آل عمران:147} ؛ ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا فوفوا المقامين حقهما مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف "([62]). فمن طلب الانتصار لنبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم- طلب وسائل شرعية ومقاصد سامية فلا سبيل له في تحقيق ذلك وتكميله إلا بأن تكون نصرته بالله ولله وفي الله ، ويجتهد في عبادة ربه وطاعته بما أمكن ، ويحرص على الاقتداء بالكتاب والسنة ، ويتحرى العلم والعدل في معاملته للخلق ؛ يقول ابن القيم- أيضا-:" فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا وكان قيامه بالله ولله لم يقم له شيء ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعل له فرجا مخرجا، وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في اثنين منها أو في واحد؛ فمن كان قيامه في باطل لم ينصر وإن نصر نصراً عارضاً فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول وإن قام في حق لكن لم يقم فيه لله وإنما قام لطلب المحمدة والشكور والجزاء من الخلق أو التوصل إلى غرض دنيوي كان هو المقصود أولا والقيام في الحق وسيلة إليه فهذا لم تضمن له النصرة، فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جاهد في سبيله وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين وإن نصر فبحسب ما معه من الحق، فإن الله لا ينصر إلا الحق وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبر والصبر منصور أبداً فإن كان صاحبه محقاً كان منصوراً له العاقبة وإن كان مبطلاً لم يكن له عاقبة، وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله مستعيناً به متوكلاً عليه مفوضاً إليه بريا من الحول والقوة إلا به فله من الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك" ([63]).
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
|
#13
|
||||
|
||||
|
الضابط السابع : وجوب إظهار ( مقصد الرحمة ) في موضع الدفاع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .
يلحظ المتتبع لموارد الانتصار للنبي -صلى الله عليه وسلم- في القرآن والسيرة النبوية أنها لم تخلو من إبراز جانب الرحمة ؛ فحتى شدته -صلى الله عليه وسلم- بالكفار ومعاقبته لهم كانت مشوبةً بالرحمة ؛ فشدته عليهم شفقة، ، وعفوه عنهم إحسان، ومعاقبته لهم عدل ، وقتاله لهم رحمة ؛ فكان مقصد الرحمة ملازماً للنبي -صلى الله عليه وسلم- في المسالمة والمحاربة ، وفي المصابرة والمدافعة، وهو من عمومات الشريعة وكلياتها وعوائدها الثابتة المستقرة ؛ فأضحت البعثة النبوية من أولها إلى آخرها رحمة للمسلم والكافر؛ كما قال تعالى: [ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ] {الأنبياء:107} ؛ فمقصد الرحمة يظهر في مظهرين: الأول: تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة، والثاني: إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته([64]). فما من أحدٍ من الناس إلاّ وله حظ من هذه الآية؛ كما يقول ابن القيم -معلّقاً عليها-: "وأصح القولين في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ؛ أنه على عمومه وفيه على هذا التقدير وجهان : أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه فالمحاربون له عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة وهم قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر، وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته وهم أقل شراً بذلك العهد من المحاربين له، وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره، وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته. الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوها لهذا المرض فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض"([65]). وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أنه قال : لقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض طرق المدينة فقال : [أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم] ([66]) . قال العلامة عبد الرؤوف المناويُّ – شارحاً الحديث- :" ووجه كونه نبي الرحمة ونبي الحرب إن الله بعثه لهداية الخلق إلى الحق وأيده بمعجزات ؛ فمن أبى عذب بالقتال والاستئصال ، فهو نبي الملحمة التي بسببها عمت الرحمة وثبتت المرحمة" ([67]). وقد ظهر مقصد الرحمة - جلياً- في موضع الانتصار للنبي -صلى الله عليه وسلم- من المشركين والردّ عليهم ؛ كما جاء في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:(كأني أنظر إلى النبي r يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)([68]). وقد علّق الإمام ابن القيم - رحمه الله- على هذا الحديث بالقول : "وتأمل حال النبي الذي حكى عنه نبينا أنه ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول: [اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون] ([69]) ، كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه : أحدها: عفوه عنهم . والثاني: استغفاره لهم. الثالث: اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. الرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليه ؛ فقال [اغفر لقومي] كما يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به : هذا ولدي ؛ هذا غلامي ؛ هذا صاحبي ؛ فهبه لي"([70]). لذلك كانت معاملة النبي –صلى الله عليه وسلم- للمشركين بمكة معاملة عفوٍ وإحسانٍ لا معاملة تشفٍّ وانتقامٍ؛ كما في حديث عروة أن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي –صلى الله عليه وسلم- حدثته أنها قالت للنبي –صلى الله عليه وسلم- : [هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ـ وفي الحديث ـ: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا]([71]). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ـ معلقاً على الحديث-: "وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي –صلى الله عليه وسلم- على قومه، ومزيد صبره وحلمه، وهو موافق لقوله تعالى: [ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ] {آل عمران:159} وَقَوْله [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ] {الأنبياء:107} ..."([72]). وإذا شرع العبد بالدفاع عن نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم- في أي صورة من صور الدفاع فلا بد من إظهار الرحمة ؛ إذ مصلحة الانتصار له لا تقوم إلا بأن تقترن النّصرة بالرحمة ؛ فالنصرة وسيلة والرحمة غاية ، وبهما يتحقق التوسط بين الإفراط والتفريط، وبهما يكون الاعتدال بين برودة القلب ويبوسته؛ لذلك استعمل الرعيل الأول مع المشركين وأهل الكتاب كل سبيل موصل إلى نجاتهم وهدايتهم، وأعانوهم على تحصيل مصالح الدارين؛ فكان ذلك من مظاهر الرحمة والخيرية؛ حتى صارت محاربة المؤمنين للمشركين داخلة في معنى الرحمة والإحسان والفضل؛ كما جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:[عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل] ([73]) وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام ابن الجوزي في شرح الحديث؛ فقال : "معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول" ([74]) وقد جاء عن الصحابي الجليل أبي هريرة -رضي الله عنه- في تفسير قوله تعالى: [ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] {آل عمران:110} , قَالَ: [خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام]([75]). فلا تتمُّ مصلحة الانتصار لنبي الرحمة، ولا تتحقق مقاصد الدين إلا بالرحمة الحقيقية المبنية على العلم والهدى، لا على الجهل والهوى.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
الضابط الثامن: تصرفات الإمام في - باب النُّصرة - منوطة بالمصلحة .
وهذا الضابط يُبحث في أصلين : الأصل الأول: النّصرة التامة لا تتحقق إلا باقتران السماحة بالشجاعة: لا يصلح أمر الدين والدنيا ، ولا تحفظ ثغور المسلمين ، ولا تصان بيضة الإسلام إلا بأن يجمع إمام المسلمين – في سلوكه وخططه وتراتيبه – بين الشجاعة والسماحة ؛ فهو لا يعان على رعاية السياسة وتنفيذ الأحكام وتطبيق الحدود وحراسة الملة إلاّ إذا كانت سياسته في الملك ومعاملته مع الخلق مبنيةً عليهما معاً ؛ ليحصل من اجتماعهما الوسطية والاعتدال في النُّصرة من غير تهور ولا جبن . ولا يتردد القلم أن يخط حقيقة تاريخية وشرعية وهي: أن الأمة لم تنتفع بشيء مثلما انتفعت بالسّماحة المكيّة والشجاعة المدنيّة حتى صارت الشهامة السُّلطانيّة خادمةً للسّماحة الإسلامية وقائمة عليها بالرعاية والحفظ، وقد جمع نصٌّ قرآنيٌّ بينهما؛ فقال تعالى: [ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ , وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ] {الشُّورى:37-39} ؛ فجمعوا بين العفو والمغفرة لأعدائهم، وبين الانتصار عليهم؛ وقدم السّماحة على الشجاعة؛ لأن الآية مكية؛ فتحصل الكمال من اقترانهما؛ قال العلامة السّعدي رحمه الله -معلّقاً على الآيات- : "فوصفهم بالإيمان، والتوكل على الله، واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصغائر، والانقياد التام، والاستجابة لربهم، وإقامة الصلاة، والإنفاق في وجوه الإحسان، والمشاورة في أمورهم، والقوة والانتصار على أعدائهم، فهذه خصال الكمال قد جمعوها، ويلزم من قيامها فيهم، فعل ما هو دونها، وانتفاء ضدها"([76]). والحاجة إلى الشجاعة والسماحة حاجة عامة لكل الخلق وخاصة لولاة الأمر؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- :" هذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ؛ فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله كما يصبر المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم ، فالصبر على الأذى في العرض أولى وأولى ؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويندرج في ذلك ولاة الأمور فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس على غيرهم كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك" ([77]). وانظر – يا رعاك الله – كيف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد اتصف وتخلّق بالشجاعة والسماحة معاً في موضع الاعتداء عليه ؛ فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-ما- قال: [إنه غزا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قبل نجد فلما قفل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه فنزل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تحت سمرة فعلق بها سيفه قال جابر: فنمنا نومة، ثم إذا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي: من يمنعك مني قلت: الله. فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله –صلى الله عليه وسلم-] ([78]). وفي رواية أن النبي –صلى الله عليه وسلم- [عرض عليه الإسلام: قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله قال فذهب إلى أصحابه قال: قد جئتكم من عند خير الناس] ([79]). قال الحافظ ابن حجر _ عند ذكر فوائد القصة- :"فمنَّ عليه لشدّة رغبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام ، ولم يؤاخذه بما صنع بل عفا عنه... وفي الحديث فرط شجاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال" ([80]). وهاهنا ثلاثة أمور مهمة : أولها: أن النُّصرة الواجبة على ولي الأمر لا تظهر مصلحتها ولا يتحقق وقوعها إلا بالشجاعة والسماحة ؛ فالشجاعة بوحدها تفضي إلى التهور والاندفاع ؛ والسماحة بوحدها تفضي إلى الذُّل والخضوع. الثاني: أن الشجاعة تارة تسبق السماحة ، وتارة أخرى قد تتأخر عنها ؛ وهذا كله منوط بالاقتدار والمصلحة. الأمر الثالث: أن كل ما كان من باب الحدود والعقوبات الشرعية ، أو المناصرة بالقوة العسكرية ، أو المدافعة بالسيف ونحوها فهو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، ولا يجوز الافتئات عليه في أيّ حال من الأحوال . فينبغي إذن على من ينهض بواجب النّصرة والنّجدة من أئمة المسلمين أن يتصف بالبذل والإيثار، ويتخلّق بالسّماحة والصبر، ويتميّز بالشجاعة والإقدام، ويأمر بالعدل والإحسان، ويتحرى اتباع الكتاب والسنة ، ويعتني بمقاصد الشريعة، ويحرص على البطانات الناصحة ، ويكثّر من المشاورات النافعة.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
|
#15
|
||||
|
||||
|
الأصل الثاني: تخيير الأئمة في هذا الباب تخيير مصلحة لا تخيير شهوة.
ثمة فرق ظاهر بين قاعدة تخيير الأئمة، وقاعدة تخيير آحاد المكلفين ([81]), فإذا خُيّر الإمام بين أمرين، فعليه أن يختار ما فيه مصلحة للمسلمين؛ فيكون اختياره مبنيًا على الاجتهاد والمصلحة لا على المشيئة والشهوة. أمّا تخيير آحاد الناس فيختلف بحسب نوع التخيير؛ فقد يكون تخييرًا بين واجبين، أو بين مباحين؛ فيختار أرجحهما تارةً, وأيسرهما تارة أخرى، وقد يكون اختياره اختيار تشهي؛ كما في اختيار الولد لأحد أبويه في الحضانة، وقد جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: [ما خير رسول الله r بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما؛ فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه] ([82]). وقد حمل بعض العلماء معنى التخيير في هذا الحديث على ما كان من أمر الدنيا ([83])؛ وحمله علماء آخرون على الأخذ بالأيسر والأرفق في كل أمر فيه تخيير ما لم يكن حرامًا أو مكروهًا([84]). والأيسر والأرفق في باب نصرة النبي -صلى الله عليه وسلم- أو في باب التعامل مع الكفار والمشركين أن يختار الإمام ما فيه مصلحة للإسلام؛ فأيسر الأمرين في هذا الباب أكثرهما مصلحة وأقلهما مفسدة. قال أبو العباس القرافي رحمه الله -عند كلامه على الفرق بين قاعدة الأئمة وقاعدة آحاد الناس في التخيير-: "وأما التخيير بين الخصال الخمس في حقِّ الأسارى عند مالك رحمه الله ومن وافقه، وهي القتل والاسترقاق والمنّ والفداء والجزية، فهذه الخصال الخمس ليس له فعل أحدها بهواء، ولا لأنها أخف عليه، وإنما يجب عليه بذل الجهد فيما هو أصلح للمسلمين" ([85]). وقد تضافرت أدلة الشريعة على أن الإمام إذا خُيّر بين أمرين عند تعامله مع الكفار؛ فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين؛ كما في حادثة الأسرى؛ فقد اختار النبي –صلى الله عليه وسلم- الفداء وشاور أصحابه: فكان رأي أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- الفداء أيضًا، وكان رأي عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- قتل الأسرى؛ فنزل قوله تعالى: [ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآَخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ] {الأنفال:67} . وقد روى أهل التفسير عن ابن عباس –رضي الله عنها- في تفسير الآية، قال: (وذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتدّ سلطانهم، أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الأسارى : [ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً] {محمد:4} ؛فجعل الله النبيَّ –صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادَوْهم)([86]). أي: أن النبي –صلى الله عليه وسلم-في قضية الأسرى- اختار أولًا ما كان أسهل وأيسر؛ لأنه –صلى الله عليه وسلم- ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن الأصلح للمسلمين في ذلك الوقت أن لا يكون لهم أسرى حتى يُثخِن في الأرض ثم خُيّر بعد ذلك بين الفداء، أو القتل، أو ما فيه مصلحة للمسلمين، قال تعالى: [ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا] {محمد:4} . قال الشنقيطي رحمه الله: "وأكثر أهل العلم يقولون أن الآية ليست منسوخة، وأن جميع الآيات المذكورة محكمة؛ فالإمام مخيّر وله أن يفعل ما رآه مصلحة للمسلمين، من منّ وفداء وقتل واسترقاق" ([87]). والمقصود أن أيَّ تخيير مع الكفار ينبغي أن يكون مبناه على المصلحة، وأنّ هذا التخيير من خاصّية الإمام ومنوط به، وهو في اختياره هذا يكون مجتهدًا؛ إذ الأصل أن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة ([88]). وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن الإمام إذا خُير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء؛ فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين فيكون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا بحكم الله، ويكون له أجران، وقد لا يصيبه فيثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة" ([89]). وهناك أمور ينبغي على ولي الأمر أن يغلب فيها جانب العقاب والزجر ؛ إذ لا تظهر المصلحة في بعض أنواع الانتصار إلا بالمعاقبة والردع ؛ كسبِّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وشتمه ؛ لأن " ضرر السب في الحقيقة إنما يعود إلى الأمة بفساد دينها وذل عصمتها وإهانة مستمسكها ؛ وإلا فالرسول صلوات الله عليه وسلامه في نفسه لا يتضرر بذلك" ([90]). وقد ظهر من هذين الأصلين أن الدفاع الممدوح عن نبي الرحمة محمد -صلى الله عليه وسلم- شرعا وعقلا - يكون بالشجاعة والسماحة واستطلاب المصلحة... وفق الله تعالى أئمة المسلمين وحكامهم للاتصاف بهذه الخصال ، وأعانهم على القيام بواجب النُّصرة لله وللرسول -صلى الله عليه وسلم- ، وفتح عليهم من أسباب طاعته ومرضاته. فإن قيل : إنه قد يتعذر- في وقتنا الحاضر - في بعض البلاد والأمصار وجود أئمة يقومون على أمر الدين – نصرةً وجهاداً – في وقت قد تكالبت فيه قوى الشّر على نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم- بالطعن والاستهزاء ؛ فما الحل للخروج من هذا المأزق؟ فالجواب أن يقال : إن إحسان الظن بأئمة المسلمين وحكامهم مطلوب على الدوام؛ ففي الأمة خيرٌ كثير وعطاءٌ وفير , لكن يحتاج إلى تفعيل وتثوير؛ كما أخبر الصادق الأمين: [مثلُ أمتي مثلُ المطر، لايُدْرى أوّله خيرٌ أم آخره] ([91]). وعند تعذر الكمال فيصار إلى الأمثل فالأمثل منهم، ثم إذا تعذر الكمال في آحادهم ، فقد يعوّض بتعاون المجموع واجتماعهم على كلمة سواء. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
الخاتمة
وفيها تلخيص لنتائج البحث: 1_ إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة جامعة لكل الوسائل والأسباب والأحوال المتاحة التي بها يتحقق الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ، وذلك بطاعة أمره، والسعي إلى نصرته وتعزيره، والجهاد عن دينه والذب عنه، وبيان ما أُرسل به من الحق. 2_ إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم جنس تحته أنواع متفاوتة في الرتب، ولابد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. 3_ لقد اعتبر الشرع الحنيف أي نوع من أنواع انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدم توقيره نازلة جسيمة يجب إلحاقها بأشدّ المحرمات وأعلى الجنايات لما اشتملت عليه من المفاسد العظيمة والأضرار الكبيرة على الإسلام وأهله. 4_ إن أحكام الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع بتنوع المصالح والأحوال والأوقات، وهي تقبل التفاوت والتبعيض والانقسام، ويشتغل الموفق في كل وقت بما هو واجب ذلك الوقت. 5_ قد جعل الشرع الحنيف تكميل الإيمان، وتحصيل المحاسن والفضائل، والتفاضل بين أهل الإيمان منوطاً بالسبق إلى الهجرة والنُّصرة معاً. 6_ قد تقرر- في البحث - أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي من موجب محبته ومقتضاها؛ وأن الانصراف عن نصرته مع القدرة التامة يعدّ شعبة من النفاق. 7_ إن الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم تكليف شرعي وواجب ديني يناط بالاستطاعة الشرعيّة، لذلك يسوغ للعبد أن يكتمه تارة ويظهره تارة أخرى، بحسب حال القوة والضعف، وبحسب استطاعته الشرعية ورجحان المصلحة على المفسدة. 8_ وإنه يجب أن تكون وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم شرعية، ومتفقة مع أحكام الشريعة ومنسجمة معها، وبعيدة كل البعد عن الحرام والشبهة ، وأن تندرج هذه الوسائل تحت معاني كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أُثر عن سلف الأمة؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 9_ وقد ظهر أن مصلحة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحصل إلا بالفهم الدقيق لمقاصد الشريعة ، والنظر الثاقب في أولويات الدين، والبصيرة التامة بالحق ، والتضلع الكبير بأحكام النوازل. 10_ وقد تبين لنا أن الشرع قد أمر المؤمنين - إذا أرادوا الدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم- بالعدل لا بالظلم ، وبالحقّ لا بالباطل ، وبالصلاح لا بالفساد ، وبالسنة لا بالبدعة. 11_ ومدار نصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على قوة الحجة ووجود القدرة؛ فتارة يكون الانتصار له بالحجة والقدرة، وتارة يكون بالحجة فقط، ولا يكون الانتصار له بالقدرة من غير حجة. 12_ وظهر أنّ كمال النُّصرة في كمال الطاعة، وأنْ ليس للمبطل الجاني صولةٌ وجولةٌ وحراكٌ إلا عند غفلة أهل الحقّ في اتباع حقهم والالتزام به ظاهرا ً وباطناً. 13_ إذا شرع العبد بالدفاع عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في أي صورة من صور الدفاع فلا بد من إظهار الرحمة ؛ إذ مصلحة الانتصار له لا تقوم إلا بأن تقترن النّصرة بالرحمة ؛ فالنصرة وسيلة والرحمة غاية. 14_ إن النُّصرة الواجبة على ولي الأمر لا تظهر مصلحتها ولا يتحقق وقوعها إلا بالشجاعة والسماحة ؛ فالشجاعة بوحدها تفضي إلى التهور والاندفاع ؛ والسماحة بوحدها تفضي إلى الذُّل والخضوع. 15_ كل ما كان من باب الحدود والعقوبات الشرعية ، أو المناصرة بالقوة العسكرية ، أو المدافعة بالسيف ونحوها فهو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، ولا يجوز الافتئات عليه في أيّ حال من الأحوال .
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
|
#17
|
||||
|
||||
|
التوصيات
أولاً:ضرورة الاعتناء بجانب التأصيل الشرعي، والوقوف على مقاصد الشريعة، وتغليب النظر المصلحيعند بحث مسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم . ثانيا: الاعتناء بجانب نشر العلم الشرعي ، وحث الناس على الالتزام بالشريعة والاحتكام إليها في عباداتهم ومعاملاتهم ؛ وبيان أن هذا من أهم أسباب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: الاعتناء بفقه السيرة ودراستها دراسة منهجية على ضوء منهج أهل الحديث والفقه، واستظهار معالم النصرة الشرعية المنضبطة من نصوصها وأحداثها. رابعا: الاعتناء بالفقه الجامع للوازم العلم ومدارك الأحكام: كواجب الوقت ، وفقه الواقع ، وفقه الأولويات ، وفقه النوازل ، وفقه المآلات ، وفقه الدعوة ، وفقه السنن الكونية ، فقه السياسة الشرعية... خامساً : السعي بكل ممكن لربط الأمة بولاة أمورها من الأمراء والعلماء الربانيين على أساسٍ شرعيٍّ؛ وتحجيم المتصدرين للفتوى والتدريس من الكلام في القضايا المهمة للأمة من غير علم ولا برهان.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
|
#18
|
||||
|
||||
|
المصادر
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، تأليف: أبي السعود محمد بن محمد العمادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - الاستقامة، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - 1403، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رشاد سالم - الأشباه والنظائر، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1403، الطبعة: الأولى - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 1415هـ - 1995م. ، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. - اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات , تأليف: عبدالرحمن بن معمر السنوسي , الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1424هـ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الجيل - بيروت - 1973، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد - بدائع الفوائد، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - 1416 - 1996، الطبعة: الأولى، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد . - التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور,تأليف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393هـ) , الناشر : مؤسسة التاريخ العربي، بيروت – لبنان , الطبعة : الأولى، 1420هـ/2000م - تفسير القرآن، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، دار النشر: المكتبة العصرية - صيدا، تحقيق: أسعد محمد الطيب - تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1401 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1421هـ- 2000م - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1405 - جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار النشر: دار العروبة - الكويت - 1407 - 1987، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة , تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي أبوبكر , الناشر: دار الكتب العلمية ، دار الريان للتراث - الطبعة الأولى - 1408 هـ - 1988 - زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار النشر: مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت - 1407 - 1986، الطبعة: الرابعة عشر، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط - سلسلة الأحاديث الصحيحة , إعداد : محمد ناصر الدين الألباني , الناشر : مكتبة المعارف الرياض 1416 - الجامع الصحيح سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - -، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون - السنن الكبرى , تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي , الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد, الطبعة : الأولى ـ 1344 هـ - صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1392، الطبعة: الطبعة الثانية - الصارم المسلول على شاتم الرسول، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: دار ابن حزم - بيروت - 1417، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني , محمد كبير أحمد شودري - الجامع الصحيح المختصر، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا - صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1414 - 1993، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب - الفروسية، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار النشر: دار الأندلس - السعودية - حائل - 1414 - 1993، الطبعة: الأولى، تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان - الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش )، تأليف: أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ - 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل المنصور - فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 1356هـ، الطبعة: الأولى - قاعدة في المحبة، تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة، تحقيق: د. محمد رشاد سالم - قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج1-2، تأليف: أبي محمد عز الدين السلمي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - مجموع الفتاوى , تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي - مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر - مشكاة المصابيح ، تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1985، الطبعة: الثالثة ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني - شرح مشكل الآثار، تأليف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت - 1408هـ - 1987م، الطبعة: الأولى، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - معارج التفكر ودقائق التدبّر، تأليف : لعبدالرحمن حبنكة الميداني , الناشر : دار القلم –دمشق. - معالم التنزيل، أليف: البغوي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك - المعجم الكبير، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، دار النشر: مكتبة الزهراء - الموصل - 1404 - 1983، الطبعة: الثانية، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي - معرفة الصحابة , تألبف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ,تحقيق : عادل بن يوسف العزازي , الناشر : دار الوطن للنشر – الرياض , الطبعة : الأولى 1419 هـ - 1998 م - مفاتيح الغيب , تأليف: الإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1421هـ - 2000 م - المفردات في غريب القرآن، تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد ، دار النشر: دار المعرفة - لبنان، تحقيق: محمد سيد كيلاني - منهاج السنة النبوية، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: مؤسسة قرطبة - 1406، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رشاد سالم - نصب الراية لأحاديث الهداية، تأليف: عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، دار النشر: دار الحديث - مصر - 1357، تحقيق: محمد يوسف البنوري - النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - 1399هـ - 1979م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
|
#19
|
||||
|
||||
|
الهوامش:
([1]) تفسير ابن كثير (2\67) . ([2]) الصارم المسلول (2\397) ([3]) الصارم المسلول (3\906) . ([4]) تيسير الكريم الرحمن (ص\228). ([5]) جامع البيان في تأويل القرآن (7/ 264- 265) . ([6]) أَخرجه البخاري برقم (2981 ) ومسلم برقم (1062) . ([7]) شرح النووي على صحيح مسلم ( 7/158) . ([8]) رواه البخاري برقم ( 3330) ، ومسلم برقم ( 2584) . ([9]) انظر : مفردات غريب القرآن، للراغب الأصفهاني ص (108). ([10]) تفسير ابن كثير (8/28). ([11]) أضواء البيان (8/ 98). ([12]) البخاري برقم (2443) , ومسلم برقم (2584) . ([13]) البخاري برقم (2442) , ومسلم (2580). ([14]) الصارم المسلول (2/ 395-396). ([15]) رواه البخاري برقم (2631 ) ومسلم برقم (1864). ([16]) النهاية في غريب الحديث (5/ 202). ([17]) رواه الطبراني في " المعجم الكبير" برقم (3011) ، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة" برقم (1739) ، والطحاوي في مشكل الآثار برقم(1722 ) . ([18]) مشكل الآثار (5/ 49). ([19]) جلاء الأفهام (ص234- 235). ([20]) البخاري برقم (2970). ([21]) انظر: الصارم المسلول، لابن تيمية (2/315). ([22]) البخاري برقم (3670). ([23]) البخاري برقم (3643). ([24]) رواه البخاري برقم (3572) ومسلم برقم (75) . ([25]) الصارم المسلول(3/1093). ([26]) مسلم برقم (1910) . ([27]) قاعدة في المحبة (ص\93- 95 بتصرف يسير) . ([28]) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (3/49). ([29])رواه الطبري في تفسيره برقم (9953). ([30]) البخاري (1/94)، مسلم (3/1418). ([31]) شرح صحيح مسلم، للنووي (6/251). ([32]) انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/377). ([33]) منهاج السّنة النبوية، لابن تيمية (6/425). ([34]) رواه الطبري في تفسيره (23/427). ([35]) البخاري برقم (6776)، ومسلم برقم (1867). ([36]) الصارم المسلول(2/ 413). ([37]) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/492). ([38]) مفاتيح الغيب، للرازي (13/396). ([39]) تيسير الكريم الرحمن، للسِّعدي (1/892). ([40]) معارج التفكر ودقائق التدبّر، لعبدالرحمن حبنكة الميداني (1/174). ([41]) البخاري برقم (3059)، ومسلم برقم (1795). ([42]) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (1/ 166). ([43]) إغاثة اللهفان (2/72) . ([44]) منهاج السنة (6/ 386) . ([45]) مجموع الفتاوى (27/ 230) . ([46]) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/314). ([47]) الصارم المسلول، لابن تيمية (3/925). ([48]) الترمذي برقم (1450)، و الترمذي برقم (2492)، وصححه الألباني في تحقيقه على مشكاة المصابيح برقم (3601). ([49]) رواه البيهقي في السنن الكبرى (9/105)، وانظر: نصب الراية، للزيلعي (3/343)، وحاشية كتاب اعتبار المآلات للسنوسي، فقد ساق شواهده، أنظرها هناك (ص153). ([50]) انظر كتاب اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، لعبد الرحمن السّنوسي، (ص152 ـ 153). ([51]) إعلام الموقعين (3/138) . ([52]) تفسير الطبري (21/550) . ([53]) الاستقامة (1/40) . ([54]) مجموع الفتاوى (6/ 26) . ([55]) مفاتيح الغيب (13/345) . ([56]) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/103) ([57]) تفسير الطبري (21/130). ([58]) الفروسية، لابن القيم (ص186). ([59]) معالم التنزيل، للبغوي (3/73). ([60]) الفروسية، لابن القيم (ص186). ([61]) تيسير الكريم الرحمن (ص\464). ([62]) زاد المعاد (3/ 225_ 226). ([63]) إعلام الموقعين (2/ 178_ 179). ([64]) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور (9/220). ([65]) جلاء الأفهام، لابن القيم الجوزية ص (181-182). ([66]) البخاري برقم (3532) , ومسلم برقم (2354) . ([67]) فيض القدير (3/ 45) . ([68]) رواه البخاري برقم (3290). ([69]) البخاري برقم (3477) , ومسلم (1792) . ([70]) بدائع الفوائد، لابن القيم (2/ 468). ([71]) البخاري برقم (3231) , ومسلم (1795) . ([72])فتح الباري، لابن حجر (6/ 316). ([73]) صحيح البخاري برقم (2848). ([74]) فتح الباري، لابن حجر (6/145). ([75]) رواه البخاري برقم (4281). ([76]) تيسير الكريم الرحمن (759). ([77]) مجموع الفتاوى (28 / 180) . ([78]) البخاري برقم (3822). ([79]) عند أحمد في المسند برقم (14401)، والبيهقي في دلائل النبوة برقم (1272). ([80]) فتح الباري (7/ 426 - 427). ([81]) انظر: الفروق، للقرافي (3/33 ـ37). ([82]) البخاري برقم (3367)، مسلم برقم (2327). ([83]) انظر: فتح الباري، لابن حجر (6/575). ([84]) انظر: شرح النووي على مسلم (15/83). ([85]) الفروق، للقرافي (3/33). ([86]) رواه الطبري في تفسيره برقم (16286)، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم (9155). ([87]) أضواء البيان، للشنقيطي (7/248 ـ249). ([88]) انظر: قاعدة (تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة) في الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص121). ([89]) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (34/116). ([90]) الصارم المسلول (3/842). ([91]) الترمذي في السنن برقم (2869) , وابن حبان في صحيحه برقم (7226) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، برقم (2286).
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
|
#20
|
||||
|
||||
|
تنزيل البحث بصيغة وورد
http://www.4shared.com/office/rmPPXA...___-____.html?
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
 |
| أدوات الموضوع | |
|
|
 المواضيع المتشابهه للموضوع: الضوابط الشرعية في الدفاع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- للشيخ فتحي الموصلي
المواضيع المتشابهه للموضوع: الضوابط الشرعية في الدفاع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- للشيخ فتحي الموصلي
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
| لا حول ولا قوة إلا بالله(فوائد وثمار | معاوية فهمي | موضوعات عامة | 1 | 2021-05-30 08:25 AM |