
 |
| جديد المواضيع |

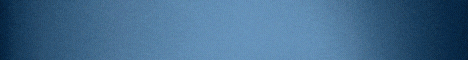
| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
السنة وحي ... تعقيب على تعقيب د.الشريف حاتم بن عارف العوني تنبيه: سبق وأن نشر تعقيباً لفضيلة الـــدكتور/ سعـد الـدين العـثماني بعنوان "هل السنة كلها وحي " والذي ناقش من خلاله بعض القضايا الواردة في بحث الشيخ الدكتور/ الشريف حاتم العوني "السنة وحي من رب العالمين في أمور الدنيا والدين". واليوم نضع بين أيدي الزوار الكرام تعقيباً للدكتور الشريف حاتم العوني على تعقيب الدكتور العثماني. سائلين المولى - عز وجل - أن ينفع بالشيخين وبما يكتبانه وأن يجعل كل ذلك خالصاً لوجهه - عز وجل -. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه وذريته المكرمين، أما بعد: فقد قرأت تعقيبًا للدكتور سعد الدين العثماني بعنوان (هل السنة كلّها وحي)، وهو تعقيبٌ له على مقالٍ لي بعنوان (السنة وحي من رب العالمين في أمور الدنيا والدين). وقد حاولت الإجابة عن تساؤل الدكتور (وفقه الله)، وحاولت إعادة توضيح ما كنتُ قد ذكرته في مقالي السابق عن هذه المسألة، إثراءً للمسألة علميًّا، وإحياءً لمنهج الجدل العلمي، الذي سبق الدكتور إليه (وفقه الله). وأبدأ بأوّل عنوان وضعه الدكتور العثماني، عندما قال عن موضوع النقاش حسب رأيه-: ((موضوع قديم متجدّد))، فإني أسأله السؤال التالي: ما هو الموضوع القديم الذي يتجدّد؟ فما ذكره الدكتور العثماني في فاتحة مقاله، من نقل عن الخطيب والشافعي وغيرهما، ليس هو موضوع النقاش أصلاً. لأنها نُقُولٌ يُريُد أن يُثبت فيها أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحيٌ. وهذا ليس هو محلّ الخلاف؛ لأني ذكرتُهُ في مقالي بتفصيل واضح، وممّا قلتُه في مقالي: "إن وقوع الاجتهاد من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مسألةٌ خلافيّةٌ بين العلماء.. (إلى أن قلتُ) ومنهم من جَوّز الاجتهاد في أمور الدين، وهو قول الجمهور…". وهو ما رجّحتُه أيضًا في مقالي، واستدللتُ على وقوعه بآيات العتاب، وبحديث عائشة رضي الله عنها- في عذاب القبر، كما سيراه من قرأ مقالي. فلماذا يصرُّ الدكتور على أن يجعلني مخالفاً له في مسألةٍ نحن فيها متفقان؟ وصريح مقالي لا يترك مجالاً لاعتقاد أننا مختلفان!! إن إثبات الخلاف في هذه المسألة لن يدل على وجود خلافٍ معتبرٍ في وجوب الطاعة المطلقة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - وتصديقه المطلق في أوامره وأخباره، وهذا هو لبّ الموضوع وأساس المسألة. فالموضوع القديم المتجدّد هو وقوع الاجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن وقوع الاجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم - لا يلزم من القول به عدم الإيجاب المطلق بطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أوامره وتصديقه المطلق في أخباره. ولذلك: فهذا الإمام الشافعي، وكما نقل الدكتور كلامه، ومع نقله للاختلاف في اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - يقول بعد ذكر المقالات في ذلك: "وأيّ هذا كان: فقد بيَّنَ اللهُ أنه فرض فيه طاعة رسوله، ولم يجعل لأحدٍ من خلقه عذراً بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله…". [الرسالة: 104]. وكذلك فعل الخطيب البغدادي، كما نقل ذلك عنه الدكتور العثماني، فمع نقل الخطيب للاختلاف في السنن التي ليس فيها نصّ كتاب، لكنه قرّر عند نقل كل قول ما يدل على وجوب الطاعة المطلقة والتصديق المطلق لما صدر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فانظر قول الخطيب حاكياً رأي من جوّز الاجتهاد من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما خصه الله بأن يحكم برأيه؛ لأنه معصوم، وأن معه التوفيق". (الفقيه والمتفقه: 91). وهذا مثل كلام أبي المظفّر السمعاني الذي نقلتُه سابقاً، وسأشير إليه لاحقاً. ولذلك لا نستغرب أن يُنقل الإجماع على وجوب طاعة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في كل مُحْكمٍ غير منسوخ ووجوب تصديقه في كل ما أخبر به؛ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن مقتضيات شهادة (أن محمداً رسول الله). ولذلك قال ابن حزم في مراتب الإجماع: "واتّفقوا أن كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صحَّ أنه كلامه بيقين: فواجبٌ اتّباعه.. واتّفقوا أنه لا يحل ترك ما صحّ من الكتاب والسنة" (175). وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع: "وأجمعوا على التصديق بما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الله - تعالى -، وما ثبت به النقل من سائر سُننه، ووجوب العمل بمحكمه، والإقرار بنصّ بمتشابهه، وردّ كل ما لم نُحط به علمًا بتفسيره إلى الله - تعالى -، مع الإيمان بنصّه". (رقم 129). فما نقل الدكتور فيه الخلاف، وكان فيه خلافٌ حقًّا، قد سبقتُ إلى نقل الخلاف الذي فيه. وما كان فيه إجماعٌ، ومضى سلفُ الأمّة على الإجماع عليه، هو ما استمسكت به، ورفضت الخلافَ الحادثَ فيه، المحجوجَ بالإجماع، المنقوضَ بمخالفة دلائل الكتاب والسنة، ولم يذكر الدكتور ما يدل على وقوع خلافٍ فيه. والذي حاولتُ أن أوجّهه في مقالي، هو بيان المستند الذي جمع سلفَ هذه الأمة وأئمتها عليه: من وجوب الطاعة المطلقة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - ووجوب التصديق المطلق له - صلى الله عليه وسلم -. فلماذا وكيف أجمعوا على ذلك، مع اختلافهم في إمكان اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل مع كون جمهورهم على إمكان اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -؟!! بل كيف نجمع بين نصوص القرآن الكريم الكثيرة الآمرة بالطاعة المطلقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، في أمور الدين والدنيا، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد، والمجتهد في الأصل معرّضٌ للخطأ؟!! هذا هو ما حاولتُ الإجابة عنه، وذكرتُ جوابين لأهل العلم فيه. كان الجواب الأول الذي ذكرتُه: أنه - صلى الله عليه وسلم - معصومٌ في اجتهاده من الخطأ، وهو ما نقلتُ فيه كلام أبي المظفّر السمعاني. والجواب الثاني، وهو الذي ارتضيتُه: أنه غير معصوم في اجتهاده، حتى في أمور الدين، لكنه لا يُقَرُّ على الخطأ فيه. وبأحد هذين الجوابين استطعنا أن نفهم: كيف نؤمر بمطلق الطاعة وبمطلق التصديق، والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - بشر، ويجتهد، فقد يخطئ. فجاء هذان الجوابان ليبيّنا أنه إنّما صحّ ذاك الإطلاق بالأمر بالطاعة والتصديق للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - لأنه مؤيَّدٌ في بلاغه: إما بالعصمة (وهي هنا: سَلْبُ القدرة على الخطأ)، أو بعدم الإقرار على الخطأ، فيما لو أخطأ. والثاني هو الذي رجّحتُه، وهو الذي استدللتُ لصحّته. وأنت تلحظ في هذين الجوابين أنهما يعودان بالاجتهاد النبوي إلى أنه معبِّرٌ عن مراضي الله - تعالى -في التشريع: إمّا بعصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخطأ في الاجتهاد، أو بعدم إقراره - صلى الله عليه وسلم - على الخطأ، فما أُقر عليه (وهو الغالب) فهو مُقَرٌّ عليه من الله - تعالى -، فالله - تعالى -راضٍ عنه. وما لم يُقر عليه، فقد بلَّّغنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه عن مراضي الله، فكان اجتهادُه - صلى الله عليه وسلم - الأول كالمنسوخ ببلاغه الثاني لتصويب الله - تعالى -الذي جاء كالناسخ له. ولم يقل أحدٌ من أهل العلم، لا من السلف ولا من الخلف: إن ما لم يُقرَّ عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى وفاته مشروعٌ يجوز العمل به، وكيف يقول هذا أحدٌ وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يُقرَّ عليه من ربّه - عز وجل -. فهذا الصِّنف من اجتهاداته - صلى الله عليه وسلم - خارجُ محلِّ النقاش أصلاً، ولا ينازع فيه أحد. وأمّا ما سواه: فقد أفادنا الجوابان السابقان أنّ الاجتهاد النبوي فيه معّبرٌ عن مراضي الله - عز وجل -، في التشريع، وبالتالي فهو وَحْيٌ، لكنه وَحْيٌ مآلاً، كما أطلقتُ عليه ذلك في مقالي السابق، وكرّرتُه، ولم يقف الدكتور العثماني عنده. وَوَصْفُهُ بأنه وحي مآلاً هو التعبير الصحيح لهذه الحالة للسنّة، التي نعترف بأنها ليست وحيًا بالابتداء، لكنّها بلاغٌ عن مراضي الله - تعالى -في الانتهاء، وما الوحي إلا التبليغ لمراضي الله بواسطة رسوله. فالبلاغُ عن مراضي الله بواسطة المَلَكِ ابتداءً وحيٌ، والبلاغ عن مراضي الله - تعالى - بواسطة رِضَى الله - تعالى -المُسْتَدَلِّ عليه بالإقرار وحيٌ انتهاءً. وما دام مقصودُ الوحي تبليغَ مراضي الله - تعالى -، فلا فرق بين أن يكون العلم بالرضى الإلهي قبل البلاغ أو بعده، للمأذون له بهذا البلاغ عن الله - تعالى -، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإن لم يوافقني الدكتور (وفقه الله) أو غيره على تسمية الاجتهاد النبويّ المقَرِّ عليه من الله - عز وجل - وحيًا مآلاً، ورفضوا هذه التسمية، مع استدلالي لها بما لم أقرأ ما ينقضه حتى الآن فليست هذه التسمية هي محلّ النقاش. وإنّما محلّ النقاش: هل نحن مُلزَمون بمطلق الطاعة لأوامر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وهل نحن ملزمون بمطلق التصديق لأخباره - صلى الله عليه وسلم -؟ أم أننا لسنا ملزَمين بذلك؟ هذا الإلزام هو محلّ النّقاش، وهو ما أنفي وجودَ خلافٍ معتبر فيه؛ لأنه مخالفٌ للإجماع ولقطعيّات الكتاب والسنة. وما الأقوال التي نقلها الدكتور العثماني إلا من جنس ما ذكرتُه في مقالي، فهي في إثبات اجتهاد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ومن الأقوال التي نقلها الدكتور ما تؤيد الإجماعَ الذي أتيقّنُه، ككلام الإمام الشافعي وكلام الخطيب اللذين سبقا. وكما فعل الدكتور في مسألة اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما عرضها وكأنها محلّ خلاف بيننا، عرضَ مسألة أخرى كذلك، وهي محلّ اتّفاق أيضاً (والحمد لله). وهي مسألة: حوادث العين التي لا عموم لها، وهي لذلك ليست بلاغاً عامًّا للأمّة، كالفصل بين الخصوم في القضاء، وتدابير الحروب، والسياسة الشرعية في حالةٍ خاصّة. فقد ذكر الدكتور هذه الأمور، ونصوص العلماء على أنها لا يلزم أن تكون بوحي. ولا أدري ألم يقرأ الدكتور العثماني قولي بالحرف الواحد: "وهذه الأحكام الخاصة التي لا عموم فيها (كحكمه - صلى الله عليه وسلم - على سبيل القضاء والإمامة والسياسة) هي التي ربما عبّر عنها العلماء بأمور الدنيا، التي لا يلزم أن تكون بوحي، بل التي قد يحكم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيها بحكم، ولا يُصوَّب، ويكون مخالفاً للواقع؛ لأن الخطأ في هذه الأمور لا يؤدّي إلى خطأ في التصوُّر للأمّة كلّها إلى قيام الساعة، ولا يفهمُ الناس منه أنه حكمٌ يتعدَّى إلى غير من حُكِم له أو عليه، ولا يَؤُول إلى خللٍ في بلاغ الدين". إذن فأنا أقرّر أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قد يجتهد في هذه الأمور، بل إني لأقرر أيضاً أنه قد يخطئ في اجتهاده، بل أضيف إلى أنه قد لا يُصوَّبُ خطأه في هذه الحالة؛ لأنه في حُكمه على زيدٍ من الناس بأن عليه حقًّا لعَمرو، أو أن الرّماة يوم أحد يقفون على جبلهم، لن يفهم الناس من ذلك أن هذا هو حكم زيد من الناس مطلقا، ولا أنّ المعارك لا تصح إلا بأن يقف الرماة على جبل الرماة!! هذا لا قائل به من العقلاء، ولا بلغ الفَهْمُ البشري إلى هذا الحدّ من التدنيّ، لذلك لو أخطأ النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذه الأمور ولو لم يصوَّب هذا الخطأ لا يكون في ذلك خطر على صحّة تبليغ الشريعة، ولا يؤدّي ذلك الخطأ لو وقع- إلى تحريف معالم الدين؛ ولذلك لم يكن هناك ضرورة مطلقةٌ إلى تصويب مثله. وهذا بخلاف الخبر الجازم من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، الذي يفهم المخاطَبون به أنه حقٌّ وصِدْق، وهو بخلاف ذلك، فيما لو أُقر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه على الخطأ. فإنه يؤدّي إلى تحريف الحقيقة، وتشويه الدين.. لقد كنتُ قد ذكرتُ في هذا السياق حديثَ أمِّ سلمة رضي الله عنها-، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إنكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون أَلْحَن بحجّته، من بعض، فأقضي له على نحوٍ ممّا أسمع منه. فمن قطعتُ له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعةً من النار". وذكرتُ أنه دليلٌ على أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد يجتهد في حوادث الأعيان التي لا عموم لها، ويخطئ، ولا يصوّبُ الوحيُ خطأه. فلماذا يُعيدُ الدكتور كلامي واستدلالي، وكأنه يخالفني في هذا المعنى، اللهم إلا إن كان الدكتور (وفقه الله) يريد أن يُساوي بين أمور الدنيا التي لا عموم لها (كهذه الحوادث العينيّة) والأمور العامّة والأخبار المطلقة، بحجّة أن الجميع من أمور الدنيا. وعندها يكون قد ساوَى بين غير المتساويين، ولزمه أن يعطينا الفارق الواضح بين ما يُحتجُّ به من السنّة في أمور الدنيا وما لا يحتج به؛ إذ إنّ اطّراد هذا القول حينها سيكون هو ردَّ السنّة في أمور الدنيا كلّها، وأنها لا تُقبل إلا في العقائد والعبادات المحضة؛ كما سبق وبيّنتُه في مقالي السابق. والدكتور (وفقه الله) كاد أن يعترف بأنه لا فارق واضحاً لديه لأمور الدنيا التي تلزم فيها طاعةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - والتي لا تلزم فيها الطاعة، وأنه لم يصل لوضع ضابط صحيح لذلك. فهو عندما أورد رأي شهاب الدين القرافي في التمييز، وأنه: ما كان لمصلحة الآخرة وما كان لمصلحة الدنيا، وأثنى على هذا التمييز، عاد وقال: "لكنها تحتاج إلى مزيد دراسة وتعميق". وهو إنما أعلن حاجته إلى ذلك؛ لأنه قد علم أن ما ذكره القرافي ليس ضابطاً للتمييز، فبهذا التعبير الذي نقله عنه يمكنني أن أُخرج نُصوصَ المعاملات، ولا يفيدني ذلك الوصفُ ما يمنع من هذه النظرة الكنسيّة (حسب تعبير الدكتور). وأمّا قول الدكتور: "وهكذا يتبيّن أن المقصود من التصرفات النبويّة الدنيويّة ليس هو ممّا يبلّغه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله من أخبار أو أحكام، فهذه هو فيها صادق أمين، معصوم عمّا يطالها من خُلْف أو خلل، ولو كانت متعلقة بأمور المعاملات بين الناس"، فليس فيه بيان ضابط التفريق بين أمور الدنيا التي يبلّغها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله - تعالى -، وأمور الدنيا التي ليست بلاغاً عن الله - تعالى -. وما الذي جعل أمور المعاملات عن الله - تعالى -، دون أمور الطب مثلاً؟! لقد كنتُ في مقالي السابق قد ذكرتُ ضابطًا لا يُحرج الذي ما زال يحتجّ بالسنة في غير العبادات والعقائد، كالمعاملات المالية وغيرها من أمور الدنيا؛ لأنه ضابطٌ حدَّدَ أمور الدنيا بحوادث الأعيان التي لا عموم لها. أمّا من احتجّ بالسنة في أمور المعاملات وهي من مصالح الدنيا، وردّها في الطب مثلاً، فقد تناقض؛ وإلا فيلزمه أن يبيّن لي كيف عرف أن الأولى بلاغٌ عن الله - تعالى -دون الثانية! ومن دلائل بطلان القول (أيّ قول) فسادُ لوازمه؛ ومن وسائل إثبات عدم صحّة رأي طَرْدُه لتتضح نتائجه الخطيرة، وهذا ما حرصتُ على بيانه في مقالي السابق، ولم يقف الدكتور عند ذلك، ولا مَرّ به في تعقيبه، ولا مرور الكرام على اللغو. وبهذا نكون قد انتهينا من أهمّ مسألتين في تعقيب الدكتور العثماني وفقه الله، وبقي التعليق على بعض ما أرى أنه يحسن التعليق عليه: أولاً: ذكر الدكتور العثماني فيما ذكر مما يستدل به على أن من السنة ما ليس بوحي (ابتداءً): الأفعال التي يفعلها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمقتضى الجبّلة البشرية، ونقل ما يستدل به على أنها ليست وحيًا. وهذا مما لا أخالف فيه، لكني أسأل الدكتور: ألا يستدلّ العلماء كلُّهم على إباحة تلك الأفعال التي كان يفعلها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على وجه البشرية؟ هل كان أحدٌ منهم يقول أو يعتقد: أن هذه الأفعال يُمكن أن تكون محرّمة مع كون النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلها؟!! إذن فإقرار الله - تعالى -لتلك الأفعال الجبليّة من النبي - صلى الله عليه وسلم - يجعل أقل ما يُستفاد منها الإباحة، والإباحة تشريع. كما أن الإقرار الإلهي لنبيّه - صلى الله عليه وسلم - وَجْهٌ من وجوه الوحي، كما قدّمناه. ولذلك نزلت تشريعاتٌ وقيود في بعض الأمور العاديّة البشرية: في الأكل والشرب واللباس.. وغيرها، ولا تردَّدَ أحدٌ من أهل العلم في الاحتجاج بها. وبذلك يتّضح أن قولي بأنّ السنة كلّها وحي حالاً أو مآلاً، يتناول أيضًا الأفعال التي كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يفعلها على وجه الجبلّة والعادة؛ لأنّها مع الإقرار الإلهي تدل على الإباحة في أقل الأحوال. وهنا أنبّه إلى وَهَمٍ قد ينقدح في بعض الأذهان، وهو أن القول بوجوب الطاعة المطلقة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، لا يعني أن كل ما صدر من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقتضي الوجوب، ولا يقول هذا أحد. وإنما المقصود وجوب الامتثال لما دلّت عليه السنة، سواء أكانت قوليّة أو فعليّة أو تقريريّة، فقد تدل على الوجوب أو التحريم، وقد تدل على الاستحباب أو الكراهة، وقد تدل على الإباحة. فالواجب امتثال دلالة السنة مطلقاً، دون استثناء؛ إلا ما لا حاجة إلى استثنائه، لوضوحه، وهو ما كنت قد بيّنتُه آنفاً وفي مقالي السابق. ثانياً: إذا كان الدكتور يحتج باجتهاد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدنيا، وبالخطأ الذي قد يتعرّضُ له هذا الاجتهاد، على أن هذا النوع من السنة في أمور الدنيا لا تجب طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ولا تصديقه عليه؛ لأنه قد يكون خطأ. فيلزمه أن يقول ذلك تمامًا في أمور الدين، بل في أجل أمور الدين، وهي الأمور الغيبيّة من العقائد!! لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اجتهد فيها، وقد أخطأ أيضًا!!! فقد ذكرتُ في مقالي السابق حديث عائشة رضي الله عنها- في عذاب القبر، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، وبيّنتُ هذا الإلزام. فلا أجاب الدكتور عن هذا الإلزام، ولا أشار إليه. والجواب عن خطأ النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه المسألة العقديه، سيكون هو الجواب نفسه عن أمور الدنيا. وهو أن التصويب الإلهي قد حفظ السنة الموحَى بها (إبتداءً أو مآلا) من التهاتر والتعارض، وبيّن هذا التصويبُ أن القول الأول كان خطأً ليس من السنة التي هي وحيٌ: ابتداءً، أو مآلاً بالإقرار، بل هو اجتهادٌ محضٌ من النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَقره الله عليه، فخرج عن سنةِ الوحي تمامًا. ثالثاً: احتجّ الدكتور على رأيه بحديث تأبير النخل، مع أني كنتُ قد فصّلتُ الردّ على الاحتجاج به، وبيّنت الصواب فيه. واحتجّ أيضًا بحديث أبي قتادة الأنصاري، عندما كانوا في سفر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فناموا عن صلاة الفجر، حتى طلعت الشمس، فقال بعضهم لبعض: فرّطنا في صلاتنا! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تقولون؟! إن كان أمر دنياكم فشأنكم، وإن كان أمر دينكم فإليّ"، قالوا: يا رسول الله، فرّطنا في صلاتنا!، فقال: "لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة.... " أخرجه أحمد رقم (22546). وهذا الحديث جاء في الاجتهاد من الصحابة في أمر الدين بمحضر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا كالاجتهاد في مورد النصّ؛ ولذلك قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لهم هذا القول. ومعنى الحديث حينها: أمور الدنيا التي لا نصّ فيها فلكم الاجتهاد فيها، أما ما كان فيه نصّ فلا اجتهاد في مورد النصّ. ولا علاقة لهذا الحديث بتقسيم السنة إلى: سنة في أمور الدنيا، وسنة في أمور الدين؛ لأن من أمور الدنيا ما وردت فيه سنةُ وحي، كما يوافق الدكتور العثماني عليه في المعاملات، وعندها ستكون هذه الأمور الدنيوية التي وردت فيها السنة (بورودها فيه) من أمور الدين؛ لأنها أصبحت تشريعًا وحكمًا إلهيًّا. فالقسمة لا يصح أن تكون بناءً على الدنيا والدين، بمعنى فصل الدين عن الحياة، هذا التقسيم باطلٌ من أساسه، كما ذهب إليه الدكتور نفسه. وإنما جاء الحديث ليبيّن للصحابة: متى يحق لهم الاجتهاد بمحضر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ومتى لا يحق لهم ذلك. فما كان فيه نصٌ فهو دينٌ بورود النصّ فيه، وما يتعلق بالحلال والحرام فهو دينٌ أيضاً، كالنوم عن الصلاة وترتّب الإثم عليه وعدم ترتبه عليه؛ فهذا لا حاجة للاجتهاد فيه مع وجود المبلِّغ عن الله - تعالى -وحضوره بين أيديهم، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وما لم يكن فيه نصٌّ من أمور الدنيا والمعاش، فهذا ما يجوز للصحابة أن يجتهدوا فيه، ولو بمحضره - صلى الله عليه وسلم -. كما احتجّ الدكتور بحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف في النخل بالمدينة، فجعل الناس يقولون: فيها صاع، فيها وَسَق، يَحْزِرون، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "فيها كذا وكذا"، فقالوا: صدق الله ورسوله. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس، إنما أنا بشر: فما حدثتكم به من عند الله، فهو حق، وما قلت فيه من قِبَل نفسي، فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب". أخرجه البزار في مسنده رقم (4726، 5033)، وأبو الشيخ في طبقات الإصبهانيين (1/425-426 رقم 76)، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (1/304-305). وهو من طريق حسين بن حفص بن الفضل الأصبهاني، عن خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة، عن أبيه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. وقال البزار عقبه: "لا نعلمه رواه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد". قلت: وهذا الانفراد من قبل هؤلاء الرواة ممّا يضعف الاعتماد عليه، وخاصة خطاب بن جعفر، فإنه وإن رضينا بقبوله، فهو ليس محلّ الاعتماد على انفراده. وأبوه في روايته عن سعيد بن جبير ضعف، كما قال ذلك عثمان بن سعيد الدارمي في ردّه على الجهميّة (45رقم 15)، ونقله عنه الحافظ في التهذيب (2/108). وليس هذا الضعف هو ما يهمّني، فإن الحديث لو صَحّ فإنه بمعنى حديث تأبير النخل، والجواب عنه هو الجواب الذي كنتُ قد ذكرتُه عنه. ويلزم من فَهْمه الفهم الذي أردُّه لوازمُ فاسدة، كما سبق، تدل على عدم صحّة ذلك الفهم. فقصّة الحديث تبيّن أن عدداً من الصحابة كانوا يَحْزِرون (أي يخمّنون) مقدار ما يجب من الزكاة من نَخْل كان مثمراً حينها، وشاركهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الكلام بالحَدْس والظنّ، لكنهَّم فهموا أنه خبر، فقطعوا حَدْسَهم مُحيلين ذلك إلى ما حسبوه يقينًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: "صدق الله ورسوله"، فعاجل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تصحيح ما فهموه، وأنه تكلَّم بحدسه دون وحي، وَحَدسُه وظنُّه لا يوجب التسليم المطلق في أمور الدنيا التي ربما كان في الناس من هو أكبر خبرةً منه بها. ولا ندري هل كان لفظ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - دالاًّ على الظنّ حين تكلَّم؟ كما وقع ذلك في حديث تأبير النخل، فنقله بعض الرواة دون بعض بالتصريح بلفظ الظن، كما بيّنتُه في مقالي السابق. أم أنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بقرينة الحال، وهي أن الحديث كان دائراً بالحدس والظن بينهم، فلمّا ظنّوه يقينًا لا يكون إلا بالوحي، بادر - صلى الله عليه وسلم - إلى تصحيح هذا الخطأ منهم: حينما لم يراعوا قرينة الحال الدالة على أن الكلام بظن، وحينما فهموا أن هذا الخبر منه - صلى الله عليه وسلم - خبرٌ عن الله - تعالى -لا يجوز عليه إلا التسليم الكامل. وكما قلنا في حديث تأبير النخل: فَهْمُ جيل الصحابة لكلام النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه وَحْيٌ، وفي قصص متعدّدة، يدل أن هذا هو الحق الذي كان مستقرًّا عندهم، وأنهم لا يخرجون عن هذا الأصل لمجرّد أنه - صلى الله عليه وسلم - تكلّم في أمور الدنيا، وإنما يخرجون عنه إذا تيقنوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ليس وحيًا: إما بالنصّ الواضح كما هنا، أو بابتدائه أنه - صلى الله عليه وسلم - يظن ولا يوقن، كما كنتُ قد بيّنتُه في مقالي السابق. ولا يتم تصوّر الجواب التصور الكامل عن هذا الحديث، إلا بإدراك الفهم الآخر، وما يستلزمه من لوازم فاسدة، وما يقدح فيه من ثغرات لم يُجب عنها الدكتور العثاني (وفقه الله). وإن كان فيما سبق كفاية، من الكلام عن ضعفه، إلى آخر الجواب. رابعاً: عمد الدكتور العثماني إلى آية واحدة مما ذكرت فردّ على استدلالي بها، وهي آية النجم "وما ينطق عن الهوى" وعمد إلى حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص، فرّدّه أيضًا. والواقع أن دليلي على ما ذهبت إليه لم يكن آيةً واحدةً أو آيتين، ولا حديثاً واحداً أو حديثين، بل العديد من النصوص التي ذكرتُ بعضها وأحلتُ إلى بعضها الآخر وأشرتُ إلى غيرها. فليس في الردّ على ذينك الدليلين ما يكفي لتمام الردّ، ولا يتوهَّمُ أحدٌ أن هذا كفيل بنقض ما احتججتُ به. هذا.. مع أني كنتُ قد أشرتُ إلى الجواب عن الاعتراض الذي ذكره الدكتور العثماني على استدلالي بآية سورة النجم، حيث أحلتُ عند الكلام عليها إلى كتاب (الإجماع في التفسير) للخضيري، وهي إحالةٌ غريبةٌ لعنوانٍ يستدعي البحث ويسترعي الانتباه إليه. حيث إن صاحب هذا الكتاب قد ناقش الفهم الذي ذهب إليه الدكتور العثماني، وردَّ عليه، وردّ على دعوى الإجماع الذي نقله ابن عطيّة في تفسيرها، ولذلك أحلت إليه، عسى أن يستوفي الردّ عليه من أراد أن يخالفه. وأمّا حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما- فقد أبنت عن معناه بمالا يتعارض مع حديث تأبير النخل، وبما يتأيّد بقطعيّات الكتاب والسنة، وبالإجماع. وذلك من خلال بيان المقصود بالحق الذي ورد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما خرج منه إلا حق"، وأنه الوحي ابتداءً أو الاجتهاد المؤيّد بالإقرار الإلهي، فلا يبقى بعد ذلك مجال لردّه بحجّة معارضته للمتواتر؛ لأنه موافق غير معارض، وهو حديث صحيح السند والمتن، صحيح المعنى. وأخيراً: لا يخفى على الدكتور المنهج العلمي في تناول المسائل العلميّة، فهو خريج هذا المنهج وأستاذه الآن. ومن أصول المنهج العلمي عند تحرير مسائله، أن يتناول الباحث القول الذي يعارضه فيردّ على أدلّته جمعيها؛ لأن بقاء دليل واحد كافٍ لإثبات دعوى مخالفه، ثم على الباحث أن يذكر رأيه وأدلّته (غير المنقوضة) عليه. والدكتور (وفقه الله) لم يفعل ذلك، كما هو واضح من مقاله. مع أني كنت لخّصتُ أهم أدلتي في آخر المقال، وحاولت إبرازَها بوضوح. ومع أني رددت على حديث تأبير النخل، فعاد واحتجّ به دون أن يردّ على المعنى الذي ذكرته. ومع أني نقلتُ كلاماً لبعض العلماء يدل على رأيي، فنقل عنهم هو ما يعدّه دالاً على رأيه، دون أن يحلّ إشكال هذا التناقض... فلكي نصل إلى الحق الذي هو بُغْيتنا جميعاً، أرجو أن يكون نقاشُنا علميًّا، فالنقاش العلمي، وإن لم يُغَيّر آراء المتجادلين، لكنه مثمر، ويعين المحايدين على استجلاء الحقيقة والوصول إليها. والدكتور العثماني أدرى بذلك كله، وأعتذر إليه عن أي لفظ بدر مني (دون قصد) قد يجد عليّ فيه. فإني أُحيل إلى علمٍ وعقلٍ، وأكله إلى حبّه لخدمة دينه. والله يوفقنا وإيّاه، ويجعل أعمالنا خالصةً في رضاه. والله أعلم. والحمد لله ذي الجلال، والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه والآل. 18/11/1427 |
 |
| أدوات الموضوع | |
|
|