
 |
| جديد المواضيع |

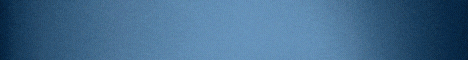
| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
التفكير بالنص الفكري
(دراسة أكاديمية) أما النص الفكري فإن المعارف العقلية هي الأساس في بنائه. والعناية فيه ليست موجهة للألفاظ والتراكيب، أي أنها ليست كالعناية بالنص الأدبي، لأن معنى النص الفكري هو الذي توجه إليه العناية أولا، ثم إلى المعاني ثانيا. وهو ـ أي النص الفكري ـ كما قيل وهو قول حق لغة العقل لا لغة العاطفة، لأن الغرض منه تأدية الأفكار وتأدية الحقائق بقصد خدمة المعارف، وبقصد إثارة العقول، ثم إن تراكيبه وألفاظه أو كلماته يجب أن تتميز بالتحديد والدقة والاستقصاء، وهو لا يقوم على العواطف، بل على العقل من حيث نشر الأفكار والحقائق، ومن حيث خدمة المعارف الإنسانية من جهة نشرها بعد بذل جهد من أجل الوصول إليها، وتحتاج إلى عمق واستنارة، ومن هنا كان النص الفكري مخالفا مخالفة تامة للنص الأدبي، لأن هذا الأخير لا يقف عند الحقائق والمعارف، وقد علمنا أنه ـ أي النص الأدبي ـ لا يغذي العقل بالأفكار، وإنما يحاول تقريبها وتقريب الحقائق إلى الأذهان، وفي هذه المحاولة يخالطه الاختيار من حيث اصطفاء أبرز الأفكار أو الحقائق وأهمها، أي أنه يختار ما يمكن رؤيته جميلا جمالا ظاهرا أو خفيا، وما كان موجدا للتأثير والانفعال، وما الألفاظ والتراكيب فيه إلا لتأدية الأفكار على الوجه الذي يصل به الأديب إلى إثارة قارئه أو سامعه ليهز بذلك مشاعره، ويحاول بعث ما يقتضيه هذا الإنفعال من سخط وغضب، أو رضا وغبطة. هذا هو وجه الإختلاف بين النص الأدبي والنص الفكري. فهذا الأخير يقصد به تغذية العقل بالأفكار والوقوف عند حد المعرفة والحقيقة، ولا يبالي بالمشاعر، أي أن النص الفكري لا يحرص فيه على اختيار ما يهز المشاعر، كما أنه لا يحرص فيه على ما لا يهزها، لأن هذا ليس من إختصاصه. فخصوصيته تأدية الأفكار والحقائق من جهة مخاطبة العقل بصرف النظر عن الجانب العاطفي. وصاحبه يتقصد إجتلاء الأفكار ولا يتقصد تقريبها. وهو يتقصد حسن إبراز الفكرة الحقيقية ولا يتقصد البحث عما فيها من جمال. ويتقصد ما يمكن الوصول به إلى إقناع العقل مع دقة الأداء، ولا يتقصد الحرص على الوصول إلى ما يمكن به إثارة قارئه أو سامعه من حيث إسخاطه أو إرضائه, إدخال السرور على قلبه أو الغضب، وإنما عنايته موجهة إلى أداء الفكر كما هو بجعله صور الفكر واضحة غير مبهمة حتى ولو غمضت صور التركيب؛ لأنه لا يهتم بها. ومن هنا كان فهم النص الفكري يخالف فهم النص الأدبي مخالفة تامة. والتفكير في النص الفكري معناه فهمه. وفهمه لا يتأتى للحريص على الفهم إلا بواسطة كسبه للمعلومات السابقة عن موضوع النص. وهو بهذه المعلومات السابقة الموجودة لديه يستطيع الفهم وبدونها لا يستطيعه. وسبب ذلك يرجع إلى واقع النص الفكري، فهو ليس كالنص الأدبي. فالنص الفكري يضعه المفكر ليعبر عن واقع معين. والواقع لا يفهم من قبل الذي يقع حسه عليه دون وجود معلومات سابقة يفسر بها الواقع. فأنت مثلا أيها القارئ الكريم إذا حصل ولم تكتسب معلومات سابقة لغوية عن العربية، فإنك لا تستطيع تفسير الواقع الذي تدل عليه. وأنت في هذه الحالة يجب أن لا تخرج مطلقا عن اصطلاح العرب. لأن اللغة العربية إصطلاح اصطلح عليه العرب. وهم في ذلك وضعوا ألفاظا للدلالة على معاني معينة. فحين وضعوا لفظ ـ القرء ـ فإنما وضعوه للدلالة على الحيض والطهر. وحين وضعوا لفظ ـ الجون ـ فإنما وضعوه للدلالة على الأبيض والأسود... فحين تقرأ هذا النص مثلا: ارتفعت درجة حرارة سليم حين صيرته أفعى سليما. فإنك لا تملك غير تفسيره باللدغ لأنه هو الذي صير ـ سليم ـ ملدوغا. ومعناه أن الأفعى لدغت المسمى ـ سليم ـ حتى صار بسبب ذلك ملدوغا يعاني من ارتفاع درجة حرارة جسمه. وفهم هذا النص تأتى بكلمة ـ سليم ـ التي وضعت في آخر النص ـ سليما ـ للتمييز، ولكن الكلمة وإن كانت قد وضعت للتمييز، فإنها مع ذلك لا تكفي للفهم إلا إذا أدرك مدلولها، أي أنه لابد للمرء من معلومات سابقة عن واقع الإصطلاح. فالعرب وضعوا كلمة ـ سليم ـ للدلالة على الملدوغ والسليم، ولولا ذلك لكان النص مبهما، لأن السليم إذا كانت تعني السليم فحسب؛ وجب حذفها من النص وإقامة لفظ الملدوغ بدلا عنها، ولكن بما أنها تعني الملدوغ وتعني السليم في نفس الوقت كان النص واضحا غير مبهم، وكان دالا على واقع معين، وكانت المعلومات السابقة المتعلقة بالوضع هي السبب في تفسيره. وإذا أردنا أخذ امرئ لا يعرف عن لفظ ـ سليم ـ إلا السليم، أي أنه ليست لديه معرفة سابقة عن دلالتها الأخرى وهي ـ الملدوغ ـ وطلبنا منه قراءة النص وتفسيره فإنه سوف يذهب بنا إلى القول بأن النص مبهم؛ لأن ارتفاع درجة الحرارة في جسم إنسان ما يحتّم غير السلامة، فيكون المصاب بها غير سليم، فكان لابد من إستبدال الكلمة بكلمة أخرى حتى يتضح المعنى ويفهم النص، ولكنه بمجرد إدراكه لمعنى اللدغ أثناء تلقيه للمعرفة السابقة عن الوضع أو بعدها كما هو الشأن في لفظ ـ الجون ـ الذي يعني الأبيض والأسود، أو القرء الذي يعني الطهر والحيض، فإنه سوف يتراجع في حكمه وتفسيره السابق، ويقر بصحة التركيب مع فهم الواقع فهما مخالفا تماما لسابقه مادام لفظ ـ السليم ـ يعني السليم والملدوغ وهكذا. وأما الأسلوب الفكري فإنه يتطلب وجود معلومات سابقة حتى يتأتى فهمه، وذلك من جهة مدلولاتها التي يجب أن تكون مدركة. وهذه المعلومات إن كانت معروفة لدى المرء مجرد معرفة دون إدراك مدلولها الواقعي، أي دون أن يكون مدلولها مدركا واقعه، فإن هذا لا يؤدي إلى فهم النصوص الفكرية، لأن النصوص الفكرية تعبر عن الأفكار، وهذه الأفكار لها مدلول معين، ولها واقع معين أيضا، ولبست مجرد أفكار. فإن حصل وفُهمت الأفكار فهما لما تدل عليه دون إدراك لواقعها، ودون رؤية لمدلولاتها، فإنها لا تكون معارف سابقة يمكن بواسطتها تفسير الواقع، وإنما تكون مجرد معارف، ثم إنها لا تنفع في التفكير، وبالتالي لا تنفع في الفهم للنصوص الفكرية؛ لأن شرط التفكير في النصوص الفكرية ليس وجود معارف سابقة فقط، وإنما يضاف إليها الإدراك لواقعها، والتصور الحقيقي لمدلولاتها. فأنت حين تقرأ كتابا فكريا سواء كان متناولا بحثا فكريا، أو بحثا في موضوع ما، أو مسألة ما، أو غير ذلك، وكان الكتاب مكتوبا باللغة العربية، فإنه من البداهة أن تكون نصوصه عربية، وألفاظه عربية، وتراكيبه عربية وأنت في كل الأحوال عالم بالعربية، ولكن علمك هذا وإن ساعدك على فهم معاني الألفاظ والتراكيب، ولكنه بالتأكيد لا يساعدك على فهم مدلول الفكر الذي صيغ بهذه الألفاظ والتراكيب، فكان السبيل من أجل فهم هذا الفكر هو وجود معلومات عنه، ووجود إدراك لواقعه وتصور لمدلوله، وإلا كان فهمك للكلام فهما لغويا، وربما كان مطابقا لما دل عليه الفكر، وربما كان معاكسا له، وأخيرا تكون النتيجة أنك لم تفهم الفكر، وإنما فهمت اللغة، فكان فهمك لغويا، وكان هذا ليس هو المطلوب منك أثناء وقوع حسك على النصوص الفكرية. فمثلا حين تقرأ هذا النص: ((لفظة الفلسفة لا تعني عندنا ما تعنيه عند اليونان، ولا عند من يراها خاصة بالميتافيزيقيا، وإنما نعني بها مزج المادة بالروح، أي مزج أعمال الإنسان بأوامر الله ونواهيه. والتفكير من الأعمال الذهنية، وما دام كذلك، فإنه لا يصح أن يأخذ كل شيء، لأنه لو أخذ كل شيء وباشره بالعلاج، فإنه لن يصل، لأن التفكير لا يمكنه أن يتناول كل شيء، لأن من الأشياء مالا يقع عليها حس الإنسان، والتفكير لا يخرج عن نطاق ما يحس. ولذلك فالتفكير حين يمزح بالفلسفة الإسلامية يسلم من الشطط، ويسلم من الوقوع في الغث وإنتاج الترهات)). وهو من النصوص الفكرية. وهذا النص لا يكفي فيه أن تفهم معناه في اللغة العربية حتى تصل إلى فهمه. ولا يكفي الوقوف فيه على ألفاظه وتراكيبه حتى الوقوف على معانيه. فلا يكفي إدراك أن الفلسفة تعني حب الحكمة، وهي ليست معنية في هذا النص. ولا يكفي إدراك أنها تعني الميتافيزيقيا، وهي ليست معنية في هذا النص. بل لا يكفي إدراك أن معناها هو مزج الأعمال بأوامر الله ونواهيه بما فيها عمل العقل مادام عملا ذهنيا أو قلبيا إلى جانب أعمال الجوارح. ولا يكفي إدراك قصور التفكير عن الوصول في تناوله كل شيء. ولا يكفي إدراك سلامة التفكير بسبب مزجه بالفلسفة الإسلامية، بل لا بد أن يكون التفكير الفلسفي الإسلامي واضحا لديك مغروسا في قناعاتك الصادرة عن قوله تعالى: ((فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)). وقول الرسول الأكرم صلوات الله عليه: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد على صاحبه)). ولا بد أن يكون متصورا مدلوله عندك تصورا لا تخالطه شائبة. ولا بد أن يكون واقع الروح وما يدل عليه مدركا ومتصورا مدلوله عندك بحيث لا يجذبك إلى غيره مفهوم آخر خصوصا إذا أعملت عقلك فيه ووصلت في ذلك إلى بلورته، لأن كلمة الروح من الألفاظ المشتركة. وكل لفظ منها حسب سياق استعماله يدل على معنى غير المعنى الآخر. والأصل في معنى الروح أن المؤمنين بوجود الإله هم الذين يرددون كلمة الروح والروحانية والناحية الروحية، وكلها محصورة في آثار الناحية الغيبية. وأثناء الوقوف عند هذه المعاني يصير الوضع كما لو كان زوبعة رملية، أو ضبابا يحول دون رؤية ما يراد رؤيته فيقع الغموض والإبهام رغم ما لهذه المعاني من واقع في الذهن، وما لها من واقع خارج الذهن وهو المغيّب المدرك وجوده وغير المدرك ذاته، ثم إنه بالذهاب إلى الاصطلاح، وبالذهاب إلى اللغة العربية يتبين أن الروح والروحانية والناحية الروحية ليست كلمات إصطلاحية، وليست كلمات لغوية حتى يمكن الرجوع إلى الاصطلاح أو اللغة من أجل فهمها، وبالذهاب إلى شرح الروح مادامت لفظا مشتركا يتبين أن لها معاني عديدة كالعين المراد بها الجاسوس والذهب والفضة والباصرة والجارية. وقد وردت كلمة الروح بعدة معان. فوردت وأريد بها سر الحياة في قوله تعالى: ((يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)). ووردت وأريد بها الملك الأمين جبريل عليه السلام في قوله تعالى ((نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين)). ووردت وأريد بها الشريعة الإسلامية في قوله تعالى: ((وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا)). فهذه المعاني كلها ليست هي المقصودة في النص الفكري المذكور. وهذه المعاني ذاتها اختلطت على الناس حتى قال قائلهم أن الإنسان مركب من مادة وروح، فإذا غلبت المادة على الروح كان شريرا، وإذا غلبت الروح على المادة كان خيرا، وعليه يتحكم ترجيح وتغليب الروح على المادة حتى يسير الإنسان خيّرا، وكان ممن بالغوا في هذا الفهم السقيم المتصوفة. هذا القول لا يحتاج إلى التفات لأن الإنسان ليس مركبا من مادة وروح، ووجه الغموض كان في عدم تفريقهم بين سر الحياة الموجود حتى لدى الحيوان وبين الناحية الروحية المتعلقة بإيمان المرء بوجود خالق وهو المغيّب عنه. فالملحد مثلا يوجد فيه سر الحياة كالمؤمن تماما، ومع ذلك لا يدرك صلته بالإله لأنه لا يؤمن بوجوده بخلاف المؤمن. فكان الموضوع كله يجب أن يحصر في الإيمان لأنه هو الذي ينتج الشعور بعظمة الخالق، والخشية منه، والتقديس له وعبادته. فالإيمان إذن هو الذي ينتج الروح والروحانية والناحية الروحية أثناء إدراك العقل لوجود الخالق، فكانت الروح المذكورة في النص هي إدراك الإنسان صلته بالله تعالى، وهذا الإدراك يجعله حريصا على الإلتزام بأوامره واجتناب نواهيه، فكان مزج العمل بالأوامر والنواهي، أي مزج المادة بالروح هو الفلسفة الإسلامية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا بد من وضوح الرؤية لواقع التفكير. فالتفكير الذي ثبت في النص أنه قصير عن بلوغ هدفه بتناوله كل شيء يتطلب إدراكا سليما وواقعيا لواقع الفكر أو العقل لأن التفكير من عمله، فالعقل البشري يوجد في ذات محدودة، وعليه فإنه لا يقوى على تناول كل شيء خصوصا غير المحدود. ولا بد من إضافة شيء هام جدا لإدراك النص وفهمه فهما لما يدل عليه، وهو أن العقل لكي يعقل أو يدرك لا بد له من واقع محسوس أو أثر هذا الواقع، لأن الواقع شرط أساسي للعملية العقلية، فبدون واقع لا يوجد إدراك، فنتناول العقل أشياء لا يقع عليها حس الإنسان كذات الله عز وجل والملائكة والجنة والنار وكل ماهو غيبي يوقعه في الزلل، وهو الذي يؤدي إلى إنتاج الترهات، وأولا وأخيرا فإن هذه البحوث تفتقد للواقع الذي لولاه والدماغ والإحساس والمعلومات السابقة لما وجد عقل أو إدراك، فتحتم أن يكون واقع العقل مدركا حتى يتأتى لنا فهم النص، أي لابد من أن تكون المعارف السابقة عن الروح، وعن المقصود بالمادة، وعن كيفية المزج بينهما، وعن العقل متصورا واقعها، ومدركا مدلولها حتى يتيسر لك فهم هذا النص ويتأتى. وإذا لم يحصل ذلك وظلت معارفك معارف مجردة، أو كنت تلاحظ فيها مدلولها كمعان لا كواقع، فإنه بالتأكيد لا يمكنك فهم هذا النص. ومن الطبيعي عند عدم فهمك أن لا تستفيد منه حتى ولو حفظته عن ظهر قلب. فالنص الفكري يشبه البناء. والبناء حين تزول بعض لبناته ولو واحدة منه فسوف لا تبقى صورة البناء كما هي. والنص الفكري شأنه شأن البناء فلا يجوز لك نقل حرف من مكان إلى آخر ولا يجوز لك إستبدال كلمة بأخرى، بل لا بد من المحافظة الكاملة على أدوات النص أو مكوناته كما هي، لأن مدلول الفكر الذي يراد أداؤه، أي الواقع الذي يراد منه واقع معين، وصورة معينة، فحصول شيء من التغيير في واقعه، وفي صورته يجعل الفهم تابعا لهذا التغيير، أي يتغير الفهم بصرف النظر عن التغيير الكلي أو الجزئي فيه. وعليه فإن فهم النص الفكري يقضي بإدراك مدلوله، وهذا الأخير يقضي أيضا بالمحافظة على ألفاظه وتراكيبه، صحيح أن النص الفكري قد يصاغ بنفس الصياغة التي يصاغ بها النص الأدبي. وصحيح أيضا إمكانيته من جراء ذلك على التأثير على المشاعر، هذا ملاحظ في كثير من النصوص الفكرية، ولكن بما أنه يتقصى الحقائق، ويسعى إلى بلورتها، فلن يكون إلا نصا فكريا، وليس نصا أدبيا، لأن شرطه هو الوصول إلى الحقائق بصرف النظر عن تأثيره على المشاعر أو غير ذلك. وإذا حصل وأثر على المشاعر فإن هذا التأثير لا يخرجه عن كونه نصا فكريا، بل يظل فكريا سواء آثّر أم لم يؤثر مادامت شرطيته متوفرة، ومادام الإهتمام به موجه إلى الفكر، فكان هذا الأخير هو قصده الأساسي. وبالإضافة فملاحظة تأثير النص الفكري على المشاعر لا يغير شروط فهمه بحيث لا خلاف في توفر هذه الملاحظة أو عدمها، لأن فهمه يتطلب معارف سابقة عن الأفكار، ويتطلب إدراكا لواقعها، وتصورا لمدلولها. والنص الفكري قد يكون صالحا لجميع الناس، وقد يكون محتويا على قدرة الأداء بحيث يوصل الأفكار لكل الناس مهما كانت مستوياتهم الثقافية، فهو على عمقه ممكن الفهم لكل الناس، ولكن مثل هذا النص وإن كان ممكنا أخذ ما نقدر على فهمه منه، ولكنه في عمقه ليس من المقدور فهمه من قبل كل الناس. نعم يقوى كل واحد منا على أخذ ما يقدر على فهمه، ولكن ليس كلنا بقادرين على التفكير به أو فهمه، وقد نسأل لماذا؟ والجواب على ذلك أن النص الفكري إذا لم توجد معارف ماضية ـ سابقة ـ في مستواها عنه لا يمكن فهمه. وإذا لم يكن واقع أفكاره مدركا لا يمكن فهمه أيضا. وإذا لم تكن مدلولات أفكاره متصورة لا يمكن فهمه كذلك، وبالتالي فإن الإستفادة منه تغيب، وتحقيق أفكاره أو تنفيذها يستحيل. فكوننا نأخذ منه ما نقدر على فهمه لا يعني أننا في مستوى فهمه، أو قادرون على ذلك، فالفهم هنا ينحصر في القدرة نظرا لعامل المعارف السابقة التي يجب أن تكون في مستواه، وهي غير متوفرة لدى كل الناس، أو لدى كل منا، وعليه لا يمكن فهم النص الفكري فهما صحيحا في غياب المعارف السابقة والتي يجب أن تكون في مستواه كما قلت. ولا يقال أن المعارف السابقة ـ أي المعلومات ـ تكفي لتكوين الفكر متى وجد الحس بحيث يكفي المرء أن يفهم النص الفكري متى ما توفرت لديه المعارف السابقة لأن هذه الأخيرة يفسر بها الواقع الذي يدل عليه النص أو يتضمنه، لا يقال ذلك، لأن المعارف السابقة وإن أريد بها تفسير الواقع الذي يتضمنه النص؛ إلا أنها لا توصل إلى الفهم الصحيح إذا كانت في غير مستواه، وكمثال على ذلك نأخذ المعارف السابقة التي تتعلق باللغة ـ أي المعلومات اللغوية ـ فهذه الأخيرة رغم توفرها لقارئ النص، أو الذي يحاول فهمه سواء كان النص مقروءا أو مسموعا، فإنه يفهمه فهما لغويا لأنها ـ أي المعلومات اللغوية ـ تفسر النص تفسيرا لغويا، ولكنها لا تكفي لتفسير الفكر. وإذا كانت معارفنا السابقة مثلا عن أنجع القيادات في العالم قديمها وحديثها هي القيادة الجماعية سواء كنا بصدد الحديث عن الفكر المادي، أو الفكر الديموقراطي، أو الفكر الإسلامي، وكانت هذه القيادة الجماعية متمثلة لدى الصنف الأول في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، أو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وكانت لدى الصنف الثاني متمثلة في البرلمان، أو مجلس الوزراء، وكانت لدى الصنف الثالث متمثلة في مجلس الشورى، فإن هذه المعارف لا تكفي لفهم القيادة، بل قد تضلل عن فهم القيادة فهما صحيحا، وهذا هو الحاصل فعلا. فالقيادة في أي نظام، ومن وجهة نظر أيّ تيار فكري إذا حاولنا تلمس واقعها الجماعي؛ لن نجده. فالقيادة ما كانت قط جماعية، ولن تكون أبدا، لأن القيادة فردية، وهي لا بد أن تكون فردية. فالقرار الأخير في الحزب الشيوعي ليس للجنة المركزية ولا للمكتب السياسي، بل للكاتب الأول للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، أو للأمين العام للجنة المركزية. والقرار الأخير في الفكر الديموقراطي ليس للبرلمان، ولا لمجلس الوزراء، بل لرئيس الوزراء إذا كان النظام وزاريا كما هو الشأن في الهند وإيطاليا وإسرائيل... ولرئيس الجمهورية إذا كان النظام جمهوريا كما هو الشأن في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان... وللملك إذا كان النظام ملكيا كما هو الشأن في بعض الأنظمة العربية كالمغرب والأردن والبحرين.. لأن الملك فيها يملك ويحكم بنفس الوقت، بخلاف الأنظمة الملكية الأخرى كالنظام الملكي البلجيكي والبريطاني والإسباني.. فإن الملك فيها يملك ولا يحكم، فكان النظام فيها وزاريا رغم أنه ملكي، أي أن القرار الأخير فيه يعود لرئيس الوزراء وليس للملك أو الملكة. والقرار الأخير في الفكر الإسلامي ليس لمجلس الشورى ولا لرئيسه، وليس لهيئة المعاونين.. بل للخليفة، لأنه هو الذي يحكم بناء على البيعة، لأنها تكون بيعة على على الحكم وهي بيعة الإنعقاد وليست بيعة الطاعة. وبهذا يتبين أن مدلول القيادة لم يكن مدركا عند الذي تصور أنها جماعية. فمعارفه السابقة عن القيادة لم تكن في مستواها بحيث ضلّل عن إدراك واقعها، وانحرف عن تصور مدلولها، فتصور ما أريد له تصوره حتى قال بالقيادة الجماعية إلى أن وصل إلى وصفها بأنها أنجع القيادات في العالم. والغالب أن الخطأ يحصل في الذهاب إلى تفسيرها تفسيرا لغويا خصوصا وأن الإنسان بطبعه الإجتماعي ينفر من الفردية. وهكذا تجري المغالطات في كثير من الحقائق علما بأن الفكر هو الذي يجب أن يوصل إليها. وأبرز الأسباب التي تحول دون إدراكها تكمن في المعارف السابقة والتي لا تكون في مستوى الفكر، وبذلك يحصل الخطأ في الاعتماد على الواقع غير المدرك، وعلى المدلول غير المتصور. وإذا كانت معارفنا السابقة عن الحكم بأنه القوة، فإن هذه المعارف لا تكفي لإدراك واقع الحكم فحسب، بل قد تضلل عن فهمه. فلبنان مثلا يحكم بالقوة منذ إندلاع الحرب الأهلية وهلم جرا، فالحاكم فيه هو القوي، ومع ذلك لا يعني الحكم؛ القوة. وروسيا تملك قوة رهيبة تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في بعض المجالات كالأسلحة التقليدية، ومع ذلك فإن الحكم فيها ليس لهذه القوة. وأي جيش يستولي على السلطة ويحكم الناس بواسطة سلاحه، فإن ذلك لا يعني أن الحكم هو القوة رغم هذه الظاهرة، لأنها ظاهرة مؤقتة وشاذة. فما الجيش إلا سند للسلطة مثله مثل السفراء وشيوخ القبائل والأعيان والأحزاب والأغنياء والمجتمع المدني من جهة كونهم سندا للسلطة، وهو سند غير طبيعي بخلاف الأمة أو الشعب لأنهما السند الحقيق والطبيعي للسلطة، فإن كان الكلام عن السند غير الطبيعي للسلطة كالذي ذكر، أو كأن يستند الحاكم على دولة ما يستعين بها على حكم شعبه، فإن الأمر في هذه الحالة يختلف، لأنه يكرس شريعة الغابة التي للحيوانات، وهو متوفر في بعض الأنظمة بكثير من البلدان النامية كما يسمونها خصوصا أمريكا اللاتينية والدول العربية إلا أنه يعتبر من الأمور الطارئة التي سرعان ما تزول. وإذا كانت معارفنا السابقة عن الحكم أيضا بأنه القضاء، وأن الحاكم هو منفذ الحكم، فإن هذه المعارف لا تصلح لتفسير الحكم؛ لأنها معارف لغوية، وحديثنا في هذا الباب عن الحكم بالمعنى الاصطلاحي، ولذلك لا بد من المعارف السابقة عن الحكم بالمعنى الاصطلاحي، أي لا بد من معراف تكون في مستوى الحكم بالمعنى الاصطلاحي، أي لابد أن ندرك واقع الحكم بأنه مباشرة رعاية شؤون الأمة أو الشعب بالفعل. وأن عمل الراعي سواء كان رئيسا أم ملكا أم أميرا هو دفع التظالم وفصل التخاصم، وهذا هو المعنى الاصطلاحي للحكم، أي مباشرة تنفيذ الأحكام، وهو بمعنى الملك والسلطان وقدرة الملك، ويكون ماعدا هذا إدارة، وليس حكما. وإذا كانت معارفنا السابقة عن المجتمع بأنه مجموعة من الناس يتبادلون العلاقات، فإن هذه المعارف لا تكفي للفهم، وبالتالي إن كان المرء يسعى إلى إصلاح المجتمع، أو يقصد إلى المحافظة عليه، أو يباشر تغييره فإن جميع هذه المعارف السابقة ليست في مستوى ما يعنيه المجتمع، وليست في مستوى ما يعنيه العمل من أجل الحصول على غاية واحدة من غايات السعي. وأكبر مثال على ذلك واقع الحركات الإصلاحية الترقيعية في العالم الإسلامي. فإنه حين جثم الاستعمار على صدر الأمة الإسلامية، وحين هدم دولتها عمل على نشر أفكاره ومفاهيمه عن الحياة. وحين تمكن من جعلها واقعا معاشا كان ذلك على حساب الأفكار والأحكام الإسلامية، أي أنه استبدلها بفكره وحضارته حين أحل محلها وجهات نظره وأنظمته فصارت حضارته هي السائدة رغم ما أبقى عليه من مظاهر للإسلام في المساجد، وما أبقى عليه من أحكام الزواج والطلاق والإرث.. لما فعل ذلك نهض بعض المسلمين فأنشئوا جمعيات إصلاحية ولا يزالون يتوخون من ورائها إصلاح المجتمع فعموا عن الحل الصحيح، وصاروا مرقعين للنظام الرأسمالي، ولما أوجده الإستعمار حتى ظهر على أيديهم إسلام يمزج بين حضارتين، حضارة غريبة وحضارة إسلامية، وكل ذلك ناتج عن عدم إدراكها لواقع المجتمع، وعدم تصورها لمدلوله، فرغم ما حصل لم ينتبهوا للتغيير الذي حصل في المجتمع، ولذلك نهضوا لإصلاحه، أي ترقيعه. أما الذين يعملون على المحافظة على المجتمع فإنهم وفّقوا في ذلك ما دامت عقلياتهم قد أصبحت غربية، وما داموا مقتنعين بجدوى أعمالهم لأنهم بمحافظتهم على المجتمع إنما يحفظون أنفسهم ومبدأهم وعلمانيتهم. وأما الذين يعملون على التغيير فإنهم أخفقوا نظرا لجهلهم الموضع الذي تأكل منه كتف الشاة، فتصوروا التغيير بواسطة الثورات والاضطرابات والمظاهرات، وتصوروه بواسطة الأعمال المادية كالإغتيالات.... صحيح أن المجتمع عبارة عن علاقات بين الناس، فيكون المجتمع هو الناس والعلاقات، ولكن هذه المعلومات السابقة رغم أنها صحيحة إلا أنها لا تكفي، بل قد تضلل عن الفهم الصحيح، وقد تضلل عن العمل المجدي سواء صبّ في خانة الإصلاح أو المحافظة أو التغيير، وهذا ما حصل بالفعل ولا يزال. فالمجتمع ليس عبارة عن علاقات بين الناس فحسب، إذ لو كان كذلك لكان المسافرون جماعيا في الطائرة والباخرة والقطار يشكلون مجتمعا، لأنهم ناس، ويتبادلون العلاقات أثناء سفرهم، ولكنهم لا يتبادلونها بشكل دائمي، بل بشكل مؤقت حسب ما تمليه عليهم ظروف السفر نظرا لحاجتهم لبعضهم البعض، ومن هنا كانت هذه المعارف قاصرة عن إدراك واقع المجتمع إدراكا صحيحا، فلا بد أن يكون إدراك واقع المجتمع في مستوى ما يعنيه وهو ـ أي المجتمع ـ عبارة عن علاقات دائمية بين الناس ضمن بيئة جغرافية معينة، هذا فيما يتعلق بواقع المجتمع. أما ما يتعلق بإصلاحه والمحافظة عليه وتغييره فإن هذه المعلومات لا تكفي بدورها، بل لا بد من إدراك تام وواقعي لتشكيلة المجتمع حتى يتأتى إصلاحه أو المحافظة عليه أو تغييره. فالعلاقات لا يتبادلها الناس إلا إذا كانت بينهم مصالح. والمصالح لا تكون مصالح إلا بناء على عنصر التحسين والتقبيح الناتج من العقل أو القلب، أي أن التحسين والتقبيح يحتاج إلى أفكار ومفاهيم لأنها هي التي تحدد المواقف، والأفكار لا قيمة لها بينهم إلا إذا كانت موحَّدة، أي لابد من وحدة الأفكار، فأنت لو كنت تاجرا تبيع لحما مذبوحا على الطريقة الشرعية، لحم غير الميتة وغير المحرّم، وكنت أنا مشتريا ولي نفس النظرة فإنه سوف تنشأ بيننا علاقة في البيع والشراء نظرا لوحدة الرؤية، ولكن إذا كنا مختلفين في الرؤية، فإنه سوف لا تنشأ بيننا علاقات، وهكذا في سائر مجالات الحياة، فلا تزوجني أختك إن كنت نصرانيا لا سمح الله، ولا أبتاع منك ميتة، ولا أبيعك خمرا.. ولا بد أن يكون شعورنا موحّدا، أي لا بد أن تكون بيننا وحدة في الرضى والغضب، ولابد أن يكون هناك نظام ينظم علاقاتنا مادام الإنسان يختلف مع أخيه الإنسان في قوة الإندفاع، وحتى لا تكون هنالك فوضى، ومن هنا كان المجتمع هو ناس وأفكار ومشاعر وأنظمة، وبمعرفة تركيبة المجتمع هذه، أي بإدراك واقعه وتصور مدلوله يتأتى إصلاحه، أو المحافظة عليه، أو تغييره، وبدونه يحصل الزلل، فلا بد من معلومات سابقة تكون في مستوى الفكر الذي يحويه النص الفكري، لا أن تكون مجرد معلومات عنه. ولا يقال أن النص الفكري يكفي لفهمه أن تكون المعلومات السابقة في مستواه فلا داعي لاشتراط إدراك واقعه وتصور مدلوله. لا يقال ذلك لأن النص الفكري يقع بين أمرين اثنين، فإما أن يفهم ليؤخذ، وهذا هو الأصل في سائر النصوص الفكرية. وإما أن يفهم ليترك ويحارب. والسعي الصحيح نحو فهمه لا يوصل إلى التلذذ به وإن توفرت فيه لذة، لأنها ليست مقصودة. ولا يوصل إلى الوقوف على معانيه، وإن وقف، بل هو يفهم من أجل أن يعمل به، ومن أجل أن يؤخذ، وإذا لم يكن كذلك فأيّ فائدة منه؟. وأيّ قيمة لوجوده؟ فمجرد المعرفة لا قيمة لها لأن الأصل في النص الفكري أن يقف عليه ليأخذه ويعمل به، وهذا هو معنى فهمه. ولكن أخذه هذا هل يتأتى بدون إدراك لواقعه، ودون تصور لمدلوله؟لا. وقد تجد من الناس من أخذ فكرا ما وعمل به دون إدراك لواقعه، ودون تصور لمدلوله، ولكن هؤلاء الناس مغرر بهم، وأن معلوماتهم السابقة عنه لم تكن في مستوى الفكر المأخوذ لأنهم لم يفهموه، بل زيّن لهم، أو أنهم عطّلوا عقولهم لمجرد ثقتهم فيمن لقّنهم، وهذا الأخير قد يكون مخلصا لهم، وقد يكون غير ذلك. فمن خلال ما تقدم يتضح لنا أن شروط فهم النص الفكري شروط ثلاثة هي : أولا :أن تكون المعارف السابقة في مستوى الفكر الذي يحويه النص الفكري والذي يراد فهمه. ثانيا: أن يكون واقعه مدركا إدراكا يجعله محددا ومميزا عن غيره. ثالثا : أن يكون الواقع متصورا تصورا صحيحا بحيث يكون التصور للواقع تصورا حقيقيا حتى يتبين أن الصورة هي صورته وليست صورة غيره. هذه الشروط مجتمعة تمكّن من فهم النصوص الفكرية، وبدونها لا يكون هناك فهم، ولا يكون هناك أخذ بالمعنى الصحيح للأخذ حتى ولو أخذ، أو ظهر ما يدل على أن المرء يعمل به حين أخذه، لأن هذا قد يكون ناتجا عن فهم معناه، وفهم معناه لا يعني أخذه حتى لو تظاهر المرء بذلك. وباختصار فإن فهم النص الفكري يتطلب الشروط الثلاثة المذكورة، وبدونها لا يمكن فهم النص الفكري، أي لا يمكن فهم الفكر، وبتعبير آخر لا يمكن أخذه، لأن الفهم للفكر يعني أخذه، ولا يعني فهم معناه. وعند البحث على أمثلة نعزز بها ما ذهبنا إليه؛ نجدها كثيرة سواء من الماضي أو من الحاضر. ويكفيني مثال واحد أجعل منه مثالين اثنين هو أفكار الإسلام. فالأفكار الإسلامية من عقائد وأحكام حين خوطب بها العرب بحكم البعثة التي كانت فيهم، وبحكم نزول الإسلام منجما بحسب الوقائع، فإن العرب فهموه وأخذوا به. وفهمهم له وأخذهم به لم يكن نتيجة لغتهم حتى قيل بأن اللغة العربية هي التي مكّنتهم من فهمه فأخذوا به، بل فهمه والأخذ به كان نتيجة إدراكهم لواقع أفكاره وأحكامه. ونتيجة تصورهم لمدلولاتها. فلم يأخذوا بأفكار الإسلام وأحكامه إلا بعد هذا الإدراك وذاك التصور، ومن هنا نتج تأثير الإسلام فيهم. ومنه نتج الإنقلاب الذي حصل في حياتهم. فقد قلبهم رأسا على عقب، وغير نظرتهم للكون بما فيه من إنسان وحياة. أصبحت القيم والمثل عندهم غير التي كانت بالأمس، انخفضت قيمة أشياء، وارتفعت أخرى في نظرهم, صار الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أحب إليهم مما سواهما حتى صاروا خير أمة أخرجت للناس بشهادة ربهم فضلا عن أعدائهم. ونفس العرب حاليا حين فقدوا إدراك أفكار الإسلام وأحكامه، وحين لم يعد متصورا لديهم مدلولها؛ كان من الطبيعي أي ينتج عن ذلك عدم فهمهم لأفكار الإسلام وأحكامه، أي عدم أخذهم بها حتى ما عادت تؤثر فيهم إلا في الجانب الكهنوتي نظرا لحتمية إشباع غريزة التدين في الإنسان وهم من نفس الجنس، ونظرا كذلك لاقتفائهم أثر الغرب في نظرته للدين. فبالرغم من كثرة المحدثين الذين فاق بعضهم الإمام مالك في علمه. وبالرغم من كثرة الفقهاء الذين وسع علم بعضهم علم الإمام أبي حنيفة. وبالرغم من كثرة المفسرين الذين يوجد فيهم من هو أكثر إحاطة من الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله... بالرغم من كل هذا لم يوجد فيهم من هو في مستوى من كان قريبا من مالك، ولا في مستوى من كان في عصر ابن عباس، ولا في مستوى من كان في عهد أبي حنيفة. كل هذا لم ينتج بسبب التقصير في معرفة الأفكار، بل هو ناتج عن عدم إدراك واقعها، وناتج أيضا عن عدم تصور مدلولها. وعليه فإنه للتفكير بالنص الفكري يجب أن لا يكتفى بالمعلومات السابقة التي تكون في مستوى الفكرة أو الأفكار، بل يجب إلى جانب تلك المعلومات السابقة التي في مستوى الفكر؛ إدراك لواقعه وتصور لمدلوله. هذا من جهة فهم النص الفكري من أجل أخذه، ولكن وكما سبقت الإشارة فإن فهم النصوص الفكرية لا يكون من أجل أخذها فحسب، وإن كان الأخذ هو الأصل في كل نص فكري، غير أنه لا يسري على جميع النصوص الفكرية، بل قد يسري على معظمها، أو على القليل منها، أي أن البحث لا يتعلق بالكم ولا بالنّسب، بل يتعلق بالأخذ والترك. فبما أن من النصوص الفكرية ما يجب أخذه وتبنيه، كذلك منها ما يجب تركه ومحاربته، وكلتا الحالتين ترتبطان بالفهم. فلا يؤخذ فكر إلا بعد فهمه، وفهمه يكون على نفس الوتيرة، ولا يهجر فكر أو يحارب إلا بمثل طريقة الأخذ والتبني، وفي جانب معين يترك بمناقضته للقاعدة الفكرية التي ترتكز عليها شخصية المفكر بالنصوص الفكرية. إن الأخذ هو المقصود، ولكن إن كان من النصوص الفكرية ما لا يؤخذ فسوف يكون مما يترك. والترك قد يكون مجرد ترك، وقد يكون مما يجب أن يحارب كما سبقت الإشارة. وإذا لم يكن هناك إدراك لواقع الفكر الذي يجب أن يترك أو يحارب وتصور لمدلوله، فإن الأمر قد يؤدي بصاحبه إلى الزلل والضلال أو الانحراف. فقد يأخذ المرء ما كان جديرا بالترك. وقد يترك ما كان جديرا بالأخذ، وربما أخذ فكر ما وكان الصواب عدم أخذه، وربما حورب فكر ما وكان الصواب عدم محاربته، بل كان الصواب ليس أخذا ولا تركا، وإنما الوقوف عليه وقوف المعرفة مجرد معرفة دون أخذ أو ترك. ولذلك لابد لفهم النص الفكري من الشروط المذكورة لأنه بهذه الشروط يُتّخذ الموقف الذي يجب أن يُتّخذ سواء تم الذهاب نحو الأخذ أو نحو الترك والمحاربة. وما يعصم الفكر من الزلل، وما يحفظه من الانحراف والضلال، وما يؤدي إلى القرار السليم تجاهه؛ هو الإدراك لواقعه، والتصور لمدلوله. وإذا نظرنا إلى الخطر الكامن في الفكر الفاسد نجد أن الضرر لا يقف عند حد الاقتصار على معرفة فساده، بل قد يصرف صاحبه عن القيام بالأعمال الهامة في حياته، وقد يكون منه ما تجب محاربته بكشف واقعه الفاسد، ووضع الأصبع على مدلوله. ومن الأفكار ما لا يقف ضررها أيضا عند حد الاقتصار على المعرفة، بل قد يصرف صاحبه الذي يأخذه عن أعمال أساسية في حياته، وقد يجعله يزلّ وينحرف، أو يضل ضلالا بعيدا. ومن أقرب الأمثلة على ما أثبتناه فعل دراسة الفلسفة اليونانية في كثير من المسلمين، وكذلك فعل الأفكار الرأسمالية والأفكار الشيوعية في آخرين أيضا. فكل هذا إنما نتج لأن إدراك الواقع لم يكن بالشكل الذي يستطيع تحديده وتمييزه، ولأن التصور لمدلول الأفكار لم يكن على الشكل الصحيح. فنصارى الشام مثلا ونصارى العراق أيضا وجدت لديهم الفلسفة اليونانية قبل أن توجد عند المسلمين، والمسلمون قد حملوا دعوة الإسلام إلى هؤلاء النصارى، ولكن بعد استتباب الأمر نتيجة انتصارين حاسمين في اليرموك والقادسية صارت جميع البلاد بسكانها خاضعة للحكم الإسلامي، وأثناء هذا الخضوع بدأت الحضارة الإسلامية بجميع مقوّماتها تكتسح ما وجدته من أفكار خاطئة ومفاهيم ساقطة بطريق النقاش وعدم الإكراه، تقدمت الحضارة الإسلامية في الصعيد الذهني والقلبي تهزهما بالأدلة والبراهين، في هذه الأثناء لجأ النصارى إلى الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني لمناقشة المسلمين بواسطتهما، فلجأ المسلمون بدورهم إلى نفس الفلسفة ونفس المنطق ليردوا بهما على النصارى، فكان أن استعملوهما دون إدراك للأفكار التي تضمنتها تلك الفلسفة، ودون رؤية المغالطات التي تدخل في مقدمات المنطق، فنتج عن هذه الدراسة التي لم تكن أول أمرها إلا لنشر الإسلام حسب قولهم؛ أن ذهب إليها بعض من علمائهم لما في دراستها من لذة ومتعة، كما ذهب إليها آخرون بغية الرد على النصارى، وكذلك من أجل البرهنة على صحة الإسلام، وصحة أفكاره وأحكامه. هذا ما حصل بالفعل، غير أن الفريق الأول بحكم ما صاروا إليه، والوضع الذي وجدوا عليه ألفوا أنفسهم سائرين في نفس الطريق الذي مسلكه فلاسفة اليونان، فصاروا شبيهين بهم حين أخذوا الفلسفة اليونانية على أساس الانتفاع بها؛ فصارت ثقافتهم، وحين اعتنقوا آراءها؛ فصارت آراءهم مع شيء من المراعاة للإسلام، ولكن حسب ما يراه الفكر الفلسفي اليوناني، فنتج عن هذا المخاض ولادة الفلاسفة (المسلمون)، أو فلاسفة (الإسلام)، فمنهم من انحرف وزلّ، ومنهم من شطّ شططا بعيدا، وكلا الفريقين كما هو واضح وضوح الشمس في الظهيرة، وكما هو مقرر فيما خلّفوه من كتابات تنسب إليهم قد ترك الإسلام، ولا فرق بين من ينتمي إلى الانحراف، أو إلى الضلال، إذ أيّا كان منهم ينطبق عليه ما قرره الإسلام في حقهم وحق من يسلك سبيلهم سواء كان ابن رشد والكندي، أو كان الفارابي وابن سينا أو غيرهم. وأما الفريق الثاني ممن درس المنطق اليوناني، والفلسفة اليونانية، فإنهم صاروا فريقين. فريق اتخذ الفلسفة اليونانية أساسا له فصار يؤوِّل الإسلام وأفكار الإسلام بالشكل الذي يجعله متفقا مع الفكر الفلسفي اليوناني الذي جعله أساسا له حتى أن الفكر الفلسفي اليوناني بدأ تطبيقه على الفكر الإسلامي بأيديهم، وهؤلاء هم المعتزلة. والفريق الآخر وقف من الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني موقف الناقد والمعارض، فبنقده صار يحاول تصحيح ما يحتاج إلى تصحيح، هذا ما استقر عليه، وبمعارضته تلك صار يهاجم ما يرى فيها من ضلال، وهؤلاء هم أهل السنة، فاستفحل الجدال بين الفريقين، بين المعتزلة وأهل السنة، وشغلوا بجدالهم هذا عن حمل الدعوة الإسلامية ومد إشعاعها أكثر في العالم حتى انصرفوا إليه كلية، فاتصرفوا بذلك عما أوجبه الله عليهم من عمل حمل الدعوة الإسلامية إلى غير المسلمين، وكان ذلك محاولة منهم تصحيح العقائد عند المسلمين، فتارة باستخدام الأفكار الفلسفية اليونانية ليبرهنوا بها على الإسلام وصحة أفكاره وليبلوروها، وتارة أخرى بالرد عليها، فانشغل المسلمون بهذا الهراء أجيالا كثيرة وقرونا عديدة.. هؤلاء المسلمون الذين خاضوا في الفلسفة اليونانية تخلوا بسبب خوضهم عن حمل دعوة الإسلام إلى غير المسلمين بنفس الفلسفة طبعا والتي كانت عائقا كبيرا في طريق الإسلام خصوصا بعد نجاحها في اقتعاد مكانة في أدمغة العلماء وكذلك مجموع المسلمين. وياليت الأمر اقتصر على هذا. وياليته وقف عند هذا الحد، بل كان من جراء ذلك أن وجدت جماعات أخرى اهتمت بدورها في توسيع رقعة التشويش والبلبلة على الأفكار الإسلامية من أمثال ـ القدريـة ـ و ـ المرجئة ـ و ـ الجبرية ـ وغيرها، فظهرت ملل ونحل، ووجدت أفكار وجماعات بين المسلمين، فكانت بلبلة كبيرة حُدّت لها معاول وأدوات فكادت تقوى على طمس الحقائق، وكادت تقوى على استمالة الجميع إلى ساحتها حتى وجدت فرق بالعشرات، ومذاهب بالمئات، ولم يكن كل هذا إلا بسبب دخول الفلسفة اليونانية لبلاد الإسلام، وبسبب إقبال المسلمين على دراستها دون إدراك سليم يحددها ويميزها في فكرها، ودون تصور يقظ وصحيح لمدلول أفكارها. ولا يسعنا عند هذه النقطة إلا أن نقف عند الإسلام نفسه، فقوته، وحجته البالغة، وصفاؤه، ومواقف أهل السنة والجماعة الصادقة والمخلصة، ووقوفهم في وجه الأفكار اليونانية ببيان فسادها، والواقع الذي تدل عليه، ثم تصوير مدلولها للناس تصويرا صحيحا، وسل السيف في وجه الهدّامين من الفرق الضالة؛ هو الذي حفظ الإسلام وأفكار الإسلام من التلاشي والضياع، لولا ذلك لضاع الإسلام من جراء المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية وما أوجداه من أفكار وآراء، لولا ذلك لذهب الإسلام. وأما الأفكار التي تمخضت عنها الثورة الفرنسية والتي شكلت فيما بعد المبدأ الرأسمالي الذي صار يسودنا. والأفكار التي تمخضت عنها الثورة البلشفية والتي شكلت فيما بعد المبدأ الاشتراكي الشيوعي الذي صار يسود بعضنا، فإن خطرهما من الأمور المشاهدة المحسوسة، وضلال أفكارهما قد عمّ مجموع المسلمين، وإن الأخطاء التي تضمنتها مفاهيمهما عن الحياة قد تفشّت تفشّيا كبيرا في سائر البلاد الإسلامية وبين جماهير المسلمين وفي العالم أجمع. ولإقامة الدليل على الأفكار الضالة، والمفاهيم الخاطئة، فإننا بحاجة إلى مجرد تذكير فقط ولفت نظر الناس إلى التخريب الذي حدث في عقول المسلمين من جراء الانضباع بها، لأن الأمر لا يحتاج إلى إقامة الدليل، فهذه الحياة التي يحيا ها المسلمون في تبادل علاقاتهم، وهذه الأفكار والمفاهيم المعششة في أدمغتهم لأكبر دليل على ما أحدثته الأفكار الرأسمالية والإشتراكية من تخريب في عقولهم وفساد في سلوكهم. ولذلك فإن التفكير بالنص الفكري يجب أن لا يعرف فحسب مجرد معرفة، بل يجب أن يعرف تمام المعرفة، وأنه لا فائدة من مجرد وجود معلومات سابقة عنه، لأن هذا لا يكفي، بل لا بد من التحقق من أن المعلومات في مستوى الفكر، وأن إدراك واقعه بالشكل الذي يحدده ويميزه قد وجد بالفعل، وأن يكون التصور لمدلوله تصورا صحيحا يمكّن من إعطاء الصور الحقيقية عن ذلك المدلول. وإذا أخذنا الإسلام من أجل معرفة موقفه من الدراسات الفكرية، نجد أنه لم ينه عن مثل هذه الدراسات، بل أباحها، ولم ينه عن أخذ الأفكار، بل أباح أخذها أيضا، وهذا قد حصل في تاريخ المسلمين. وحين أتحدث عن حصول هذا في التاريخ الإسلامي، فإنني لا أعني اعتبار ما حصل دليلا على إباحة الدراسة للأفكار الأجنبية وأخذها، لا، لأن الدليل على إباحة الدراسة وإباحة الأخذ لا يؤتى به من المسلمين ولا من علمائهم وفقهائهم، بل يؤتى به من الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة لا أي إجماع آخر، ثم القياس الشرعي المبني على علة شرعية، ومن هنا نفهم أن المسلمين قد فهموا موقف الإسلام من هاتين القضيتين، فلم يقفوا في وجه الترجمة لأفكار الشعوب والأمم غير الإسلامية، لم يعترضوا على الدراسة التي حصلت للفكر الأجنبي، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في موضوع الأخذ والتبني، فمنهم من رأى أخذ الأفكار دون قيد وشرط، ومنهم من رأى غير ذلك، وهنا يجب الوقوف قليلا، فالقلة القليلة منهم هي التي وعت وهضمت موقف الإسلام على وجهه الصحيح. فصحيح أن الإسلام كما قلنا لم ينه عن الدراسات للفكر الأجنبي، ولم ينه عن أخذه، بل أباح دراسة الأفكار، وأباح أخذها، ولكن هذا الإسلام مادام عقائد وأحكاما، فإنه ولا شك يرتكز على أساس معين؛ هو قاعدته الفكرية وقيادته، وهذه القاعدة هي العقيدة الإسلامية، وهي قد جُعلت أساسا للقياس والبناء والانبثاق، فوجب جعلها قاعدة للأفكار، ووجب جعلها مقياسا لأخذ الفكر، أو رفضه، فهو ـ أي الإسلام ـ لا يجيز أخذ ما يتناقض مع القاعدة الفكرية من أفكار رغم أنه لا يمانع من قراءة النصوص التي تحويها. فهو لا يجيز أخذ أية فكرة إلا إذا كانت القاعدة الفكرية قد أباحت أخذها. وباعتبار هذه العقيدة قاعدة، فإن موقفه منذ انطلاقته وهلم جرا، ومن الآن فصاعدا من جميع المعارف والثقافات الأجنبية هو هو لا يتبدل، أو يتغير، فما أباحت قاعدته أخذه يُؤْخذ، وما رفضت أخذه يُرْفض، وما يُؤسَف له في تاريخ المسلمين القديم؛ أنهم قلّ فيهم من كان على بينة من هذا الأمر، ولذلك طغى أخذ الأفكار اليونانية دون إعتبار موقف الإسلام منها، وما يؤسف له كذلك أننا اليوم صرنا مضبوعين بالأفكار الرأسمالية والأفكار الاشتراكية فصارتا أفكار كثير منا دون مراعاة اعتبار موقف الإسلام منها. ولإدراك ما يوافق القاعدة الفكرية، ولإدراك ما يناقضها وجب إدراك واقع الفكر إدراكا يحدده ويميزه. ووجب تصور مدلوله تصورا صحيحا حتى يمكن اتخاذ الموقف الصحيح تجاهه. فالموقف لا يتخذ إلا بناء على هذا الإدراك، وبدونه يتعذر إن لم يستحل قياس الفكر بالقاعدة الفكرية. فالتفكير بالنص الفكري أيا كان هذا النص يجب أن يكون لدى المفكر به معارف ماضية ـ سابقة ـ في مستوى الفكر علاوة على ذلك أن يكون مدركا لواقعه إدراكا يحدده ويميزه، وأن يكون مدلوله متصورا عنده تصورا صحيحا يعطي الصورة الحقيقية له. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ محمد محمد البقاش أديب ومفكر مغربي من طنجة المؤلف: محمد محمد البقاش أديب باحث وصحافي. الكتاب: التفكير بالنصوص ( دراسة أكاديمية ). الحقوق: محفوظة للمؤلف. الطبعة الأولى ـ ورقية ـ: يونيو 1999. السحب: مصلحة الطباعة Servise Grafic Tanger النشرة الإلكترونية الأولى: الإيداع القانوني: 462 ــ 98 ردمد 1114 – 8640 ISSN |
 |
| أدوات الموضوع | |
|
|