
 |
| جديد المواضيع |

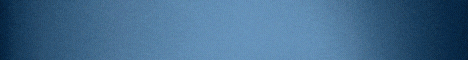
| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
شبهة أن اختلاف الصحابة هو الذي حرم الأمة العصمة وأدى إلى تفرقها وتمزقها
شبهة أن اختلاف الصحابة هو الذي حرم الأمة العصمة وأدى إلى تفرقها وتمزقها ومن هذه الشبهات قولهم أن اختلاف الصحابة هو الذي حرم الأمة العصمة وأدى إلى تفرقها وتمزقهاحيث قالوا: والمشكل الأساسي في كل ذلك هو الصحابة، فهم الذين اختلفوا في أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الكتاب، الذي يعصمهم من الضلالة إلى قيام الساعة، واختلافهم هذا هو الذي حرم الأمة الإسلامية من هذه الفضيلة، ورماها في الضلالة، حتى انقسمت وتفرقت وتنازعت وفشلت وذهبت ريحها، وهم الذين اختلفوا في الخلافة، فتوزعوا بين حزب حاكم، وحزب معارض، وسبب ذلك تخلف الأمة، وانقسامها إلى: شيعة علي، وشيعة معاوية، وهم الذين اختلفوا في تفسير كتاب الله، وأحاديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت المذاهب والفرق والملل والنحل، ونشأت من ذلك المدارس الكلامية والفكرية المختلفة، وبرزت فلسفات متنوعة أملتها دوافع سياسية محضة، تتصل بطموحات الهيمنة على السلطة والحكم. فالمسلمون لم ينقسموا ولم يختلفوا في شئ لولا الصحابة، وكل خلاف نشأ وينشأ إنما يعود إلى اختلافهم في الصحابة». قلنا: قوله فهم الذين اختلفوا في أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الكتاب، الذي يعصمهم من الضلالة إلى قيام الساعة، وأن هذا الاختلاف هو الذي حرم الأمة من هذه الفضيلة، يشير بذلك إلى ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا، وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع).[1] وقد ذكرنا الرد على هذه الشبهة في هذا الكتاب. أما الزعم أن اختلافهم هذا هو الذي حرم الأمة الإسلامية من العصمة ورماها في الضلالة والتفرق إلى قيام الساعة. والجواب على هذا: إن هذا القول باطل، وهو يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك تبليغ أمته ما فيه عصمتها من الضلال، ولم يبلغ شرع ربه لمجرد اختلاف أصحابه عنده حتى مات على ذلك، وأنه بهذا مخالف لأمر ربه في قوله: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس}. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبرأً من ذلك ومنزهاً بتزكية ربه له في قوله: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَنِتُّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} فوصفه بالحرص على أمته: أي على هدايتهم، ووصول النفع الدنيوي والأخروي لهم، ذكره ابن كثير في تفسيره[2]: وإذا كان هذا الأمر معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام عند الخاص والعام، لايشك فيه من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أن هذا الرسول الكريم قد بلغ كل ما أُمر به، وكان أحرص ما يكون على أمته، بما هو متواتر من جهاده وتضحيته، وأخباره الدالة على ذلك، علمنا علماً يقينياً لا يشوبه أدنى شك، أنه لو كان الأمر كما يذكر هذا الطاعن من الوصف لهذا الكتاب من أن به عصمة الأمة من الضلال في دينها، ورفع الفرقة والاختلاف فيما بينها، إلى أن تقوم الساعة، لما ساغ في دين ولا عقل أن يؤخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابته إلى ذلك الوقت الضيق، ولو أخره ما كان ليتركه لمجرد اختلاف أصحابه عنده[3] وقد ثبت من سيرته أنه لربما راجعوه أحياناً في بعض المسائل مجتهدين، فما كان يترك أمر ربه لقولهم، كمراجعة بعضهم له في فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي، وذلك في حجة الوداع، وكذلك مراجعة بعضهم له يوم الحديبية، وفي تأمير أسامة[4]<SUP> </SUP>-رضي الله عنه-، فهل يتصور بعد هذا أن يترك أمر ربه فيما هو أعظم من هذا لخلافهم، ولو قدر أنه تركه في ذلك الوقت لتنازعهم عنده لمصلحة رآها فما الذي يمنعه من أنه يكتبه بعد ذلك، وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك عدة أيام فقد كانت وفاته -عليه الصلاة والسلام- يوم الإثنين على ما جاء مصرحاً به في رواية أنس في الصحيحين[5] وحادثة الكتاب يوم الخميس بالاتفاق. فإن أبى الطاعن إلا جدالاً، وقال: خشي أن لا يقبلوه منه، ويعارضوه فيه، كما تنازعوا عنده أول مرة، قلنا: لا يضره ذلك وإنما عليه البلاغ كما قال تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً}. فإذا ثبت هذا باتفاق المسلمين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتب ذلك الكتاب حتى مات، علمنا أنه ليس من الدين الذي أمر بتبليغه، ولا على ما يصفه هذا الطاعن من المبالغة لاستحالة ذلك على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولِمَا دل عليه القرآن من أن الله قد أكمل له ولأمته الدين، فأنزل عليه قبل ذلك في حجة الوداع: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً}. وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في قوله: (إني تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك).[6] فإذا تقرر بطلان ما يدعي هذا الطاعن من أن الأمة وقعت في الضلالة، وحرمت العصمة بسبب عدم كتابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم ذلك الكتاب لاختلاف الصحابة عنده: فليعلم بعد هذا أن الذي أراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كتابة ذلك الكتاب هو أن يكتب لهم كتاباً يبين فيه فيمن تكون الخلافة من بعده كما ذكر ذلك العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت، إذ لو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وآله وسلم ما أمره الله به، لكن ذلك مما رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي بكر، ورأى أن الخلاف لابد أن يقع».[7] وقال في موضع آخر: «وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يكتبه، فقد جاء مبيناً كما في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه: (ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)[8] ... [إلى أن قال بعد ذكر روايات الحديث]: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع، علم أن الكتاب لا يرفع الشك، فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال: (ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)».[9] وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: (لن تضلوا بعدي) فيقول الدهلوي في توجيهه: «فإن قيل: لو لم يكن ما يكتب أمراً دينياً فلم قال: (لن تضلوا بعدي؟) قلنا: للضلال معان، والمراد به ههنا عدم الخطأ في تدبير الملك، وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزه، وتجهيز جيش أسامة منه، لا الضلالة والغواية عن الدين».[10] وأما قوله: «وهم الذين اختلفوا في الخلافة فتوزعوا بين حزب حاكم وحزب معارض، وسبب ذلك تخلف الأمة وانقسامها إلى شيعة علي وشيعة معاوية...» فالجواب على هذا: أن الخلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم - في عهد علي -رضي الله عنه- لم يكن في الخلافة، فإن الذين اختلفوا مع علي -رضي الله عنه- هم: طلحة، والزبير، وعائشة، ومعاوية -رضي الله عنهم-، ولم يكن هؤلاء ينازعونه في الخلافة بل لم يَدَّعِ أحد لامن هؤلاء ولا من غيرهم، أنه أولى بالخلافة بعد مقتل عثمان -رضي الله عنه- من علي؛ لأنه أفضل من بقي، وقد كانوا يقرون له بالفضل، وإنما أصل الخلاف بين هؤلاء الصحابة المذكورين وعلي هو في المطالبة بدم عثمان وقتل قتلته، فقد كانوا يرون تعجيل ذلك والمبادرة بالاقتصاص منهم، وقد كان علي -رضي الله عنه- لا ينازعهم في أن عثمان -رضي الله عنه- قُتل مظلوماً، وعلى وجوب الاقتصاص من قتلته، وإنما كان يرى تأجيل ذلك حتى تهدأ الأوضاع ويستتب له الأمر، لأن قتلة عثمان كثير وقد تفرقوا في الأمصار كما كانت طائفة كبيرة منهم في المدينة بين الصحابة. ومع هذا كله فإن اختلافهم -رضي الله عنهم- لم يصل بهم إلى الطعن في الدين، واتهام بعض لبعض، وإنما كان كل فريق يرى لمخالفه مكانته في الفضل والصحبة ويرى أنه مجتهد في رأيه، وإن كان يخطئه فيه. فههنا ثلاث مسائل مقررة عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة، يندفع بها ما يثيره هؤلاء المغرضون من شبه، حول الفتنة التي حصلت في زمن الصحابة -رضي الله عنهم- في خلافة علي وهي: المسألة الأولى: أن الخلاف الذي حصل بينهم لم يكن حول الخلافة، ولم ينازع علياً -رضي الله عنه- أحد من مخالفيه فيها، ولم يَدَّعِ أحد منهم على الإطلاق أنه أولى بالخلافة من علي. المسألة الثانية: أن الخلاف بينهم إنما هو في تعجيل قتل قتلة عثمان أو تأخيره، مع اتفاقهم على وجوب تنفيذ ذلك. المسألة الثالثة: أنهم مع اختلافهم لم يتهم بعضهم بعضاً في الدين، وإنما يرى كل فريق منهم أن مخالفه مجتهد متأول، يعترف له بالفضل في الإسلام، والصحبة لرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسائل عظيمة، دلت عليها الأخبار الصحيحة. وفيها توضيح لحقيقة الخلاف بين الصحابة وتبرئة لساحتهم من كل مايرميهم به الطاعنون والزنادقة، وهي أصل كبير في الرد على هؤلاء ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها بأدلتها، وإليك أيها القارئ بسط الأدلة على تقريرها: المسألة الأولى: أن الخلاف الذي حصل بينهم لم يكن في الخلافة، ولم ينازع علياً أحد من مخالفيه فيها، ولم يدع أحد منهم أنه أولى بها من علي -رضي الله عنه-. ومن أقوى الأدلة، وأكبر الشواهد على هذا: اجتماع الصحابة -رضي الله عنهم- على مبايعته بالخلافة بعد مقتل عثمان -رضي الله عنه- بما فيهم طلحة والزبير -رضي الله عنهما-، وقد دلت على ذلك الروايات الصحيحة المنقولة عنهم في ذلك. منها مارواه الطبري في تاريخه بسنده إلى محمد بن الحنفية، قال: «كنت مع أبي حين قتل عثمان -رضي الله عنه- فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة، ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تفعلوا، فإني أكون وزيراً، خيرٌ من أن أكون أميراً، فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك، قال: ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خَفِيّاً ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. قال سالم بن الجعد، فقال عبدالله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يُشْغَب عليه، وأبى هو إلا المسجد، فلما دخل دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس».[11] وعن أبي بشير العابدي قال: «كنت بالمدينة حين قتل عثمان -رضي الله عنه- واجتمع المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير فأتوا علياً، فقالوا: يا أبا الحسن هلم نبايعك، فقال: لا حاجة لي في أمركم أنا معكم، فمن اخترتم فقد رضيت به، فاختاروا والله، فقالوا: ما نختار غيرك....»[12]<SUP> </SUP>الخ الرواية، وفيها تمام البيعة لعلي-رضي الله عنه-. والروايات في هذا كثيرة ذكر بعضها ابن جرير في تأريخه[13]<SUP> </SUP>وهي دالة على مبايعة الصحابة -رضي الله عنهم- لعلي -رضي الله عنه- واتفاقهم على بيعته بما فيهم طلحة والزبير، كما جاء مصرحاً به في الرواية السابقة. وأما ما جاء في بعض الروايات من أن طلحة، والزبير بايعا مكرهين فهذا لا يثبت بنقل صحيح، والروايات الصحيحة على خلافه. فقد روى الطبري عن عوف بن أبي جميلة قال: «أما أنا فأشهد أني سمعت محمد بن سيرين، يقول: إن علياً جاء فقال لطلحة: ابسط يدك ياطلحة لأبايعك. فقال طلحة: أنت أحق، وأنت أمير المؤمنين، فابسط يدك، فبسط علي يده فبايعه».[14] وعن عبد خير الخَيْوانيّ أنه قام إلى أبي موسى فقال: «يا أبا موسى، هل كان هذان الرجلان -يعني طلحة والزبير- ممن بايع علياً قال: نعم...».[15] كما نص على بطلان ما يُدَّعَى من أنهما بايعا مكرهين، الإمام المحقق ابن العربي وذكر أن هذا مما لا يليق بهما، ولا بعلي قال-رحمه الله-: «فإن قيل بايعا مكرهين [أي طلحة والزبير]، قلنا: حاشا لله أن يكرها، لهما ولمن بايعهما، ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك، لأن واحداً أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له، وهو مكره على ذلك شرعاً، ولو لم يبايعا ما أثر ذلك فيهما، ولا في بيعة الإمام. وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم[16]، فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع ولم يكن كذلك. فإن قيل فقد قال طلحة: (بايعت واللُّجّ علي قَفَيّ) قلنا: اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في (القفا) لغة (قفى)، كما يجعل في (الهوى) (هوي)، وتلك لغة هذيل لا قريش[17]، فكانت كذبة لم تدبر. وأما قولهم: (يد شلاء) لو صح فلا متعلق لهم فيه، فإن يداً شُلّت في وقاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم لها كل أمر، ويتوقى بها من كل مكروه، وقد تم الأمر على وجهه، ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه».[18] وكذلك معاوية -رضي الله عنه- فقد ثبت بالروايات الصحيحة أن خلافه مع علي -رضي الله عنه- كان في قتل قتلة عثمان -رضي الله عنه- ولم ينازعه في الخلافة بل كان يقر له بذلك. فعن أبي مسلم الخولاني أنه جاء وأناس معه إلى معاوية وقالوا: «أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُتل مظلوماً، وأنا ابن عمه والطالب بدمه فأتوه، فقولوا له فليدفع إليّ قتلة عثمان وأسلم له، فأتوا علياً فكلموه فلم يدفعهم إليه[19]».[20] ويروى ابن كثير من طرق ابن ديزيل بسنده إلى أبي الدرداء وأبي أمامة -رضي الله عنهما- «أنهما دخلا على معاوية فقالا له: يا معاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فو الله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاماً، وأقرب منك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحق بهذا الأمر منك، فقال: أقاتله على دم عثمان، وإنه آوى قتلته، فاذهبا إليه فقولا له: فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام».[21] والروايات في هذا كثيرة مشهورة بين العلماء[22] وهي دالة على عدم منازعة معاوية لعلي -رضي الله عنهما- في الخلافة ولهذا نص المحققون من أهل العلم على هذه المسألة وقرروها. يقول إمام الحرمين الجويني: «إن معاوية وإن قاتل علياً فإنه لا ينكر إمامته، ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظاناً منه أنه مصيب وكان مخطئاً».[23] ويقول ابن حجر الهيتمي: «ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما- من الحروب فلم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعلي كما مر فلم تهج الفتنة بسببها، وإنما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم، لكون معاوية ابن عمه فامتنع علي».[24] ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ومعاوية لم يدَّعِ الخلافة، ولم يبايع له بها حين قاتل علياً، ولم يقاتل على أنه خليفة، ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه... وكل فرقة من المتشيعين[25] مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفأ لعلي بالخلافة، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي -رضي الله عنه- فإن فضل علي وسابقيته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله: كانت عندهم ظاهرة معروفة».[26] فثبت بهذا أنه لم ينازع علياً -رضي الله عنه- أحدٌ في الخلافة لامن الذين خالفوه ولا من غيرهم، وبهذا يبطل ما ادعا هذا الطاعن من أن الصحابة تنازعوا في الخلافة، وترتب على ذلك تفرق الأمة وانقسامها. المسألة الثانية: أن الخلاف بين علي ومخالفيه -رضي الله عنهم- إنما هو في تقديم الاقتصاص من قتلة عثمان أو تأخيره مع اتفاقهم على وجوب تنفيذه. وهذه المسألة مقررة أيضاً عند أهل العلم من أهل السنة بما ثبت في ذلك من الأخبار، والآثار الدالة على أن علياً -رضي الله عنه- لا ينازع مخالفيه في وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان، وإنما كان يرى تأجيل ذلك حتى يستتب له الأمر. وذلك أن قتلة عثمان -رضي الله عنه- كانوا قد تمكنوا من المدينة، ثم قام في أمرهم من الأعراب وبعض أصحاب الأغراض الخبيثة ما أصبح به قتلهم في أول عهد علي -رضي الله عنه- متعذراً. يشهد لهذا ما ذكره الطبري حيث يقول: «واجتمع إلى علي بعدما دخل طلحة والزبير في عدة من الصحابة، فقالوا: يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلّوا بأنفسهم، فقال لهم: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم! هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لا، قال: فلا والله لا أرى إلا رأياً ترونه إن شاء الله».[27] ويقول ابن كثير: «ولما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة -رضي الله عنهم- وطلبوا منه إقامة الحدود، والأخذ بدم عثمان، فاعتذر إليهم: بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان، وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا».[28] فكان هذا هو عذر علي -رضي الله عنه- في بداية الأمر، أما بعد ذلك فإن الأمور أصبحت أكثر تعقيداً، وأشدّ اشتباهاً، خصوصاً بعدما اقتتل الصحابة -رضي الله عنهم- في معركة الجمل بغير اختيار منهم، وإنما بسبب المكيدة التي دبرها قتلة عثمان للوقيعة بينهم، كما تقدم بيان ذلك، فلم يكن أمر الاقتصاص مقدوراً عليه بعد هذه الأحداث لا لعلي، ولا لغيره من مخالفيه، وذلك لتفرق الأمة وانشغالها بما هو أولى منه من تسكين الفتنة ورأب الصدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «لم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكناً من قتل قتلة عثمان، إلا بفتنة تزيد الأمر شرّاً وبلاءً. ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من العكس، لأنهم كانوا عسكراً، وكان لهم قبائل تغضب لهم، والمباشر منهم للقتل -وإن كان قليلاً- فكان ردؤهم أهل الشوكة، ولولا ذلك لم يتمكنوا، ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان، قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق. ومما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليه بعد موت علي، وصار أميراً على جميع المسلمين، ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا».[29] وعلى كل حال فأياً كان عذر علي -رضي الله عنه- فالمقصود هنا أنه لا يخالف بقية الصحابة المطالبين بدم عثمان -رضي الله عنه- في وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان -رضي الله عنه- على ما تقدم تصريحه بذلك في إجابته لطلحة والزبير لما طالباه بقتل قتلة عثمان حيث قال (يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم)، ثم أقسم بعد ذلك وهو الصادق البار: أنه لا يرى إلا ما يرون في هذا الأمر، وهذا مما يدل على إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على هذه المسألة، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: أن الصحابة -رضي الله عنهم- الذين اختلفوا في الفتنة لم يتهم بعضهم بعضاً في الدين، وإنما كان يرى كل فريق منهم أن مخالفه وإن كان مخطئاً، فهو مجتهد متأول، يعترف له بالفضل في الإسلام وحسن الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة مقررة عند أهل العلم أيضاً بما ثبت من ثناء الصحابة بعضهم على بعض -رضي الله عنهم- أجمعين، فمن ذلك ما جاء عن علي -رضي الله عنه- بعد معركة الجمل أنه كان يتفقد القتلى فرأى طلحة بن عبيد الله مقتولاً فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: (رحمة الله عليك أبا محمد يعزّ عليّ أن أراك مجدولاً[30] تحت نجوم السماء، ثم قال: إلى الله أشكو عُجَري وبُجَري[31]).[32] ولما جاءه (ابن جرموز) قاتل الزبير ومعه سيفه لعله يجد عنده حظوة فاستأذن عليه فقال علي -رضي الله عنه-: (لا تأذنوا له وبشروه بالنار)، وفي رواية أن علياً قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار). وقال لما رأى سيف الزبير: (طال ما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).[33] وبعد انتهاء معركة الجمل ذهب علي إلى عائشة -رضي الله عنهما- فقال: (كيف أنت يا أُمّه ؟ قالت: بخير، قال: يغفر الله لكِ، قالت: ولك).[34] وذكر الطبري أن علياً -رضي الله عنه- بلغه أن رجلين شتما عائشة -رضي الله عنها- فبعث القعقاع بن عمرو فأتى بهما، فقال: اضرب أعناقهما، ثم قال: لأنهكنهما عقوبة، فضربهما مائة مائة وأخرجهما من ثيابهما.[35] وروى الطبري من طريق محمد بن عبدالله بن سواد وطلحة بن الأعلم في تجهيز علي لعائشة -رضي الله عنهما- لما أرادت أن ترتحل من البصرة قالا: «جهز على عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب، أوزاد أو متاع، وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام، واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وقال: تجهز يا محمد فبلَّغها. فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه، جاءها حتى وقف لها، وحضر الناس، فخرجت على الناس وودعوها، وقالت: يابَنيّ تعتب بعضنا على بعض استبطاءً واستزادة فلا يعتدّن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك، إنه والله ما كان بيني وبين عليّ في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه عندي على معتبتي من الأخيار. وقال علي: يا أيها الناس، صدقت والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة».[36] ومما ثبت من ذلك عن عمار -رضي الله عنه- وكان في جيش علي يوم الجمل ما رواه الطبري من رواية مالك بن دينار قال:«حمل عمار على الزبير يوم الجمل فجعل يحوزه[37] بالرمح فقال: أتريد أن تقتلني؟ قال: لا انصرف».[38] وروى الطبري أيضاً عن عامر بن حفص قال: «أقبل عمار حتى حاز الزبير يوم الجمل بالرمح فقال: أتقتلني يا أبا اليقظان! قال: لا ياأبا عبدالله».[39] وهذا كله فيما دار بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في معركة الجمل، أما في موقعة صفين التي دارت بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما-. فقد ثبت عن علي -رضي الله عنه- على ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن إسحاق بن راهويه بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال: (سمع علي يوم الجمل أو يوم صفين رجلاً يغلو في القول فقال: لا تقولوا إلا خيراً إنما هم قوم زعموا إنا بغينا عليهم، وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم).[40] وعن محمد بن نصر بسنده عن مكحول: (أن أصحاب علي سألوه عمن قُتِل من أصحاب معاوية ماهم؟ قال: هم مؤمنون).[41] وعن عبد الواحد بن أبي عون قال: (مر علي -وهو متوكئ على الأشتر- على قتلى صفين، فإذا حابس اليماني مقتول: فقال الأشتر: إنا لله وإنا إليه راجعون هذا حابس اليماني معهم يا أمير المؤمنين عليه علامة معاوية، أما والله لقد عهدته مؤمناً، قال علي: والآن هو مؤمن).[42] وأما معاوية -رضي الله عنه- فقد تقدم ثناؤه على علي -رضي الله عنه- واعترافه بفضله كما جاء في حواره مع أبي مسلم الخولاني لما قال له أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: (لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني...).[43] الخ كلامه. وقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء أن ضرارة بن ضمرة الصُّدَائي دخل على معاوية فقال له: صف لي علياً، فقال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين، قال: لا أعفيك، قال: (أما إذ لابد فإنه كان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فضلاً، ويحكم عدلاً...). وذكر كلاماً طويلاً في وصف علمه وشجاعته وزهده. إلى أن قال: (فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها، وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء، فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه الله).[44] فهذه بعض الآثار المنقولة عن الصحابة -رضي الله عنهم- ممن وقع بينهم الخلاف، في ثناء بعضهم على بعض وتعظيم بعضهم لبعض وتحابهم في الله، رغم ما حصل بينهم من اختلاف وحروب نشأت عن اجتهاد كل منهم فيما يرى أنه فيه مصلحة الأمة، وإقامة دين الله وشرعه، ومع هذا فقد كان كل منهم ينصف صاحبه، ولا يحمله خلافه له في الاجتهاد على الطعن عليه في الدين، والاعتداء والظلم، بل كان يشهد كل منهم لأخيه بما هو عليه من الفضل والسبق إلى الإسلام. وهذا لعمر الله هو الفضل، فإن الإنصاف عند الخصومة عزيز، وهو في الناس قليل، إلا لمن علت درجاتهم في الإيمان، وزكى الله نفوسهم وطهرها من الشهوات، أمثال أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم الذين اصطفاهم الله بعلمه لصحبة نبيه، فنسأل الله أن يرزقنا محبتهم جميعاً، وحسن الأدب معهم، وأن يجعلنا ممن قال فيهم: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم}.[45] وأما قول المؤلف في حق الصحابة: «وهم الذين اختلفوا في تفسير كتاب الله، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت المذاهب والفرق، والملل والنحل، ونشأت من ذلك المدارس الكلامية والفكرية المختلفة وبرزت فلسفات متنوعة.... إلى أن قال: فالمسلمون لم ينقسموا، ولم يختلفوا في شيء لولا الصحابة، وكل خلاف نشأ وينشأ إنما يعود إلى اختلافهم في الصحابة». فجوابه: أن هذا من أكبر التلبيس والتمويه، والطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هم منه برآء، فما ينقل عن الصحابة من اختلاف في التفسير، وفي فهم بعض الأحاديث، لم يترتب عليه ما ذكر من نشأة الفرق والمدارس الكلامية والفلسفات المتنوعة. وذلك أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد[46]، وغالب ما ينقل عن الصحابة في تفسير بعض الآيات، من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. قال: «الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب مايصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد».[47] ثم ذكر -رحمه الله- أن اختلاف التنوع يرجع إلى أمرين: الأول: أن يعبر كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على المعنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فيقول بعضهم: بأنه هو القرآن أو اتباع القرآن، ويقول آخر: هو الإسلام، أو دين الإسلام، ويقول آخر: هو السنة والجماعة، ويقول آخر: طريق العبودية، أو طريق الخوف والرجاء والحب، أو امتثال المأمور واجتناب المحظور، أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. الثاني: أن يذكر كل واحد من السلف الاسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ (الخبز) فأُري رغيفاً وقيل له: هذا فالإشارة إلى نوع هذا، لا إلى هذا الرغيف وحده.[48] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب».[49] ومن هنا يظهر أن هذا النوع من الاختلاف -وهو الغالب على ما ينقل عن الصحابة من اختلاف في التفسير- لا أثر له في الاختلاف في استنباط الأحكام من الآيات، وتنازع الأمة من بعدهم في ذلك، فضلاً أن يكون سبباً لنشأة الفرق والنحل، والمدارس الفلسفية والكلامية كما يدعي الطاعن. أما اختلاف الصحابة الراجع إلى القسم الثاني وهو اختلاف التضاد فما يثبت عنهم من ذلك سواء في التفسير، أو في الأحكام، فقليل وهو ليس في الأصول العامة المشهورة في الدين، وإنما في بعض المسائل الدقيقة التي هي محل اجتهاد ونظر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد أن ذكر أن عامة ماينقل عن الصحابة والسلف من الخلاف في التفسير من باب اختلاف التنوع: «ومع هذا فلابد من اختلاف مخفف بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من اختلاف،معلوم بل متواترعند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها، وفرائض الزكاة ونصبها، وتعيين شهررمضان، والطواف، والوقوف، ورمي الجمار، والمواقيت وغير ذلك. ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، وفي المشركة ونحو ذلك لايوجب ريباً في جمهور مسائل الفرائض...».[50] وهذا النوع من الاختلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم- لم يكن سبباً في تفرقة الأمة، ونشأة البدع كما زعم هذا الطاعن، ذلك أنه لم يكن في الأصول العامة لهذا الدين، التي حصل الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدع، وإنما كان في مسائل جزئية ودقيقة، الاجتهاد فيها سائغ والخطأ فيها مغفور، لأنه ناشئ عن اجتهاد من غير تعمد للمخالفة، وقد ثبت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفراداً منهم أخطأوا في بعض المسائل مجتهدين، كما في قصة عدي بن حاتم -رضي الله عنه- لما اتخذ عقالين أحدهما أسود، والآخر أبيض، فجعل ينظر إليهما ظناً[51] منه أن هذا هوالمقصود من قوله تعالى:{حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، واختلف الصحابة إلى فريقين في فهم قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)[52]، فصلى فريق منهم في الطريق، وفريق آخر لم يصل إلا في بني قريظة. كما حصل لبعضهم -رضي الله عنهم- بعض المخالفات متأولين، كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة-رضي الله عنه-[53]، وقصة خالد -رضي الله عنه- مع بني جذيمة[54] في حوادث كثيرة يطول ذكرها، ومع هذا لم يؤثمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغير الأمة على دين الله، لأن أخطاءهم نشأت عن اجتهاد أو تأويل، قد رفع الحرج فيه عن الأمة. ولهذا لم يكن اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- في مسائل الاجتهاد سبباً في تفرقهم، وتنازعهم، وتحزبهم. قال الامام قوام السنة: «إنا وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم اختلفوا في أحكام الدين، فلم يفترقوا، ولم يصيروا شيعاً، لأنهم لم يفارقوا الدين، ونظروا فيما أذن لهم».[55] فإذا كان التنازع منتفياً في حقهم، بل الثابت عنهم هو التآلف والاتفاق، والمحبة والتواد، كما وصفهم ربهم بقوله: {أشداء على الكفار رحماء بينهم}. فكيف لهذا الطاعن أن يدعي: أن اختلافهم في الاجهتاد سبب في تنازع الأمة وتفرقها. بل إن الأمة استفادت بسبب اختلاف الصحابة في الاجتهاد، مع عدم التفرق والتمزق، من الدروس والعبر، ما كان سبباً في اجتماع الأمة لا تفرقها، ووحدتها لا تمزقها، لكن إنما حصل هذا لأهل المتابعة لطريقهم الذين اهتدوا بهديهم، واقتفوا أثرهم في ذلك، فلم يتفرقوا لاختلاف الآراء في الاجتهاد. ألا وهم أهل السنة، الذين هم أهل الاجتماع والائتلاف، وفارقهم وخالفهم في هذا سائر أهل البدع، الذين هم أهل التفرق والاختلاف. ولذا لما رأى خيار السلف من بعدالصحابة هذه الثمار الطيبة المباركة لاجتهادات الصحابة، وأثرها في الأمة، وما حصل بسببها من الرحمة للأمة والتوسعة في الاجتهاد والترجيح بين أقوالهم، ما كرهوا اختلاف الصحابة بل أظهروا الفرح والرضا به. قال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: (ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلفوا).[56] وفي رواية أخرى عنه: (ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم).[57] وقال القاسم بن محمد -رحمه الله-: (لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم، إلا رأى أنه في سعة ورأى خيراً منه قد عمله).[58] وقال أيضاً: (لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولاً واحداً، كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ بقوله رجل منهم كان في سعة).[59] قال الشاطبي-رحمه الله-:«وبمثل ذلك قال جماعةمن العلماء».[60] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: مايسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا كان الأمر في سعة».[61] فأقوال هؤلاء الأئمة تدل دلالة ظاهرة على أن اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- في الاجتهاد، لم يفض إلى مفسدة في الدين، ولم يكن سبباً في تفرق المسلمين، ونشأة الفرق المبتدعة في الإسلام، على ما ادعى هذا الطاعن، إذ لو أدى اختلافهم إلى هذا أو أقل منه بكثير، فكيف يفرح بخلافهم ولا يحزن له هؤلاء الأئمة الكبار، وهم أهل الغيرة على الدين والنصح للمسلمين. وإذا ثبت هذا فاعلم أيها القارئ أن هذه الفرق المبتدعة على كثرتها واختلاف مشاربها لا ترجع بحمد الله في أصل نشأتها لأحد من الصحابة، ولا تستند في بدعها لقول واحد منهم وإن كان بعض هذه الفرق تدعى الانتساب لبعضهم، كانتساب الشيعة لعلي -رضي الله عنه- وأبنائه إلا أن هذا غير صحيح فعلي وأبناؤه -رضي الله عنهم- بريئون منهم ومن عقيدتهم كما تقدم نقل أقوالهم في ذلك. وفي الحقيقة إن عامة هذه الفرق المبتدعة، إنما أحدثها أول من أحدثها، إما كفار أصليون أو منافقون ظاهروا النفاق في الأمة. فالخوارج يرجعون في أصل عقيدتهم ونسبهم إلى ذي الخويصرة الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قسم الغنائم يوم حنين فقال: (يارسول الله اعدل، قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: يارسول الله أئذن لي فيه أضرب عنقه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه من صيامهم، يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم منالرّمية..).[62] وأما القدرية: فأول من أظهر مقالتهم وتكلم في القدر: رجل نصراني يسمى: (سوسن) روى الآجري واللالكائي عن الأوزاعي قال: «أول من نطق في القدر: رجل من أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد».[63] وأما الجهمية: فمنسوبة للجهم بن صفوان، أول من أشهر القول بتعطيل الصفات، والجهم أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، وأخذها الجعد عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر، الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير -رحمهما الله-.[64] وأما الفلاسفة: فأخذوا الفلسفة عن فلاسفة اليونان، بل عن شرهم وهو أرسطو. قال ابن القيم: «الفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم، بل هم موجودون في سائر الأمم، وإن كان المعروف عند الناس، الذي اعتنوا بحكاية مقالاتهم: هم فلاسفة اليونان».[65] ويقول في التعريف بمصطلح الفلسفة: «وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً بمن خرج عن ديانات الأنبياء، ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه، وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو، وهم المشاؤن خاصة، وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها، وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها، المتأخرون من المتكلمين، وهؤلاء فرقة شاذة من فرق الفلاسفة، ومقالتهم واحدة من مقالات القوم حتى قيل: إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته».[66] وأما الباطنية: فبذرة يهودية بذرها عبدالله بن ميمون القداح اليهودي. يقول محمد بن مالك بن أبي الفضائل عن الباطنية: «وأصل هذه الدعوة الملعونة، التي استهوى بها الشيطان أهل الكفر والشقوة، ظهور عبد الله بن ميمون القداح في الكوفة، وما كان له من الأخبار المعروفة... وكان ظهوره في سنة ست وسبعين ومائتين من التاريخ للهجرة النبوية، فنصب للمسلمين الحبائل، وبغي لهم في الغوائل، ولبس الحق بالباطل: {ومكر أولئك هو يبور} وجعل لكل آية من كتاب الله تفسيراً، ولكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأويلاً... وكان هذا الملعون يعتقد اليهودية، ويظهر الإسلام، وهو من اليهود من ولد الشلعلع من مدينة بالشام يقال لها سلمية».[67] وهكذا الحال مع بقية الفرق الضالة. فهذه أصول الفرق المبتدعة في الإسلام، وأول من دعا لها وبثها في الأمة من أولئك الكفرة، والزنادقة الحاقدين على هذا الدين. فانظر أيها المسلم كيف أن هذا الطاعن الخبيث يبرئ هؤلاء الكفرة والملحدين مما أحدثوه من البدع العظيمة، وما نتج عنها من شر عظيم، وتفريق لوحدة المسلمين، ويلصق هذه التهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زاعماً أن هذه الفرق، إنما نشأت بسبب اختلافهم، وأنها ترجع إليهم. <HR align=right width="33%" SIZE=1>[1] - أخرجه البخاري في: (كتاب العلم، باب كتابة العلم) فتح الباري 1/208، ح114. ومسلم: (كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصي فيه) 3/1259. [2] - انظر تفسير ابن كثير 2/404. [3] - ذكر هذا الوجه من الردّ الدهلوي. انظر: مختصر التحفة الاثني عشريةص251. [4] - انظر: الأحاديث في ذلك من صحيح البخاري مع الفتح 3/606، ح1785، 8/587، ح4844، 8/152، ح4468،4469. [5] - انظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/143، ح4448، وصحيح مسلم 1/315، ح419. [6] - أخرجه أحمد في المسند 4/126، ضمن حديث العرباض بن سارية في موعظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا ابن ماجه في سننه 1/16، وقد صحح الحديث الألباني بمجموع طرقه في ظلال الجنة. انظر: ظلال الجنة مع كتاب السنة لابن أبي عاصم ص26. [7] - منهاج السنة 6/316. [8] - أخرجه مسلم في صحيحه: :(كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر) 4/1857، ح2387. [9] - منهاج السنة 6/23،25. [10] - مختصر التحفة الاثني عشرية ص251. [11] - تاريخ الطبري 4/427. [12] - تاريخ الطبري 4/427- 428. [13] - انظر: تاريخ الطبري 4/427- 429، وقد قام بجمع هذه الروايات ودرسها الدكتور محمد أمحزون في كتابه القيم: (تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة 20/59- 75. [14] - تاريخ الطبري 4/434. [15] - المصدر نفسه 4/486. [16] - إشارة إلى ما جاء في بعض الروايات: أن أول من بايع علياً طلحة - رضي الله عنهما- وكان بيده اليمنى شلل، لما وقى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد،فقال رجل في القوم: أول يد بايعت أمير المؤمنين شلاء لا يتم هذا الأمر. انظر: تاريخ الطبري 4/435، والبداية والنهاية لابن كثير 7/237. [17] - قيل هي: لغة طيّ. ذكره ابن الأثير في النهاية 4/94 وكذلك: اللُّجّ ليس من لغة قريش بل من لغة طيّ، قال ابن الأثير: «هو بالضّم: السيف بلغة طيّ» النهاية 4/234، وقيل هو السيف أيضاً بلغة هذيل وطوائف من اليمن. انظر لسان العرب 2/354. [18] - العواصم من القواصم ص148- 149. [19] - سبب ذلك أن علياً - رضي الله عنه- طلب من معاوية أن يدخل في البيعة ويحاكمهمإليه فأبى معاوية - رضي الله عنهما- جميعاً. انظر: البداية والنهاية 7/265، وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة لمحمد أمحزون 2/147. [20] - أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 16/356ب، وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 3/140، وقال محققوا الكتاب: رجاله ثقات. [21] - البداية والنهاية 7/270. [22] - انظر: البداية والنهاية لابن كثير 7/268- 270، وقد جمع هذه الروايات الدكتور محمد أمحزون في كتابه: (تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة)2/146- 150. [23] - لمعة الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة ص115. [24] - الصواعق المحرقة ص 216. [25] - أي من المتشيعين لعثمان أو علي - رضي الله عنهما- ، وقد كان المطالبون بدم عثمان - رضي الله عنه- قد انضموا إلى معاوية ومع هذا ما كانوا يفضلونه على علي - رضي الله عنهم- أجمعين. [26] ) مجموع الفتاوى 35/72- 73. [27] - تاريخ الطبري 4/437. [28] - البداية والنهاية لابن كثير 7/239. [29] - منهاج السنة 4/407- 408 [30] - أي: مرمياً ملقيً على الأرض قتيلاً: النهاية لابن الاثير 1/248. [31] - أي: همومي وأحزاني، النهاية لابن الأثير 3/185. [32] - البداية والنهاية لابن كثير 7/258. [33] - ذكر هذه الروايات ابن كثير في البداية والنهاية 7/260. [34] - أورده الطبري في تأريخه 4/534. [35] - انظر: تاريخ الطبري 4/540. [36] - تاريخ الطبري 4/544. [37] - الحيز والحوز هو السوق اللين، ومنه حاز الأبل يحوزها سارها في رفق. انظر: لسان العرب 5/343. [38] - تاريخ الطبري 4/512 [39] - تاريخ الطبري 4/512. [40] - منهاج السنة 5/244- 245. [41] - منهاج السنة 5/245. [42] - المصدر نفسه 5/245. [43] - انظر ص238 من هذا الكتاب. [44] - حلية الأولياء 1/84- 85. [45] - سورة الحشر 10. [46] - انظر: مجموع الفتاوى 6/58. [47] - مقدمة في أصول التفسير ص10. [48] - انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية ص10- 12، ومجموع الفتاوى 13/381- 382. [49] - مجموع الفتاوى 13/381. [50] - مقدمة التفسير ص17. [51] - انظر الحديث في صحيح البخاري: (كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا} الآية)، فتح الباري 4/133، ح1916، وصحيح مسلم: (كتاب الصوم، باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر) 2/766. [52] - الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: (كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحزاب) فتح الباري 7/408، ح4119. [53] - انظر: الحديث في هذا في صحيح البخاري: (كتاب استتابة المرتدين، بابما جاء في المتأولين) فتح الباري 12/304، ح 939، صحيح مسلم:(كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر...) 4/1941،ح2494. [54] - انظر: الحديث في هذا في صحيح البخاري: (كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد إلى بني جذيمة)، فتح الباري 8/56، ح4339. [55] - الحجة في بيان المحجة 2/227- 228. [56] - نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 3/80، والشاطبي في الموافقات4/125. [57] - ذكره الشاطبي في الموفقات 4/125. [58] - المصدر نفسه 4/125. [59] - المصدر نفسه 4/125. [60] - المصدر نفسه 4/125. [61] - مجموع الفتاوى 30/80. [62] - رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري في: (كتاب استتابة المرتدين، باب ترك قتل الخوارج للتألف) فتح البارى 12/390. ومسلم: (كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفتهم) 2/744. [63] - الشريعة للآجري ص243، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 4/750. [64] - انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 5/20، والبداية والنهاية لابن كثير 9/364. [65] - إغاثة اللهفان 2/260. [66] - المصدر نفسه 2/524. [67] - كشف أسرار الباطنية لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل ص31- 33
__________________
   |
|
#2
|
|||
|
|||
|
ليس هناك من الصحابة من احتج بعدالة الصحابة او اجتهادهم والامر اليك اين النصوص الصحيحة على ذلك ولم تذكر قضية التاول والاجتهاد الا في ازمنة متاخرة
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
 سؤال غبي من يسمح لنفسه الحديث في مواضيع كهذه ما علييه إلا أن يدلنا أولا أن عندهم كتب صحيحة سنتنازل : كتاب واحد فقط سنتنازل : رواية يتيمة واحدة فقط
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ   |
 |
| أدوات الموضوع | |
|
|